من ذاكرتنا الوطنية ـ كتب : عبدالله خليفة
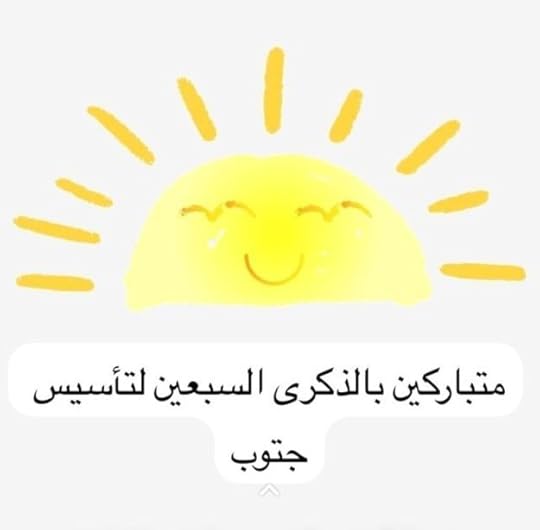
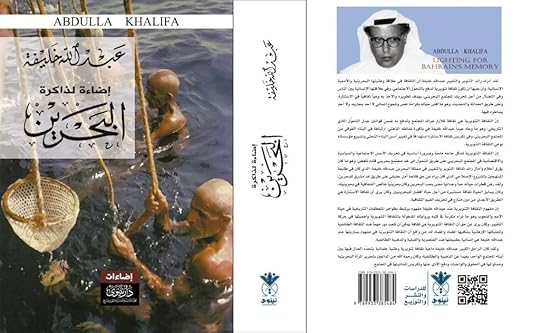
ليس فينا من هو كامل وتام، الذي لم يخطئ، وليس فينا من هو من معدن البطولة الخارقة، ولكن فينا من ناضل وجمع الحطب القليل للتنور الوطني، ومن كتب المنشورات في الليل المعتم وفي الغرف المرهفة بكل آذانِ جدرانها لخطى الأحذية، ومن خط أول شعار على الجدار العالي على المحكمة القديمة بكلمة [يسقط الاستعمار]، ولم يكن البحارة الأميون وباعة المفرق المتناثرون يفهمون حتى هذه الخطوط السوداء الكبيرة التي كـُتبت على الجدار، وفي عمق سوق المنامة، وحتى التجار المتعلمون نظروا بدهشة إلى هذا الشعار الغريب!
ولم يفهم المارة والشرطة الذين غسلوا الشعار إنهم أمام حقبة جديدة من التاريخ!
لكن أن يتجرأ أحدٌ على الكتابة العالية، ويضع أمام العيون يافطة مكتوبة بالدم والوعي، ثم يزاحم الأكتاف القاسية ويكتب ورقاً ويقود تجمعات ويقفز على المتاريس ويتلقى الرصاص ويموت، فإن هذا هو الشيء المذهل..
أربعون سنة وهذا التاريخ الوطني غائبٌ، فورقةٌ منه تكفي لإرسال صاحبها وراء الأسوار، وحين تقرأ كتيباً عليك بعدها أن تحرقه أو تعطيه لآخر وآخر حتى يكون مصيره الأخير في النار ! فامحت الذاكرة أو كادت.
كانت كلُ المجلات التي تتكلمُ عن نضالِ الشعوب متوفرةً في المكتبة الوطنية في الشارع الذي هو امتداد لما كان يـُسمى شارع الظلام، ثم سُمي الشارع المسقوف، وهو الشارع الذي تصطفُ فيه المحلات الكبرى وقتذاك، وفي خلفياته تقع المقاهي التي يتجمع فيها الهامسون، وهم المناضلون الذين يتواعدون، ويتبادلون قصاصات الصحف والمجلات والكتب والأخبار، وكانت المجلات والصحف القومية الناصرية هي التي تعلو الرفوف ويتخاطفها القراءُ بسرعةٍ شديدة!
كان من يريد أن يصبح مشهوراً وقائداً يلتحقُ بالهيئة وبالقوى القومية الناصرية، وأذكرُ أحدَ معارفي وكان طموحاً وشبه أمي، ولكنه أصر أن يكون ناصرياً بارزاً، فكان يكثرُ الإغارة على ذلك الشارع ويشتري المجلات المصرية، [آخر ساعة، والمصور] ويملأ بها بيته ومن ذلك الشارع، ثم يمشي في كشافة الهيئة، والكثيرون يفعلون مثلما يفعل والنضالُ حماسٌ وصخب حاد وشعارات متوهجة!
كان يبدو لك من هياج الناس أن كلَ فرد هو إنسان مناضل، تحفُ به الأرواحُ المقدسة، وأنه طاهر نبيل، وأن الوطن سوف يتحرر في غمضة عين، وأن العاصفة القومية ستكنسُ كل شيء في لمح البصر، وأن هدير المذيعين وصخب الإذاعات قادرٌ أن يحّول الوطن العربي الممزق إلى دولة جبارة تتفجرُ طاقاتها الصاروخية بلمح البصر وتستولي على المريخ قبل الروس والأمريكيين!
لكن هذا الرجل من معارفي بعد سنوات تحول إلى مقاول لا يعرف شيئاً عن السياسة، ويعرف الكثير عن فنون النصب والاحتيال، ويهتم كثيراً كيف ينتزعُ بيتاً من قريب متأزم مالياً، وكيف يبهرجُ الكلام ويصبح وجههُ كثيرَ الابتسام بشوشاً للمصالح والمكاسب متوارياً في الخسائر والمطالب!
كان هؤلاء الصاخبون المنفعلون أوقات الأزمات والثورات يظهرون وكأن لا أحد شريف وثوري غيرهم، وكانوا يملأون باصات طلبة المدارس بالصخب، ويعتدون على الناس لأقل شبهة، ثم يمضي الزمن وتراهم موظفين قساةً على مرؤسيهم، يقومون بأي شيء من أجل أن ترتفع درجاتهم ونسوا النضال الوطني، وكأنهم ليسوا هم الذين اتهموا الكثيرين بالخيانة للروس والفرس والإنكليز، ثم بلطوا على خط المال والوشاية والتفاهة!
ليس في النضال الوطني أهم من الاجتماعات والشخصيات البارزة والكتب والنزول إلى الشارع إذا حمى الوطيس!
ولعل الكتب قد لعبت في حياتي دوراً لا يقل عن ذلك الشريط من البشر المكافحين والسجون الممتلئة، والشوارع النازفة!
لقد كان بيتنا الواقع في حي العمال بمنطقة القضيبية لا يكادُ يعرفُ شيئاً أسمه الكتاب. وكنت أتحرق شوقاً إلى الكتب، إلى درجة كبيرة، لأن بعض أبناء الميسورين في المدرسة من أقراني كانوا يتحدثون عن كتب دارون وفرويد ونجيب محفوظ والعقاد، وأقصى ما حصلت عليه في طفولتي كتاب مغامرات عنترة بن شداد، الذي لا يزال حتى الآن ترتعش سطوره بين عيني وكأنه مفتوحٌ أمامي!
وحاولت أن أقرأ في المكتبة العامة بالمنامة، حيث كانت مدرسة الثانوية أشبه بقلعة من قلاع المعرفة، تحيطها الساحاتُ، ويبدو شبكها المعدني الطويل، مصيدة لأوراق الشتاء المتطايرة وللطباشير، وقلعة للنضال الوطني ولتخريج الكوادر في سبيل الحرية! وتجثم المكتبة العامة في جانبها الشمالي، ويبدو الحصول على كتاب فيها لطالب أشبه بمغامرة محفوفة بالمخاطر، وللأسئلة والكثير منها كتب أدبية تقليدية.
فغدت المكتبة الرئيسية التي تعلمتُ منها هي مكتبة التنظيم، ففي [الجبهة] ليس ثمة كتاب خاص، وأهم الأشياء التي تبقى معك بعد الاجتماعات السريعة هي الكتب، والكتب ليست بالقطاعي وليس ثمة وقت محدد للترجيع والاستعارة، وللسؤال عن ميولك وعنوانك وولي أمرك!
هنا نهرٌ من الكتب يتدفق بلا ثمن، و[كوارتين] مليئة تـُعطى لك لتقرأ، هنا أكبر الباحثين؛ مجلدات رأس المال، وكتب سلامة موسى وجورج حنا، وأدب المقاومة، والأعمال الكاملة للينين وروايات مكسيم غوركي والفولاذ سقيناه، وجورج آمادو، وأسس الفلسفة وكتب ماوتسي تونغ وغيرها كثير..
وفي الأسواق يكمنُ الباعةُ الشعبيون للكتب والمجلات التقدمية. في المخارقة يجلس الكهلُ من عائلة زليخ يبيعُ البضائع البسيطة العادية، ولكن يأتي إليه مثقفون وعمال، ويستغرب بعض الناس كيف يستقبل هذا العجوز هؤلاء، ثم يخرجون ولم يشتروا شيئاً.
كان المثقفون يأخذون المجلات الفكرية والسياسية الموضوعة تحت علب وصناديق البضائع، والتي تأتي من بيروت، وخاصة مجلة [الوقت]، التي كانت هي مجلة قضايا السلم والحرية والاشتراكية التي تصدر في براغ بالمعسكر الاشتراكي وقتذاك!
وفي تلك الأوراق القليلة كنتَ تقرأ تحولاتَ العالم والموائد المستديرة التي تعرض خبرات الأحزاب وصراعات الفكر والسياسة!
وفي مكتبة البحرين كانت الكتب الأدبية التقليدية تملأ الرفوف وكانت العتمة والغبار ولكن تحت الطاولة توجد كتب هزت العالم وغيرت التاريخ ! وإذا كان صاحب المكتبة يعرفك جيداً فسوف يفتح لك الدهاليز السرية!
وفي الانفتاح الأول ظهرت مكتبة النجمة، وانهمرت الكتب الفكرية والتقدمية، حتى غدت هذه الكتب موضة المكتبات الأخرى، ثم جاءت سنواتٌ كان أكثر من يقرأُ فيها هو النار!
وبعد سنوات حين أخذتنا الصناديق في الصحراء وعزت أوراق الكتب، وأدمنا قراءة الروشتات الطبية رحنا نتذكر بحسرة ذلك العالم الساحر المليء بكتب بلا ثمن، والتي حين خرجنا كانت قد ضاعت أو احترقت أو صودرت أو نـُسيت في ممرات الزمن المغبر.
كانت أحياء القضيبية والحورة والعوضية في شرق المنامة تتجاور وتكاد تتلاصق بشدة، ولكنها تبدو نائية عن بعضها، وكأنها قرى منفصلة!
كانت القضيبية أشبه بفضاء متسع، فيها مناطق سكنية صغيرة متناثرة؛ يجثمُ فيها قصران، قديم وجديد، وفيها قسمٌ من الأكواخ وعرائشُ السعف ومناطق الفرق الموسيقية الشعبية القادمة من جذور أفريقيا السوداء، وهي المساكن التي عصفت بها الحرائقُ ولم يبق منها سوى هذه الأطلالُ النازفةُ والصادحة!
أما الحورة فكانت منطقة سكنية مزدحمة، تكدس فيها فقراء، أحاطها البحر من جهتين، واتخذت الحكومة المنطقة الشمالية كمستودع عائم وأرضي للقمامة، وبدت الحورة أكثر بؤساً من بقية المناطق.
أما فريق العوضية، فهو بيوت أكثر التصاقاً وحداثة ونعمة. كانت أجواء الانفكاك تخيم على هذه الأحياء رغم أن حركة هيئة الاتحاد الوطنى قد جمعت الشعب في كيان واحد، لكن هزيمتها وعودة اليأس والحزن، أعادت الناس؛ الى أجواء العداء والتفكك والريبة.
فكانت المعارك تشتعل بين الأحياء، ثم أخذت أنفاس الحركات السياسية الجديدة تتوغل إلى هذه الحارات بصور متفاوتة.
فإذا كانت الحورة قد استقبلت المد القومي بصورة حماسية، وانعكس ذلك على تشكل خلايا قومية فيها، فإن العوضية كانت قد أخذت تتشرب الماركسية منذ أوائل الخمسينيات، فتدفق المهاجرين المطرودين من إيران، والأحداث الوطنية العاصفة هناك، ومناخ حركة الهيئة التي قذفت بالجمهور في النشاط السياسي، وتضخم أعداد العمال البحرينيين بصورة واسعة سريعة، كل هذه جعلت من الوعي التقدمي عملية ضرورية، تستدعيها مهمات الحركة السياسية الوطنية التي قذفتها الهيئة من الانتشار الهائل إلى الغياب الكامل!
كانت الحركات القومية المختلفة تقوم بذات أخطاء حركة الهيئة، من حيث البنية التنظيمية، فهي تقوم بحشد الشباب المتحمس، وتعتبره منظماً بصورة آلية، دون أي عملية انتقاء وتثقيف، وكذلك من حيث غياب الوعي المبرمج والمدروس والممنهج. ولذا كانت مسألة البرامج مسألة في غاية الأهمية حينذاك بسبب أن حركة الهيئة كانت حركة مبلبلة، مشتتة، لم تطرح أهدافاً استراتيجية ممكنة التحقيق، فهي تطرح مطالب ديمقراطية جزئية كانتخابات أعضاء إدارة ثم تتراجع عنها، أو تعتبر نفسها جزءاً عضوياً من حركة الوحدة العربية والإسلامية. دون أن تظهر مسألة الحرية الوطنية والاستقلال الناجز كهدف رئيسي محوري.
ولهذا فإن المجموعات القومية التي راحت تكرر أخطاء الهيئة في الحورة أو المحرق، أخذت تتحس لظاهرة جديدة بدأت تظهر في العوضية! فجبهة التحرير التي ظهرت كنواة صغيرة في خضم حركة الهيئة، راحت تعمل بأسلوب سياسي وفكري مغاير في هذه المنطقة المحصورة بين الأحياء «العربية والدينية المذهبية المختلفة»، فانضم عاملٌ جديد إلى نزاعات الأحياء، وغذته أطرافٌ مختلفة ليتحول إلى صدام شخصي واجتماعي . فتشكيل خلايا صغيرة، وقراءة المجتمع بصورة جديدة، وتثقيف الأعضاء والأصدقاء بصورة منظمة يومية، وطرح شعارات سياسية مناسبة، كان هذا شيئاً مغايراً مخيفا، فلا شك أن وراءه قوة خارجية خطيرة!
فظهرت حملةٌ عنيفة على «العجم» و«المتسللين»! و«الشيوعيين المخربين»؛ وكان هذا يترافق مع المد القومي، حيث تتفجر الإذاعات بالجمل الملتهبة، عن الخطر الإيراني، وكان البعض يعتدي على الخبازين البسطاء باعتبارهم جواسيس!
ثم ظهر الخطر الروسي والسوفيتي وتغلغل روسيا الشيطاني إلى منابع النفط! وكان وراء كل هذه الحملة والصراخ اتجاهات شتى، تداخلت فيها الأهداف الغربية الاستعمارية مع حركة القوميين العرب والبعثيين والناصريين بضرورة مقاومة القوة السياسية الجديدة: قوى المعسكر الاشتراكي حينذاك وتجسده التقدمي العربي.
كانت طبيعة الحركات القومية المختلفة، عبر انتفاخاتها التنظيمية التي تكبر بصورة واسعة في بضعة أشهر ثم تختفي في السنوات التالية وكأنها لم تكن، تصيب بأضرار بالغة الحركة الوطنية الناشئة في ظروف مخالفة جنينية، بعد عملية يأس حادة بعد أن أخفقت حركه الهيئة بصورة مروعة والتي كانت أشبه بدولة في عزها!
ولم يكن الأمر يعود فقط لعملية النمو المترهلة فحسب بل أيضاً في طبيعة الحركة التى تأخذ في نموها السريع الحشائش الضارة والأزهار الصغيرة إلى دوامة الفعل السياسي الفوضوي، والقيام بأعمال سياسية لم يحن أوانها، وتتحول إلى مغامرات تضر العود الهش للحركة الوطنية بعد كبواتها المختلفة والتي يكون حصادها مفقودين وشهداء ومنفيين وحرائق!
وقد تجسد ذلك في ربط البحرين بالأحداث في البلدان العربية بشكل عاطفي وحماسي صاخب، فكأن الشعب البحريني مهمته هي فقط في التضامن مع أشقائه، دون اعتبار للفروق بين عمليات التضامن القومي وعمليات الصدام الوطني، فكل عملية تضامن تتحول إلى معركة محلية حادة، فراح جدول الحركة الوطنية البحرينية يرتبط بمناسبات الثورة المصرية وخطب قائدها وانقلابات سوريا الكثيرة وصراعات العراق التي لا تنتهي! ولهذا كان أحمد سعيد يقود شوارعنا المحلية أكثر من الزعماء الطالعين تواً من الطفولة!
ومن هنا كانت احتفالات الوحدة والصدامات بين القوميين والبعثيين والشيوعيين تنعكس بشدة على الشوارع، والدكاكين وجلسات المقاهي، وانقسم الناس فجاة بين عبدالكريم قاسم وجمال عبدالناصر وأخذت المعارك تنتشر!
من هنا كان تفكير جبهة التحرير بفك الارتباط الآلي بين القومي والوطني مدعاة لاستنكار الاتجاهات القومية التي لم تكن تملك برامج وطنية داخلية، ولم يكن لديها خطط عمل سياسية واضحة، وتعيش على الانفعال. وقد تم اعتبار فك الارتباط الآلي هذا بمثابة خيانة قومية، وارتباط مباشر بموسكو عدوة العرب، ويصل ذلك حتى إلى مستوى الفرق الرياضية وأسماء الأندية، فهناك «العربي» وهناك «الوطني»، وهناك العروبة والشعلة والفجر والوحدة، فأخذت التيارات السياسية تنقل خصوماتها وشعاراتها إلى الجمهور والحياة اليومية!
لكن خط جبهة التحرير الصغير والمحدود جماهيرياً راح يؤكد نفسه وينمو بصورة مطردة، فالضربات المستمرة ضد التنظيمات المتضخمة كانت تؤدي إلى انفلاشها وعدم تركها أي أثر سوى الحسرة والمعتقلين المعترفين، الذين يتحولون من التطرف إلى السلبية الكلية، أو الارتداد.
وهو ما كان يحدث بصورة مستمرة في جنين الحركة الوطنية على مدى عقود القرن العشرين الأولى خاصةً، من حيث غياب التراكم الفكري والتأسيس النظري السياسي، وتعرض الحركة للعفوية والانفعالية الشديدة وأخطارهما. وهي جوانبٌ ستورثها الحركةُ السياسية «العلمانية» لشقيقتها وخصيمتها الحركة الدينية.
بطبيعة الحال لا يعنى هذا أن حركات التحرير كانت منقطعة عن هذه التقاليد، أو أنها لا تحوي أخطاء من نوع آخر، وكذلك فإن هذه الحركات الوطنية المنتفخة كانت تشكل حماية للتنظيمات الأكثر بعد نظر، وكان تقلص الحركة الوطنية وهزائمها أمراً مضراً للتنظيمات اليسارية الوليدة، التي انضمت إليها الشعبية عبر التحول في حركة القوميين العرب.
ولهذا كانت الانتقادات الموجهة لها من باب الحرص على تماسكها وقوتها الداخلية، لكن تلك التنظيمات رأتها كمعاول هدم لها!
لابد من التأمل العميق في تاريخنا الوطني لمزيد من العبر، لذاكرة قليلاً ما تتعلم، بسبب تاريخها البدوي ~ القروي القريب والمتجذر.
ولهذا فإن أخذ احدث الموضات الفكرية لا يعني الانتقال للحداثة!
كان صعود جبهة التحرير والجبهة الشعبية في فضاء أواخر الستينيات وفي عقد السبعينات برمته، هو تعبير عن تحول البحرين إلى بلد تهيمن فيه المجموعات العمالية والطلابية وانهارت فيه الزراعة وانعدمت فيه طبقة الفلاحين، وأخذت الأزمتان الاجتماعية والوطنية المتداخلتان يتم التعبير عنهما بالشعارات اليسارية المتصاعدة.
كان صعود التنظيمين يؤكد أن زمن التنظيمات الفضفاضة قد رحل، وأن الخلايا الصغيرة والأفراد المنظمين بشكل دقيق، هو العمل الحزبي الذي يستطيع أن يتجذر في الواقع ويصمد.
وكان واضحاً منذ البدء أن تكوين التنظيمين الاجتماعيين مختلف ومتداخل كذلك، فالتحرير التي نمت على جذور عمالية أكبر احتوت العديد من المثقفين والطلبة، كما أن الشعبية التي أسسها المثقفون وأفراد من الفئات الوسطى والصغيرة، تضم كذلك عمالاً.
ومن هنا كانت قواعد التحرير في المصانع والحياة العمالية، فنمت على أكتاف الإضرابات وتغلغلت في القرى حيث تصاعد وجود العمال. ولهذه النشأة حيوية في البدايات، حيث ظهر نمط من العمال المسيسين والمعلمين والمثقفين كذلك، الذين كرسوا فكرة (الماركسية ~ اللينينية)، حيث هناك خطوط عريضة صارمة للحركة، تعود لتأسيسات الأممية الثالثة وأدبياتها، وغدت هذه الخطوط الفكرية مهمة في الإجابة عن أسئلة الواقع والتطور، أي كيف يجري النضال ضد الاستعمار وكيف يمكن خلق جبهة وطنية عريضة تجمع الناس لتجاوز النظام الاستعماري؟ وكيف تتشكل التكتيكات ومن هي الطبقة التى تكون طليعية في هذا النضال؟
كان وجود العمال البحرينيين الكثيف وانتشار مثل هذه الأفكار يعودان لعوامل متداخلة، فكأن الظروف الموضوعية بحد ذاتها تجذب هذه الأفكار وتنشرها بين الفئات المثقفة من العمال والطلبة، فتحصل هذه الأفكار على انتشار وتأثير وتصمد بقوة في امتحان الواقع، أكثر من التنظيمات القومية الواسعة والفضفاضة، كذلك فإن طبيعة الفكر الملتحم بنظريات في الاقتصاد وعلم الاجتماع، كان ذا جاذبية خاصة.
لكن على أي مستوى فكري ونظري استطاع فكر التحرير أن يشكل أدبياته الدقيقة فتلك مسألة بحاجة إلى دراسات. وأذكر هنا دراسة كانت منتشرة بعنوان «المد والجزر في الحركة السياسية»، وكانت هذه الكراسة المكتوبة بخط الأيدي الكثيرة التي تتداولها وتنسخها، وتحرقها، تعالج أسباب الخفوت والاندفاع في الحركة السياسية الوطنية، ولماذا لا تنمو تتجذر؟ الأفكار بسيطة وساذجة ولكنها حينذاك في أواخر الستينيات تبدو كشعلة من الضوء الباهر! وكانت تبحث بشكل صحيح لماذا لا يشارك الناس في السياسة وكيف يقوم المناضل بجذبهم؟
وأول مقالة شبه علمية تعالج التطور الاجتماعي البحريني ظهرت في مجلة الطليعة المصرية التي كان يرأسها لطفي الخولي، والتي أخذت تثري الساحة العربية بنفس تقدمي جديد، هذه المقالة كتبها سيف بن علي (أحمد الذوادي) في بداية صدور تلك المجلة، وراح يعالج فيها اقتصاد الغوص والنفط وتشكيله المجموعات السكانية، وكانت اللمحات الأولى عن الطبقات والاستعمار، وفيما بعد تزايدت المقالات والكتيبات التي تعالج قضايا السياسة الملحة، كالموقف من اتحاد الخليج العربي المقترح في ذلك الوقت، الذي كان فيه التحليل متواضعاً حيث يقوم هذا التحليل على فكرة أن الاتحاد التساعي وقتذاك سوف يقام وما الأحاديث عن الاختلافات سوى فبركة وخداع! ولكن تلك الاختلافات غير المدروسة كانت حقيقية فعلاً، ولكن هذا كان تعبيراً عن ردود سريعة وعدم تعمق في قراءة الواقع!
أخذت الجبهتان: التحرير والشعبية تثبتان دورهما السياسي المؤثر، وكان اعتماد الشعبية على المثقفين والطلبة قد جعل صوتها أكثر انتشاراً ونشاطاً، ولهذا برزت بقوة في الاتحادات الطلابية وجسم المثقفين المحدود وقتذاك.
ومع انعطاف حركة القوميين العرب إلى الماركسية صار اليسار مهيمناً على الشارع البحريني‘ وبدأت عملية تجذير للوعي السياسي، وللأدبيات السياسية الوطنية، واختلفت المنشورات بشكل واسع، فغدت مركزة على التحليلات الاقتصادية والاجتماعية، وأخبار الناس العاديين وقضايا الفساد، وراحت تسرد بالأرقام والوثائق، ولم يخلُ ذلك بطبيعة الحال من الشعارات العامة والعاطفية الزاعقة!
وفيما كانت التحرير تتمركز على الشأن الوطني كانت الشعبية تجمع بين الشأن الوطني وقضية تحرير الخليج والجزيرة العربية كلها. كان النهج القومي قد تبلور هنا في حركة قيل: إنها واسعة وتمتد من الكويت إلى عمان، وان التركيز على الشأن الوطني البحريني المحدود فيه ضرر على طبيعة الحركة وتطورها. فيما كانت التحرير ترفض هذا التوسع، وتركز على قضايا الواقع الحقيقية، أكثر من فرض قوالب من الخارج، لكن عدم الاهتمام بالشأن القومي والمناطقي كان ليس تعبيراً عن عدم وجود حركات شبيهة بالتحرير في مناطق الخليج الأخرى، ولكن أيضاً في عدم الاهتمام والدرس لواقع المنطقة الخليجية المترابطة عضوياً، وعدم درس لجذور النضال في المنطقة الممتدة في الحركات الشعبية القديمة.
ولكن الصلة بالحركات السياسية خارج البحرين لم تأت بجوانب إيجابية مفيدة وقتذاك، بل أدت إلى أضرار، عبر تخوف البريطانيين من هذه الامتدادات، وتحول جبهة طفار إلى جبهة ساخنة فعلية‘ فكانت ردودهم حادة عبر التدخل الإيراني القمعي، والحملات الخ..
انعكست هذه الأضرار على مسار الحركة الوطنية البحرينية، فكان سلق الأشكال السياسية الفوقية وعدم تجذرها في الترب الموضوعية، والقفز إلى أشكال ومهمات سياسية عليا، قد جعل الحركة السياسية تضعف، وتدخل في صراعات داخلية وتمزقات كانت لها نتائجها المستقبلية في ضعف حركة اليسار.
حينذاك أخذ الخطان السوفيتي والصيني يبرزان ويتصارعان عالمياً وعربياً وبحرينياً، وركز الخط الأول على النضال السلمي والديمقراطي البعيد المدى، في حين توجه الثاني نحو الدعوة لحرب التحرير الشعبية باعتبارها الوسيلة الوحيدة للتغيير، وكان تطبيق هذا في ظروف البحرين والخليج كارثة!
كان هذا التنافس المضر يبعثر الطاقات ولكنه كان يتوسع، وهناك من يغذيه ويحوله إلى خنادق، لكن الحوار المسئول كان يجري كذلك، والعمل المشترك المحدود يثبت أن النضال الجماهيري هو أفضل وسيلة للتغيير، وحينذاك كانت هذه الوسيلة مجسدة ومتنامية في نضال العمال والناس والطلبة في كل مكان، وكانت أحداث السبعينيات كافية لإثبات أن النضال النقابي يمكن أن يتحول إلى نضال وطني واسع في الشوارع، وينتقل من جوانب بسيطة إلى نضال من أجل الديمقراطية والحرية والبرلمان والدستور.
وبطبيعة الحال كانت اليسارية الطفولية تظهر هنا كذلك عير تسييس كل قضية عمالية، وجعلها صداماً سياسياً وأزمة عامة، وهذا ما يتم استغلاله لضرب الحركتين العمالية والسياسية كذلك.
فتحولت صراعات عمالية بحتة في طيران الخليج وألبا إلى أزمات سياسية ومن ثم بدأت عمليات استيراد العمالة الأجنبية وتقليص العمال البحرينيين إلى ثلث العمالة العامة.
يعود «زخم» التيارات الوطنية والدينية كذلك على حماس الجمهور البسيط للعملية السياسية المشحونة التي ينبغي أن تغير أوضاعه الصعبة، لكن هذه العملية تصّعد عموماً أفراداً من الفئات الوسطى خاصةً إلى المراكز القيادية في التنظيمات السياسية، التي تستطيع أن تنتج أفكارها، فبدون هؤلاء الأفراد المثقفين يستحيل أن تتم كتابة البيانات.
وينمو العمل السياسي مادامت هذه الرابطة قوية ومتوهجة بين أولئك العمال والموظفين والعامة عموماً وهؤلاء المثقفين الذين يصعدون تدريجياً إلى القيادة الكلية للتنظيمات.
ولهذا نجد الفروق كبيرة بين بدايات جبهة التحرير والجبهة الشعبية وبين ما آلتا إليه، ففي البدء كان «زخم» العناصر العمالية والطلابية والفقراء عموماً مهيمناً على القواعد والقيادات، لكن في النهاية اكتسحت العناصر «المثقفة» المستويات العليا بصورة شبه كاملة.
لقد نقل هذا التصعيد الثقافي الحركات الوطنية من المستوى العامي البسيط، ومن الارتباط بشعارات الخارج، إلى الحفر الوطني الداخلي، وبهذا غدت الحركات أكثر اقتراباً من عمليات التحليل الاجتماعي والاقتصادي للبنية الاجتماعية، فتطورت النظرية الوطنية تطوراً كبيراً قياساً إلى أفكار الخمسينيات حيث كانت تتركز الأفكار على المطالب الجماهيرية المباشرة، أو على نقل شعارات العالم العربي والإسلامي.
لقد عكست العلاقة بين المثقفين والعمال التي تشكلت داخل التنظيمات الوطنية البحرينية، رؤية اليسار العالمي في ذلك الوقت، حيث ينبغى تجاوز المرحلة الرأسمالية وطرح البديل الاشتراكي، ورغم أن ذلك لم يُطرح في الأدبيات بصورة مباشرة، فإن ممارسات الحركات كانت تُقصى البرجوازية المحلية، وكانت أغلب البيوتات التجارية قد تركت المعارضة، وبهذا تحمل العمال الجهد الأكبر من التضحيات.
وسيكون لاتجاهات المثقفين نحو الارتباط الشديد والحماسي بالعمال، ثم الانفصال عنهم، أسباب عميقة فقد وجدوا مادةً بشرية تبذل التضحية والمساندة المالية، ثم كانت هي الطبقة «الموعودة» بصناعة الجنة الأرضية، ومن هنا طرح «الماركسية ~ اللينينية» الشعارية حيث الانفصال عن الإرث الديني، وهو أمر لا يتحقق حقيقةً، فتغدو الشعارات مجرد طبقة لغوية خارجية، فيأتي التسييس لجوانب إيجابية من الدين، فتعجز الحركات الوطنية عن إدراك ضرورة العلمانية وفهم الدين.
وتزداد الهوة بين مثقفي الحركات الوطنية والعمال، مع تبدل البناء الاجتماعي وتبدل طبقة العمال ومجيء العمال الأجانب، واتساع الفئات الوسطى بشكل كبير، وهي الفئات التي لم يُحسب لها حساب في منظور الاكتساح المنتظر للعمال الاجتماعي والسياسي.
ومثلما كان يحدث في رأسمالية الدولة الشرقية من انفصال إدارات المثقفين السياسيين الحكوميين عن العمال والملكية العامة، يحدث التشقق بين المثقفين والواقع، بين النظرية المتكلسة وحقائق الحياة، مثلما تقوم فئات المثقفين باستغلال مواقعها السائدة في فوائدها الشخصية، وهو أمر كان يزيد الافتراق بين قوى التضحية وقوى الاستفادة، مثلما أن القواعد الاجتماعية للتنظيمات الوطنية تتآكل، والضربات العنيفة المتواصلة عليها تهدم نسيجها المترابط وعلاقاتها بالناس، فتتفاعل عواملٌ كثيرة على هدم مرحلة.
وهذا يظهر في تصدع الأفكار وعدم تطورها، والاستمرار في «الكليشيهات» القديمة المحفوظة، وكاريكاتيرية التحالفات غير المبدئية، وغياب التعاون المثمر والبعيد المدى بين التيارات الوطنية، ويتم التسرب من داخل اليسار نحو اليمين غير الصناعي المنتج، بل الطفيلي!
إن كثرة الحشود ومواجهات الشوارع وقراءة كتب التيار فقط، تؤدي إلى العيش في وهم إيديولوجي، الذي يخلقه حماسُ الشباب والأفكار المتوهجة وقلة التجربة وعدم وجود إرث وطني ثقافي عريق مكتوب ومتداول.
ولأن اليسار البحريني نشأ وحيداً، بلا أحزاب للطبقة الوسطى، ولا أحزاب من أي نوع، فهو يحاور أفكاره الخاصة فقط، ولهذا نشأ فقيراً من الناحية الفكرية.
كان التجار الذين بقوا من حركة الهيئة يعيشون في عزلة ويأس سياسي، وتبدل فكري، وهم أنفسهم لم ينشئوا أفكاراً عميقة في الحياة الاجتماعية، ومن هنا كانت التربة الفكرية البحرينية وفي الخليج عموماً بلا مستويات أرضية متوارية.
لكن عموماً كانت نهضة الحركة الوطنية بطابعها التجاري أكثر غنى في مطبوعاتها وساهم تداول المطبوعات بين الجمهور في إحداث اليقظة الوطنية، وللأسف لم يتم الحفاظ على الحياة الصحفية كمركز مهم لتداول الأفكار الوطنية ولإنتاجها.
وحين أعلنت الحكومة البريطانية مشروع الانسحاب من شرق السويس، وهو المشروع الذي أسس الدول الحديثة الصغيرة في الخليج، خاف التجارُ الكبار في البحرين على مصالحهم وأسرعوا إلى المسئولين البريطانيين يرجونهم عدم الانسحاب!
وبغياب الصحافة وبغياب فاعليات الفئات الوسطى الغنية فإن البلد اعتمدت ثقافياً وفكرياً على المطبوعات الخارجية، المصرية واللبنانية والروسية، وهكذا صار حتى من الناحية الورقية، غياب ساحق للكلمة المنتجة محلياً.
ومن هنا لم يكن على الأرض السياسية سوى العمال واليسار، وعلى مدى أكثر من عقدين تحملت عائلات هذه القوى حملات القمع والمداهمات، وكان لذلك أثر بالغ القسوة على الحياة الفكرية، هو غياب أي تراكم فكري عميق، فلا كراس يبقى، ولا منشورات تحفظ في أرشيف، وتـُدرس وتحلل وتصوب.
ولا تبقى سوى الذاكرة اليومية، وإذا كانت الأسماء مستعارة، والمقرات معدومة، والمناضلون يصعدون إلى قطار العمل السري ثم ينزلون مختفين في محطات، ليصعد آخرون، ليعبر العمل السياسي عن مقارعات موسمية، وعن أشباح لا تراكم سوى مجموعات صغيرة باسلة، ثم يذوب كل شيء في حمى الصراع وتنور الأحداث الذي لا يشبع من الأجساد والسنين.
وهكذا صار الكفاح العمالي والتغيير الاشتراكي مانشيتات مستمرة في المنشورات والخلايا، لكن النظرية لم تتأصل لدى هؤلاء العمال الكثيرين الذين يأتون ويرحلون، وهم يفهمون جيداً الأجور والأسعار والنضال النقابي، أما ما بعد ذلك من تشكيلات وقوانين للتاريخ والوعي، فهي عبارات تومضُ في الأذهان ثم تختفي.
إن بعض المثقفين النادرين كانوا يطلبون من العمال أكثر من طاقتهم العقلية، فيقحمون فيهم أفكاراً كبرى من الصعب استيعابها وتطبيقها، وهذا جزءٌ ن الفقر الفكري أكثر من الغنى.
إن عدم وجود فئات وسطى متنورة، كان هذا يفقر المنطقة، ويجعل التنظيمات اليسارية تقف في الفراغ، ثم تعتبر ذلك شيئاً جيداً، خاصة عبر سيادة النمط التجاري من أولئك الراكضين للسلطة البريطانية لكي لا تنسحب، لكن ذلك هو الذي جعل اليسار عارياً اجتماعياً بدون غابة كثيفة من الأشجار، كما أنه لم يعمل على دعم هذه الفئات التجارية، بل أشعرها بالخوف.
إن الفقر الثقافي والنظري هو من فقر المنطقة مدنياً فلا صحافة مستمرة تراكم الفكر والتجارب، ولهذا كان الكتاب الوطني الُمنتّج غير موجود، وحين ظهر بصورة أدبية أخذته كذلك التوجهات النخبوية.
ولهذا يمكن تأريخ الحركات السياسية بحركة الصحافة، وخاصة الجانب الخبري فيها وجانب الأعمدة والمقالات المكثفة.
حين كان يتم الدخول إلى تنظيم مثل جبهة التحرير الوطني فقد كانت هناك شعارات تنظيمية داخلية كانت بمثابة الهيكل الفكري الذي لا يتغير، وهي شعارات تبين مدى الاختلاف عن الزمن الراهن.
وهذه الشعارات هي: السرية التامة، والاتجاه نحو الجماهير، والتثقيف الذاتي، ودفع الاشتراكات والتبرعات.
تتلاقى هذه الشعارات وتتكامل في منظومة سياسية واحدة، أساسها الاعتماد على النفس، وتطويرها على المدى الطويل وعدم الوقوع في مغامرات وبناء الذات والتنظيم.
التوجه نحو الجماهير، كان يعني شيئاً كبيراً لمجموعات سياسية ووطنية اعتادت على الحديث مع الأصدقاء والشلل، ووضع هذا كشعار كان يجعل الوطنيين يحدقون دائماً في المجالس والمقاهي وأمكنة العمل، والمدارس، ويقرؤون بماذا يفكر الناس، وكيف يعبرون، وما هي الأشياء والمطالب الملحة لهم.
ظلت الحركات السياسية البحرينية دائماً تفكر بما تفكر به هي، وبعمليات إسقاط شعاراتها ووعيها على الناس، وليس بما يفكر الناس حقيقة، وبظروفهم الحقيقية، وبقدراتهم على التغيير.
كانت هذه أول عملية إصغاء عميقة لأصوات البسطاء، وكانت هذه العملية صعبة ومكلفة في أزمنة لا جرائد فيها، وأن وجدت فنادرة، فهذه العملية تتطلب كتابة ما يقوله الأميون والعمال والفلاحون والمثقفون، وتدوينه ودراسته.
وكانت عملية دراسة هذه الأصوات الجماهيرية الغامضة، عملية شاقة، وكان لا بد من الاستعانة بالدراسات والمصادر. ولهذا كان وعي مراقب للجمهور يتطور ويغتني.
أما شعار التثقيف الذاتي فهو شعار خلاق، لأن السياسي يتحول عبره إلى إنسان متعلم ومثقف، عبر الإطلاع الدائم، وسبق أن رأينا كيفية تنظيم وحشد أمهات الكتب الوطنية والاشتراكية، وتوزيعها بشكل واسع.
ويغدو التنظيم مسئولاً عن عملية القراءة لدى العضو، الذي لا بد أن يكتب تقريراً أسبوعياً عن ما قرأه ويقوم بتلخيصه وتتم مناقشة هذا التلخيص لرؤية مدى استيعاب العضو للكتب التي قرأها!
إن كتابة التلخيصات والتعليقات والانتقادات هي الطريقة التي تتبعها الجامعات حالياً، لإثراء التفكير وتكوين شخصية مميزة للطالب، على أن تكون كتباً من مختلف المدارس الفكرية!
كان تآكل المبنى العلماني للحركات الوطنية بطيئاً. فلم تكن هذه التوجهات متجذرة ككل الحركات النهضوية العربية، التي لم تستطع أن تحول الفئات الوسطى إلى طبقة وسطى تعيد تغيير المجتمع التقليدي، فكان أن تصدت فئات وسطى صغيرة لهذا التغيير ولكن للانعطاف عن مهمات المجتمع الرأسمالي الحديث والقفز إلى الاشتراكية، وكان هذا وعياً عالمياً لم يستوعب النظرية.
والواقع إنه مع الرغبه في مثل هذا القفز التاريخي، فإن الكثير من الأفكار المتواريه كانت مدفونة تحت الشعارات الوطنية العامة، التي كانت صحيحة ومهمة تاريخياً.
فكان الوعي السائد يتصور بأن اليساريين والاشتراكيين هم ممثلون للطبقة العاملة، لكن هؤلاء الممثلين كانوا منقسمين إلى عمال ومثقفين، ومهما كان دور العمال في التنظيمات متقدماً فهم عبر مسار العمل السياسي لا بد أن يتراجعوا و يعودوا إلى الصفوف الخلفية والقواعد، بينما يصعد المثقفون، مثلما يحدث تاريخياً في دول المعسكر الاشتراكي حيث يضحي العمال في بدايات الثورات ثم تقوم الفئات الوسطى البيروقراطية بالسيطرة على مقاليد السلطات، وكذلك هذا يحدث في الأنظمة القومية والدينية، وهكذا فإن الحركات الوطنية البحرينية حدث لها مثل ذلك، فعبر الزمن صعد المثقفون ممثلو الفئات الوسطى إلى القيادات، والمثقفون بل والعمال كذلك غير قادرين موضوعياً على إنتاج نظام اشتراكي، ويبقى الأفق أمامهم هو مجتمع رأسمالي وله مهمات موضوعية تختلف عن المهمات الموضوعية لتكوين مجتمع اشتراكي، حيث أن الأخير يتطلب مجتمعاً ذا تطور صناعي وثقافي هائل.
ولكن حين توهم نفسك بالعمل لإنجاز مجتمع غير ممكن تاريخياً، وتضع مهمات سياسية تترافق مع هذا الوهم التاريخي، يعود ذلك بأضرارٍ كبيرة على الأجسام السياسية الصغيرة التي تتصدى لمهمات تضعف بناها المحدودة.
كانت المهمات الاشتراكية متوارية داخل البنى الفكرية والتنظيمية لهذه الجماعات، فكانت الشعارات العمالية وخلق الثورات التي تؤدي إلى إزالة الرأسمالية، وربما كانت جبهة التحرير الوطني أقل إيغالاً في مثل هذه الشطحات السياسية عبر التركيز على التحرر الوطني، وتجميع القوى السياسية الوطنية المختلفة في عمل سياسي كبير، وكانت تقدم حتى المساعدات الفكرية لبعض المجموعات القومية التي لا تعرف أسس العمل التنظيمي السري، وتندفع بشدة ثم تختفي بسرعة.
لكن هذا الواعي الاشتراكي كان موجوداً بقوة، عبر الأخطاء التي كرستها المرحلة السوفيتية والصينية بتجاهل قوانين التشكيلات الخمس، فلم تكن هناك قراءة للمجتمع التقليدي باعتباره هو المجتمع السائد الذي ينبغي تغييره، وبضرورة تنمية كافة القوى السياسية والفكرية لتغييره، عبر استثمار كافة الإمكانيات الاجتماعية وتطويرها ، لكن النظرة لـ«البرجوازية»، وهي طبقة رهن التشكيل، لا رهن الإنجاز، ضيّع مثل هذه التنمية والفرص. وهذا أمر خاطئ على مستوى القراءة التاريخية، أي ثمة عدم معرفة بالتاريخ العربي الإسلامي وطرق التطور فيه، والوعي يأخذ السهل هنا وهو جلب الكتب الخارجية وحفظها وتطبيقها.
ولهذا فإن الفئات الوسطى الصغيرة التي ملأت القيادات على مدى العقود السياسية، فرضت قوالب شعارية على الحركة الوطنية، هي التي سميتها قوالب الماركسية المستوردة، وراحت القواعد العمالية والشعبية عامةً هي التي تقدم التضحيات، لكن تلك الاشتراكية لم تكن سوى ملابس خارجية فضفاضة، في حين كانت تنمو الرأسمالية داخل قنوات التنظيمات، ولكن ليس من نوع الرأسمالية المنتجة، ولهذا فإن هذه الحركات الاشتراكية سرعان ما التحقت بالتنظيمات الدينية في أعمالها السياسية، مزيلةً آخر ما بقي من تماسك فكري وتنظيمي لها.



