حوار مع العفيف الأخضر
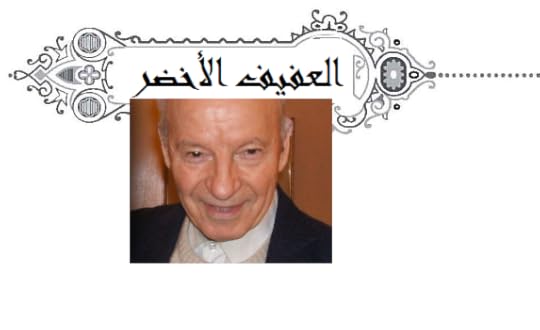
الباحث العفيف الأخضر من العقول النقدية المهمة التي نشطتْ الوعي العربي في عمليات كشف الواقع المتعدد البُنى والأنظمة والتراكيب.
وهو له دائماً قراءاتهُ التحليليةُ العميقة وتبدو الآن متباعدةً ونادرةً ولكنها ثمينة، وكان في دراساتٍ سابقةٍ يغوصُ في تعقيداتِ الهياكل الاجتماعية في عموم الشرق كما فعل في دراسة له في مجلة (قضايا فكرية) قبل سنوات، وقد كنتُ قد تابعتُ أولَ ظهورٍ فكري له في كتابِ (العسف)، عن التعذيب في الجزائر، الذي ظهرَ بعد انقلاب بومدين، فرفقتي معه طويلة!
في آخر مقالة له نشرت في موقع (الحوار المتمدن) وهي بعنوان (لماذا إصلاح الإسلام؟)، نقرأ له طرحاً يدعو لإصلاحِ الإسلام ككل عبر رؤيةٍ عامةٍ مجردة لكنها فيها تفاصيل غنية، ونقتطفُ فقرةً من مقالته رغم طولها لكنها مهمة لعرضِ وجهةِ نظرهِ:
(أمام الإسلام اليوم، أعني صناع القرار المسلمين، خياران: المراوحة في المكان أو الإصلاح. المراوحة في المكان أعطت على مرّ السنين حرباً دائمة مع الذات وحرباً مع العالم وحرباً مع العلم وحرباً مع الحداثة. إصلاح الإسلام يطمح إلى مصالحة الإسلام مع نفسه، ومع العالم الذي يعيش فيه، ومع العلم الذي يحقق اكتشافاً مهماً كل دقيقة بعضها يطرح على الوعي الإسلامي التقليدي أسئلة مُحرجة. ومع الحداثة بما هي مؤسسات سياسية وعلوم وقيم إنسانية كونية أي يسلم بسدادها ذوو العقول السليمة أينما كانوا.
مصالحة الإسلام مع نفسه بوضع حدّ للتكفير سواء تكفير المثقفين أو الفرق الإسلامية الأخرى كالمتصوفة والدروز والعلويين والأحمديين والبهائيين والشيعة…. وبوضع حد للحرب السنية – الشيعية الدائمة التي توشك أن تتحول اليوم إلى سباق تسلح نووي بين إيران وجوارها السني حامل لأخطار الحرب النووية وذلك بقبول الفصل بين الديني والسياسي، مصالحة الإسلام مع العالم تتطلب منه إعادة تعريف عميقة لعلاقته به تُنهي تقسيمه إلى دار إسلام موعودة بالتوسع ودار حرب موعودة بـ”الجهاد إلى قيام الساعة” كما يقول حديث للبخاري يَتَلَقنه المراهقون في دروس التربية الإسلامية في عدة بلدان، مصالحة الإسلام مع العلم تقتضي نسيان الإعجاز العلمي في القرآن وقبول الفصل النهائي بين القرآن والبحث العلمي والإبداع الأدبي والفني).
هذه أفكارٌ مهمةٌ لكنها مطروحة في عرض عام مجرد، رغم تخصصيها الخطاب بالتوجه نحو (صناع القرار)، فصناعُ القرارِ عموماً هم جزءٌ كبيرٌ من المشكلة. وتعبيراتٌ مثل تصالح الإسلام مع نفسه تنقلنا إلى مثاليةٍ غيرِ ماديةٍ تماماً.
التجريدُ والتعميمُ في كلامِ العفيف الأخضر يتركزان في رؤيتهِ تاريخ المسلمين المعاصرين كتاريخٍ عام، ليس فيه بُنى اجتماعيةٍ ذاتِ قوانين، وان تغييرَ حالِ المسلمين يتطلبُ رؤية هذه البُنى، ورؤية كيف تتناقض وتنمو أو تتحطم، وبهذا لابد أن نعرف لماذا كان خطابُ الإمام محمد عبده بهذا الشكل دون ذاك؟ لماذا استطاع محمد عبده أن يكون مجتهداً ولم يستطع الأزهرُ ذلك؟ (لقد خصص العفيفُ عبارةً من مقالته عن محمد عبده).
هذا يتطلبُ رؤيةَ تاريخهِ وتاريخَ البنية الاجتماعية التي جاهد فيها، وكيف كان مثقفاً دينياً مستقلاً بسبب خطاب الأفغاني الذي تبناه وكان خطاباً إسلامياً عاماً مستقلاً، وحيث كان الزعيمان منسلخين من وجهة نظر الأنظمة الشرقية الشديدة المحافظة في ذلك الوقت، ومقاربين للحداثةِ الغربيةِ في بعضِ توجهاتها الديمقراطية التنويرية، لكن هذه الوجهات النظر الإصلاحية ظلت فرديةً وفي سياقٍ ديني تقليدي كذلك.
أما الأزهر فكان تابعاً للقوى التقليدية خاصة المَلكية المصرية المحافظة وقتذاك، وقد ابتعدت القوى الدينيةُ المصريةُ عن أفكارِ المُجاهَدين الشيخين، في حين إن هذه الأفكارَ انتقلتْ وتم تبنيها لدى الوفد، وفي سياقٍ فكري مختلف كذلك، فكرست القوى التقليدية المتعددةُ من القصر الملكي والاخوان المسلمين والسيطرة البريطانية، رغم التباين بينها كذلك، نفسَها ضد الوفد وتطوره، أي ضد انتصار خيار الرأسمالية الخاصة المستقلة الديمقراطية.
هذه عينةٌ صغيرةٌ من التاريخ أقتطفُها لقراءةِ السببيات العامة وتعقيد وتركيب أي مرحلة، حيث واجهتْ القوى التقليدية نموَ الرأسمالية الخاصة المجسدة بالوفد، ثم ظهرتْ الرأسماليةُ الحكوميةُ العسكرية المجسدة بثورةِ يوليو لكي تقومَ بإصلاحٍ اقتصادي كبير، لكن الرأسمالية الحكومية ذات الشكل الدكتاتوري تنتهي بكوارث عادة. وتغدو المشكلاتُ الأكثر تعقيداً في مسائل الديمقراطية وقراءة التراث وتغيير الريف وقضايا الفساد ضرائبَ كبيرةً يجب أن تدفعها القوى الاجتماعية في مرحلةٍ تالية.
من هم صناعُ القرارِ في مصر حالياً ؟! وهل يمكن أن يتفقوا على حلولٍ مشتركة؟
إن صناعَ القرار بشكل كبير هم المسيطرون على الرأسمالية الحكومية كما جاءتهم من الفتراتِ السابقة وكما هيمنوا عليها وأضافوا تغييرات و(خصخصة) زادت الاقتصادَ فساداً وضياعاً، وهم يرفضون الانزياحَ عنها وعن فيوضِها المالية خاصةً!
وهناك الاخوان المسلمون كقوى رأسمالية – محافظة ذات جذور زراعية، ومنذ البداية رفضوا الإرث التنويري الديمقراطي من المجاهَدين الكبيرين السالفي الذكر، ومن الوفد كقوةٍ وطنية، ولكنهم في صراعاتهم الراهنة، وغياب الدكتاتورية العسكرية التي شوهت تاريخهم، أخذوا يبحثون عن أشياء جديدة ويجتهدون، لكن دون المقاربة مع الحداثة الغربية الديمقراطية التي يذوبونها بآليةٍ في الاستعمار دون تفريق عميق ودون قراءات مركبة بين الحداثة والاستعمار.
إن تغييبَ الإنجازات الديمقراطية لدى الوفد والرواد يتحدُ مع تغييبِ الإنجازات الديمقراطية لدى الغرب ولدى الثورة الإسلامية التأسيسية كذلك!
إن الترابط مع الاستبداديات الأبوية خاصة داخل الأسرة، وفي الثقافة، وغيابهم عن رأس المال الصناعي، وهيمنتهم على عامةٍ أمية غيرِ قادرةٍ على التطور السياسي، تجعل قدراتهم كمشاركين في المسئوليةِ النهضوية الراهنة تتجهُ لعدمِ تطوير الأحكام الشرعية والأفكار السياسية باتجاه العقلانية والمساواة والأنسنة.
تعتمد أفكار الأستاذ العفيف الأخضر في مقالته الآنفة الذكر (لماذا إصلاح الإسلام؟)، على التجريد العام وعلى أفكار تنويرية مهمة كذلك، لكنها تنمو داخل ذلك التجريد.
لقد وصلنا إلى تحديد بعض القوى السياسية الفاعلة الأساسية في بُنيةٍ عربيةٍ مركزيةٍ هي البنيةُ المصرية النموذجية لعمليةِ استنتاجٍ تظلُ محصورةً بها، ولا يمكن كذلك تعميمها، من أجل رؤية السببيات الكبرى هنا. وقد رأينا أصحابَ القرار الذين دعاهم العفيف الأخضر لكي يقوموا بتجديد الإسلام وتحديثه.
ورأينا كيف أن الرأسمالية الحكومية المصرية والرأسمالية الدينية المحافظة الممثلة بالاخوان المسلمين، غير قادرتين على تجديد الإسلام، لأن الأولى تتشبثُ بالمقاعدِ السلطويةِ وبإدارةِ المال العام للمواطنين، بلا أمانة، والثانية الرأسمالية المحافظة الدينية التي جاءتْ من أموالٍ أخرى نفطية وبنكية، تظلُ تريد محدوديةً في الوعي الديني لدى المودعين الصغار والعامة التابعة الغارقة في إسلام العبادات، من دون تبصر لما هو أبعد من ذلك، أي لمهمات التغيير في البُنى الاجتماعية المختلفة.
في حين أن القوةَ الثالثةَ وهي الرأسمالية الخاصة فهي أقسامٌ مشتتة، متصارعة، لديها أفكارٌ ليبراليةٌ وتجديدية، ولكنها محدودة الشعبية بسبب عدم اشتغالها فيما يشكلُ الأرزاقَ الواسعةَ لدى الجمهور، أي في الرأسمالِ الصناعي، وبالتالي هي تعجزُ عن إنتاجِ الرأسمال الفكري التجديدي.
أما اليسار فهو أقل قدرة سياسية من إحداث التجديد في الإسلام من الناحية السياسية العامة، لاعتمادهِ على عامةٍ محدودة الوعي ولا تشتغلُ بالتجديد الفكري، على الرغم من مقاربة مثقفي اليسار لتجديد الحياة أكثر من غيرهم وأعمق من بقية القوى. ودور اليسار مهم في تجميع القوى السياسية لمعركة العلمانية وتجديد حال المسلمين ومن أجل الحداثة والديمقراطية، بشرط أن يكون هذا اليسار نظيفاً غير مرتبط بقوى استغلال وفساد!
لكي يحدثَ تجديدٌ للإسلام، أي من أجل إبعاد هذه العادات ومستويات الأفكار التي كرستها القوى المحافظةُ خلال القرون السابقة والزمن الحاضر، لابد من التفاعل الديمقراطي بين القوى السياسية السابقة الذكر، وأن يتم إبعاد هذا المستوى المحافظ وهو الذي شكلتهُ في الواقع قوى استغلال المسلمين، عن الحكم، أي ألا تتكرس تلك القوى كقوى دينية، مهيمنة على النصوص، وأن تتجسد كقوى سياسية مجردة من تلك الملكية المقدسة للنصوص.
القوى الرئيسية لا تريد الابتعاد عن مطلق السلطة ومطلق التحدث باسم الدين. ولا بد كمعركة سياسية أساسية أولى من إحداث هذه النقلة التاريخية! الكراسي الدافقة للمال بين الطبقة الرأسمالية البيروقراطية – الدينية، سواء أكانت كراسي عالية أم كراسي برلمانية أم نقابية فاسدة، هي العقبة أمام تجديد الإسلام وتجديد الأوطان من هذا الجمود!
إن العديد من رجال الدين والتجار ومن المثقفين لو حصلوا على فرص للعيش وافتتاح مصانع أو ورش أو جرائد وغيرها من وسائل العمل، لجددوا رؤاهم واجتهدوا لتطوير الأحكام والأفكار ولكن كيف وهيمنة الدول على الأسواق والمال العام عقبة كبرى دون ذلك؟
من هنا تغدو نضالية اليسار الديمقراطي غير المرتبط بالفساد الحكومي والأهلى على السواء، هي القوة الفاعلة لتحليل أي بناء عربي اجتماعي، فلكل بلد عربي خصائصه ودرجة تطوره وتباين أهدافه السياسية القريبة، ومقاربة مختلف القوى بدرجات اقترابها مع مشروع الحداثة السابق الذكر، ومن دون هذا اليسار الفاعل، النشط، المحلل، فإن كل القوى تدخل في عمليات تجريب وفوضى وتراجع، لا تستطيع أن تستكشف الآفاق السياسية المراد السير فيها.
هذا هو الخيار أما أن يجلس أصحاب القرار لكي يتداوالوا أمر تغيير المجتمع، وإصلاح الدين، فأين يمكن أن يجتمعوا وفي أي فضاء مجرد يحدث هذا الاجتماع؟!
إن بلداً عربياً أو إسلامياً له درجة مقاربة مع الحداثة أكبر من بلد آخر، فتونس أقرب للحداثة من السعودية، ومن غير الممكن توحد المهمات في البلدين، لكن هذا لا يمنع أن كل دولة فيهما تبقى هي القوة المسيطرة كثيراً وكبيراً وأن مشروع الحداثة الديمقراطي النوعي غير موجود في البلدين. وبطبيعة الحال كانت قيادة تونس قد اختارت دولة الرأسمالية الخاصة وأنتج هذا الاختيار تحولات اجتماعية ديمقراطية أكبر بكثير من السعودية، والسعودية اختارت الرأسمالية الحكومية المسنودة بعلاقات بدوية وأبوية محافظة، لكن الرأسمالية الخاصة والقوى الليبرالية موجودةٌ وتنمو وتطالبُ بحريات. مثلما أن تونس لاتزال الدولة مهيمنة ورأسماليتها الحكومية هي المسيطرة.
هذا العرضُ العامُ ينفي الجزئيات المقطوعة عن السياقات، أو أنه يضعُها في أمكنتِها المناسبة، فنحن نثمن حريات تونس الفكرية لكن لا نجعلها مطلقة، وأن البلدين القيمين في تجربتيهما تونس والمغرب، لا يعني إنهما مكتملان في مسألة الحريات الجوهرية، فلاتزال أجهزةُ الدول العميقة تملكُ الكثير وتوجهُ الحياةَ كما تريد.
ثم نأتي لمسائل جوهرية أخرى تفضل الأستاذ العفيف الأخضر بطرحِها في مقالته السالفة الذكر “لماذا إصلاح الإسلام؟”، وأهمها أن يقوم الإسلام بحلِ خلافاتهِ وإنهائها عن طريق اجتماع العقلاء من الطوائف لإزالة هذا الصراع الخطر بين السنة والشيعة الذي يكاد أن يتفجر في الخليج والجزيرة العربية.
هي دعوةٌ مطلوبة ومشكورة، وحبذا لو حدثت مثل هذه اللقاءات، وتكرستْ بلقاءاتِ المثقفين والساسة. ولكن تظل هذه دعوة تجريدية كذلك، فكلُ بلدٍ يواجهُ مهماتِ تحولٍ وصراعاتٍ ملموسة ساخنة مميزة ومختلفة، ومن أهم واجبات اليسار الديمقراطي في هذه البلدان فحص هذه الصراعات وتحليلها وتجميع القوى السياسية حول حلولها بغرض إحداث تحولات باتجاه الديمقراطية والسلام والتطور.
فتأجيجُ الصراعاتِ الطائفية السياسية مؤخراً تم بسبب تصاعد دور العسكر الإيراني وتشديد قبضته على السلطة، مما جعلهُ يؤجج المنطقة ويدخلها في حروب، وهو أمرٌ ليس مضرا بطائفة من الطوائف فقط بل هو عملية إضرار بشعوب المنطقة ككل والبشرية كذلك، وهو أمرٌ لا علاقة بالشيعة والسنة، فهو صراع سياسي على السلطة، ولكن هذا الصراع السياسي يتموه بالصراع الطائفي منعاً لكشفه واستمراراً لوجوده.
وفي هذه اللحظة المفصلية ونحن نزحفُ نحو بركان مفتوح بفعلِ مغامراتِ جماعةٍ غير مسئولة، تغدو عملية مساندة القوى الشعبية الإيرانية المطالبة بالديمقراطية والتنمية والسلام في بلدها، من أكثر المهمات أهمية.
إن مقاربات الشيعة والسنة وبقية المذاهب الإسلامية والأفكار الديمقراطية التحديثية، لا تحدثُ في المجرد، ولا عبر اجتماع حكماء معزولين عن قضايا الصراعِ الملتهبة، بل تحدثُ في مثلِ هذه القضايا، تحدثُ من خلال نضالِهم المشترك من أجل الحياة والسلام، من أجل وقف مغامرات العسكريين، ووقف التدخلات الأجنبية في شئون الدول الإسلامية، ورفع أيدي الدول الشمولية في المنطقة عن الموارد والاقتصاد، وبضرورة توزيع الخيرات المادية على المواطنين ككل، مثل توزيعها على أهل صنعاء وصعدة والجنوب بشكل متساو، وبعدم تحكم فصيل في قضايا الحرب والسلم والثروة، وفي ضرورة النضال من أجل إنتاج الدولة الديمقراطية العلمانية ذات الجذور الإسلامية والمسيحية وغير هذا من المهمات المحورية في حياة المسلمين، التي هي قضايا الوجود السياسي الكبير، قضايا الحياة الفاعلة أو التفكك والفوضى.
أما قضايا الحياة الاجتماعية المعبرة عن تخلف حياة المسلمين قرونا طويلة كقضايا العقوبات غير العادلة وتعدد الزوجات وقضية الجهاد وتطبيق الحدود وغيرها من القضايا، فإنها ارتبطت ببنى اجتماعية مختلفة، كانت ثمار ظروفها الخاصة، ونحن نجد انه حتى الحكومات التقليدية تراجع مثل هذه الحدود والقوانين بشكل متدرج، في حين أن الحكومات العسكرية الدكتاتورية تواصل التشدد في قضايا الحدود بغرض السيطرة على الناس وليس الحفاظ على الشريعة.
ويعتبر الجهاد مسألة مهمة في مقاومة الغزاة ولا يمكن شطبه، وهو مختلف عن الغزو وعن الإرهاب، وقد أسس الجهادُ أمم المسلمين المتعددة، ولكنه ليس الغزو ونهب الشعوب.
إن إصلاح الحياة الاجتماعية للمسلمين مسألة متدرجة طويلة تعتمد على نمو فقه ديمقراطي، متنوع، مجتهد يتابع الظروف والحالات الملموسة للبشر ولا يصدر أحكاماً عامة تجريدية متعسفة، مثل وعي القضاة الدارسين لكل حالة، في ضوء المصلحة العامة، والمعيار هو دور الأحكام في تقدم المسلمين.
إن كل قضايانا السياسية والاجتماعية تعتمد على حل قضايانا النظامية التشكيلية، أي انتقالنا من أنظمة شبه إقطاعية – شبه رأسمالية، تهيمنُ عليها كلها أنظمةٌ رأسماليةٌ حكومية بيروقراطية فاسدة، لا تريد الانتقال للرأسمالية الحرة، بطريقة الغرب الحداثية، وأغلبية المعارضات تعيشُ في الأفق الاجتماعي نفسه، ومن دون وجود قوى يسار ديمقراطية ترفض مثل هذا الخيار، وتجمع قوى واسعة للانتقال الحقيقي للديمقراطية، ستظل التغييرات جزئية ترقيعية.
إن التراكمات النضالية السياسية العامة، والنضالات داخل البنى الاجتماعية، تتواصل في الواقع، وسوف تزداد عبر السنوات القادمة، وسوف تحدث تحولات على صعيد الحكم وعلى صعيد مفارقة الأحكام الفقهية المحافظة كذلك، أمم الغرب احتاجت إلى عشرة قرون لتحولها الواسع، ونحن لا نريد أن نصبر بضعة عقود.
إن الحوار مع باحث مثل العفيف الأخضر هو حوار خصب يفجر شرارات المعرفة ويجعل المحاور يتعلم من مناضل كرس عمره من أجل تطور أمته والعالم.



