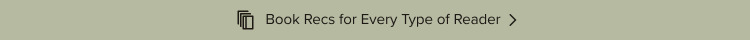نفع الحكمة وضررها!
يا ترى إيه ممكن يكون الوجه الآخر لقاعدة "عذر الجاهل بجهله"؟ بالتأكيد أنه لن يكون هناك عذر لعالم بعلمه بقى، بل العلم والمعرفة حجة على صاحبها. وفي مقدمة رسالة صغيرة للخطيب البغدادي، عنوانها "اقتضاء العلم العمل"، يعني -وهذا واضح- إننا بنتعلم عشان نعمل بعلمنا هذا، فاقتضاء العلم العمل به، وإلا أصبح العلم في رقبة صاحبه غُلاً. وكما لا تنفع الأموال إلا بإنفاقها، كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها وراعى واجبتها. يقول و"هل جامع كتب العلم إلا كجامع الفضة والذهب"، ويقصد أن من يكنز الكتب للاكتناز، مثله ككانز الذهب والفضة ولا ينفقها في سبيل الله فبشره بعذاب أليم. فالعلم والمعرفة والحكمة، تراد للعمل، وأما العمل بهذا العلم فيراد للنجا في المسلك الخطر.. ولهذا فالعلم والمعرفة والحكمة إذا ما وقرت في القلب والعقل ولم يصدقها العمل فقدت قيمتها الحقيقية. وابن خلدون في مقدمته يقول إن التحصيل والعمل أهم من تخمة الكتب وكنزها، ويحذر من أن كثرة جمع التصانيف قد يكون مشغلة عن التحصيل نفسه الذي هو المراد وهو "غاية السؤل والمأمول" وهذه عبارة استعيرها من الحلاج. وكذا الحكمة، فإن كثرة جمع الحكم دون العمل والتقدم بها عنها، يحولها إلى مجرد لغو فارغ وطق حنك، ويفقدها قيمتها. ومن الطرائف في هذا الباب أنقل هنا بعضا من مقدمة تحقيق الدكتور عبد الرحمن بدوي لكتاب "الحكمة البالغة" وهو الكتاب الذي جمعه مسكويه، ويحوي طائفة ممتازة من الحكم الشرقية الخالصة: الإيرانية، والهندية، والرومية الشرقية المنحولة، والعربية الإسلامية. وخلاصة ما أنقله من هذه المقدمة أن الحكمة والموعظة والمثل، قد تكون كلها مفيدة ونافعة وبالغة أي تامة. لكنها قد تكون، أيضا، مضرة لحاملها، وفي ذلك تفصيل..
"وهذا النوع من الأدب، أدب الأمثال والحكم والمواعظ، فيه من النفع بقدر ما فيه من الضرر. فهو إن أفاد في الحث على الفضيلة وفي استلهام الموعظة واتخاذ معايير للسلوك، فانه يضر من حيث هو قيد يشدّ النفس إلى صيغ مصنوعة وأفكار سابقة préjugées ومعان متعارفة، وهذه من شأنها أن تحجر السلوك في مجاري السنة التقليدية، مما يدعو إلى الانصراف عن التجديد والتوثب... فالنفوس المبتكرة لا ترتاد إلاّ المجهول، ولا تسير على مواطئ أقدام الأوائل، بل تفتح لنشاطها طرقاً لم تطأها من قبل أٌقدام القدماء: وهذا سر التقدم الحي للإنسانية. أما أولئك الذين يلتزمون "القواعد الذهبية"، ويتمسكون بعمود "السنة التقليدية" tradition ويستلهمون في سلوكهم ما يسمى باسم "حكمة الأمم" la sagesse des nations فلم يكونوا في الواقع غير مواطنين متوسطين "طيبين"، ولم يكونوا أبدا روادا بارزين. ولهذا نرى نموذج دون كيخوتة ينفر من الأمثال ويكره المواعظ ويدوس بقدميه حكمة الآباء؛ ومن المعلوم أن الحضارة إنما ينشئ قيمها الكبرى أمثال دون كيخوتة، وليس أولئك "المواطنين الطيبين"؛ ولهذا لا نحسبنا نعدو الحق كثيراً، إذا قرّرنا أن انتشار أدب الأمثال والحكم والمواعظ في الشرق كان من أسباب ضعفه وانحلاله، لأن الاكتفاء اللفظي كثيراً ما يقوم مقام الطاقة الفاعلة، وفي هذا التعويض يقع المرء فريسة وهم مخيف: وهم إمكان الاستغناء بالألفاظ عن الأفعال، وهو الوهم الذي يقتل كل حيوية، ويكون أذاناً بانحلال صاحبه. وفي حياة الشرق في العصر الحديث أبلغ دليل على ما نقول. ومن الأعراض الملازمة لهذا المركب النفسي الفاسد: النفاق، والتوكل، والخداع العاجز، والمشاحنة السلبية في الأحوال التي تقتضي النضال الصريح الشريف. ومن هنا كانت طائفة الوعاظ شر طائفة أخرجت للناس، لأن إحالة الوعظ إلى مهنة، تستتبع وراءها ذلك الاختلال النفسي الذي أشرنا إليه. إنما المهم في قراءة الحكم أو لدى سماعها أن يتمثلها القارئ أو السامع في نفسه، وأن يحياها في أفعاله، وأن ينفعل بها كل كيانه، وأن يحيلها إلى تجربة شخصية وكأنها مواعظ استخرجها لنفسه وبنفسه من نفسه، أو حكم قيلت في شأنه واستنبطت من حاله وأفعاله، كما كان الحلاج يفعل مع آيات القرآن. وإذن فليست الحكم صيغاً نهائية، وليست نواميس ثابتة للسلوك، بل هي بالأحرى بواعث الهام واستلهام، ودواعي توجيه والتزام، ولن تأتي أُكلها إلا إذا أضحت صوراً حية متطورة متجددة في نفس متمثلها".
"وهذا النوع من الأدب، أدب الأمثال والحكم والمواعظ، فيه من النفع بقدر ما فيه من الضرر. فهو إن أفاد في الحث على الفضيلة وفي استلهام الموعظة واتخاذ معايير للسلوك، فانه يضر من حيث هو قيد يشدّ النفس إلى صيغ مصنوعة وأفكار سابقة préjugées ومعان متعارفة، وهذه من شأنها أن تحجر السلوك في مجاري السنة التقليدية، مما يدعو إلى الانصراف عن التجديد والتوثب... فالنفوس المبتكرة لا ترتاد إلاّ المجهول، ولا تسير على مواطئ أقدام الأوائل، بل تفتح لنشاطها طرقاً لم تطأها من قبل أٌقدام القدماء: وهذا سر التقدم الحي للإنسانية. أما أولئك الذين يلتزمون "القواعد الذهبية"، ويتمسكون بعمود "السنة التقليدية" tradition ويستلهمون في سلوكهم ما يسمى باسم "حكمة الأمم" la sagesse des nations فلم يكونوا في الواقع غير مواطنين متوسطين "طيبين"، ولم يكونوا أبدا روادا بارزين. ولهذا نرى نموذج دون كيخوتة ينفر من الأمثال ويكره المواعظ ويدوس بقدميه حكمة الآباء؛ ومن المعلوم أن الحضارة إنما ينشئ قيمها الكبرى أمثال دون كيخوتة، وليس أولئك "المواطنين الطيبين"؛ ولهذا لا نحسبنا نعدو الحق كثيراً، إذا قرّرنا أن انتشار أدب الأمثال والحكم والمواعظ في الشرق كان من أسباب ضعفه وانحلاله، لأن الاكتفاء اللفظي كثيراً ما يقوم مقام الطاقة الفاعلة، وفي هذا التعويض يقع المرء فريسة وهم مخيف: وهم إمكان الاستغناء بالألفاظ عن الأفعال، وهو الوهم الذي يقتل كل حيوية، ويكون أذاناً بانحلال صاحبه. وفي حياة الشرق في العصر الحديث أبلغ دليل على ما نقول. ومن الأعراض الملازمة لهذا المركب النفسي الفاسد: النفاق، والتوكل، والخداع العاجز، والمشاحنة السلبية في الأحوال التي تقتضي النضال الصريح الشريف. ومن هنا كانت طائفة الوعاظ شر طائفة أخرجت للناس، لأن إحالة الوعظ إلى مهنة، تستتبع وراءها ذلك الاختلال النفسي الذي أشرنا إليه. إنما المهم في قراءة الحكم أو لدى سماعها أن يتمثلها القارئ أو السامع في نفسه، وأن يحياها في أفعاله، وأن ينفعل بها كل كيانه، وأن يحيلها إلى تجربة شخصية وكأنها مواعظ استخرجها لنفسه وبنفسه من نفسه، أو حكم قيلت في شأنه واستنبطت من حاله وأفعاله، كما كان الحلاج يفعل مع آيات القرآن. وإذن فليست الحكم صيغاً نهائية، وليست نواميس ثابتة للسلوك، بل هي بالأحرى بواعث الهام واستلهام، ودواعي توجيه والتزام، ولن تأتي أُكلها إلا إذا أضحت صوراً حية متطورة متجددة في نفس متمثلها".
Published on September 08, 2018 12:31
No comments have been added yet.