إيمان مرسال's Blog, page 3
January 15, 2014
GEOGRAFIA ALTERNATIVA in Spanish
صدر ديوان "جغرافيا بديلة"عن دار نشر ليبرو دِل اير في مدريد يوم 4 يناير 2014، ترجمة، لورا سالجورو ومارجريتا أوزاريو منندز.
January 4, 2014, Alternative Geography in Spanish, from LIBROS DEL AIRE, Madrid. Translated by Laura Salguero Esteban and Margarita Ossorio Menendez.
ISBN: 978-84-941469-2-3
Precio s/i : 11,54 €

Published on January 15, 2014 12:08
ممرّ معتم والمشي في مكتبة الأسرة
صدر عن مكتبة الاسرة بالقاهرة في 3 ديسمبر 2014، كتابيّ "ممرّ معتم يصلُح لتعلّم الرقص" و المشي أطول وقت مُمكن" في كتاب واحد ... يمكن الحصول عليه من مكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة في مصر.


Published on January 15, 2014 12:03
December 26, 2013
أيّام المنصورة
المدينة
ربما كان الالتحاق بجامعة عتبة مضمونة منذ الطفولة، لم يكن حلماً ولهذا لم يحتمل الشك، يمكنني الآن أن أدرك غرابة ذلك لأن عدد الفتيات اللواتي التحقن بأي تعليم فوق المتوسط في قريتي لم يتعدّ أصابع اليد الواحدة. فتيات مدرسة المعلمات كنّ يبدين أكثر أنوثة وكن يتزوجن بمجرد التخرّج، لي خالتان رأيتهما طالبتين بتلك المدرسة في المدينة، تلبسان التنانير القصيرة وتضعان الألوان الغامقة فوق الجفون على طريقة سعاد حسني، كانتا تعقصان شعرهما في شنيون عالٍ أو تلمانه في ذيل حصان. بنات الجامعة الثلاثة واللواتي ينتمين كلهن لعائلة أمي أيضاً، كن مختلفات؛ بشعر قصير وبناطيل "رجل الفيل" من الديولين أوالترافيرا مع قمصان رجالية تصل في جرأتها لدرجة أن تكون مربعات وليس وروداً. تأخرن في الزواج بشكلِ جعل التعليم الجامعي يرتبط في ذهني بالعنوسة.
الجامعة تعني المدينة، أو على الأصح مشروع التحاق بالمدينة. أول ما رأيت من جامعة المنصورة كان مستشفاها؛ أكثر من مرة ذهبت في طفولتي مع جدتي لأمي لنزور مريضاً أو مصاباً في حادث. أكثر من مرة كان يمكنني أن أنظر من شباك عنبر ما وأرى طلبة وطالبات كليات الطب بمعاطفهم البيضاء يقفون أو يتمشون في الفناء. لا أتذكر رؤية أيٍ من المرضى الذين زرتهم مرة ثانية، كانوا يموتون؛ كان المستشفى الجامعيّ هو الخطوة التي تمهد للموت. المدينة كانت بالنسبة لي مجموعة من المحطات الحية تبدأ بمحطة القطار وبتمثال أم كلثوم، بشارع السكة الجديدة حيث محلات الملابس والأحذية ومكتبة الشامي والهيئة العامة للكتاب، بالكورنيش الذي يأخذك إلى المستشفى والجامعة وبكافتيريا المستشفى حيث الاستمتاع بساندوتش جبنة رومي مع زجاجة كوكاكولا صغيرة، ولكن في سنة 1983 وبصدفة عجيبة أصبحت مدينة المنصورة هي مكان كل ما أحب والأفق الوحيد لما كنت أسميه بحكمة بالغة :الحياة.ذهبت في يناير 1983 وأنا طالبة بالصف الثاني الثانوي إلى قصر ثقافة المنصورة، كان معي ديواني الأول مطبوعاً بالآلة الكاتبة، كنت قد أصبحت شاعرة في مدينة دكرنس حيث مدرستي وفي رأي أبلة سميرة مدرسة اللغة الفرنسية وقارئتي الأولى جاء الوقت لأفتح نافذة جديدة. في مكتب بالطابق الثاني قال لي موظف اسمه أستاذ عبد المجيد: اقرأي. تنحنحت وشربت ماء وبدأت أدخل في مزاج قراءة الشعر، اخترت قصيدة اسمها "عندما أبكي غروبي" وأطلعته بفخرعليها مطبوعة في مجلة "الحصاد" وهي نشرة أدبية مستقلة ومروعة في إخراجها الفني كنت أصدرها مع شعراء من مدينة دكرنس. كانت القصيدة مؤثرة بالنسبة لي بالطبع وبعد عدة سطور دخلت موظفة محجبة ومقطوعة الأنفاس يبدو أنها تحتل المكتب الآخر في الغرفة، كانت تشتكي من أنها لم تشتر أي سجادة من المعرض لأنهم حرامية ورفعوا الأسعار، وبعد محادثة بينهما، التفت لي الموظف وقال: أكملي يا أستاذة. لممت أوراقي بغضب قائلة له أنه لا يحترم الأدب! شخص لا أعرفه كان قد راقب نهاية المشهد، فقدّم نفسه لي على أنه "وجيه عبد الهادي"، قصاص وروائي من سندوب ويعمل في سنترال تليفونات المنصورة، أخذني إلى الخارج وقال لي: "هو فيه حد أهبل يروح يقرا شعر لموظفين في قصر الثقافة؟" كان رجلاً قصيراً و طيباً و يشبه أقاربي في القرية، لم أصدق تماماً أنه كاتب؛ ربما كان لديّ تصور ما أن الكتّاب لا يجب أن يبدوا طيبين ولا أن يلبسوا صنادل مفتوحة في الأماكن العامة.
 قراءة في جامعة المنصورة 1987مشيت بحذاء النيل مع الأستاذ وجيه، تجاوزنا كوبري طلخا عن يميننا ثم مسرح المنصورة القومي عن يسارنا لندخل خلفه إلى شارع صغير ونتوقف أمام مكتب له ثلاث سلمات في مواجهة المسرح مكتوب على بابه: "مكتب النقل البطيء". في الداخل قابلت الأستاذ فؤاد حجازي لأول مرة، استمع إلى قصائدي باهتمام وأعطاني كيساً من البلاستيك مليء بالكتب التي كان قد أصدرها في سلسلة "أدب الجماهير"، كتب لي أيضاً أول اهداءات أتلقاها على روايتيه "الأسرى يقيمون المتاريس" و "نافذة على بحر طناح". كان ذلك اليوم بداية علاقة مختلفة بالمدينة، سحرتني قصة حجازي الذي لم يكمل دراسته في كلية الحقوق بسبب نشاطه السياسي الشيوعي، ثم بسبب أسره في حرب 67. أغيب عن المدرسة يوماً كل أسبوعين وآتي للزيارة، لم أذهب إلى عمل حجازي يوماً إلا وكان هناك، يجلس صبوراً بملابس مكوية، يتوقف عن حديثه ليعطي رخصة أو يخلص مخالفة عربة كارو ــ ذلك ما يُسمى بالنقل البطيء ــ لزبون لا يعرف القراءة والكتابة ويرتدي جلباباً متسخاً عادة، ثم يعود بعد ذلك ليتحدث عن ماركس أو تشيكوف أو عن كوارث الانفتاح الاقتصادي وكامب ديفيد. لم يكن هناك من عمل، المكتب للقراءة والكتابة وشرب الشاي مع الضيوف والنشطين السياسيين.قدمني حجازي إلى أفراد وجماعات من محبي الكتابة والقراءة، من أعضاء التنظيمات المعروفة والتي تحت الأرض، أعارني عشرات الكتب من الأدب الروسي المترجم وتحليلات مجتمعات ما قبل وبعد الرأسمالية. بفضله عرفت روايات صنع الله ابراهيم وعبد الحكيم قاسم ومجلة "أدب ونقد" و"الثقافة الجديدة". بكرم بالغ كان يقوم بدور الدليل، الدليل الذي سيصنع مني كاتبة "ملتزمة" بقضايا الوطن والناس. من مكتب النقل البطيء تسارع انخراطي في أنشطة كثيرة منها "لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني" في حزب التجمع، وربما كان أهم من ذلك مقابلتي لمهندسة شابة اسمها هالة إسماعيل والتي كانت مع رفيقة أخرى اسمها ثريا عبد الراضي تحلمان بمشروع مجلة نسائية يسارية اختارتا لها اسم "بنت الأرض" فانضممت إليهما بدون تردد. باختصار وقبل أن ألتحق بكلية الآداب جامعة المنصورة في 1984، بدت الجامعة حُجة لأعيش ولأمارس كل هذه النشاطات التي أحبها، بينما لم يكن لفكرة دراسة الأدب العربي نفسها سبب منطقي.لعل وعي شخص ما باختلافه عن الآخرين هو أول عتبات وعيه بذاته، لكن أن تكون مختلفا ليس له قيمة مستقلة. الآخرون على كل حال يساعدونك بدأب على اكتشاف اختلافك عنهم وعليك وقتها أن تنفي ذلك كتهمة أو تفخر به كميزة أو أن تتعامل معه فقط كواقع..أفكر أن أحلام أبي كان لها دور كبير في حبي للمدينة وما تقدمه لي منذ ذلك العمر المبكر: أبي الريفي الذي ظل أبي الشاب لأنه يكبرني بأقل من عشرين عاما، حصل على شهادة متوسطة أورثته الندم، يصدق أنه كان يمكن أن يكون شخصا ناجحاً لو اختلف الشرط. ومثل آلاف غيره ممن صدقوا أن التعليم هو الباب الوحيد للنجاة، بدأ في استثماري مبكراً بتعليمي حروف العربية وأنا في الثالثة. موت أمي جعل الاستثمار يتضاعف بحجم التضحية التي قدمها لتربيتنا. أصبح التفوق الدراسي عزاء. التشجيع على القراءة من أجل التميز. الاشتراك في المعسكرات الطلابية تنمي روح المنافسة. لم يكن ذلك يتطلب أن أشارك في الأعمال المنزلية أو أتعلم الطبيخ. كان لابد من فصلي عن تلك الصديقات اللواتي سيتزوجن مبكراً لأنهن لسن من ذوات الطموح. قدم لي أبي حرية خارج شروطها التاريخية؛ لا يهم أن أعود من المنصورة وحدي في المساء طالما أنني كنت هناك لأحضر ندوة، يدعو الكتاب الشباب للشاي حتى نخطط لمجلة الحصاد ــ تأمل العنوان ــ ويشتري نسخاً لزملائه بفخر..أظن أن تلك العلاقة بالمدينة والتي سبقت التحاقي بالجامعة هي مما جعلني أتصور أنني "مختلفة" وأن اختلافي واقع يجب ممارسته. بمجرد أن تصدق أنك مختلف ستبحث عن مختلفين مثلك. عادة ما تتصور أنهم أشباهك. يتكون سرب دون أن تنتبه. لتمارس دوراً داخله، تنتمي لشيء، تحمي نفسك من القطيع الذي في خيالك. في حالتي كان التنظيم السياسي والجمعية النسائية وجيتوهات الكتابة: كان الخروج من هذه الأسراب أقسى كثيرا من الخروج من العائلة.
قراءة في جامعة المنصورة 1987مشيت بحذاء النيل مع الأستاذ وجيه، تجاوزنا كوبري طلخا عن يميننا ثم مسرح المنصورة القومي عن يسارنا لندخل خلفه إلى شارع صغير ونتوقف أمام مكتب له ثلاث سلمات في مواجهة المسرح مكتوب على بابه: "مكتب النقل البطيء". في الداخل قابلت الأستاذ فؤاد حجازي لأول مرة، استمع إلى قصائدي باهتمام وأعطاني كيساً من البلاستيك مليء بالكتب التي كان قد أصدرها في سلسلة "أدب الجماهير"، كتب لي أيضاً أول اهداءات أتلقاها على روايتيه "الأسرى يقيمون المتاريس" و "نافذة على بحر طناح". كان ذلك اليوم بداية علاقة مختلفة بالمدينة، سحرتني قصة حجازي الذي لم يكمل دراسته في كلية الحقوق بسبب نشاطه السياسي الشيوعي، ثم بسبب أسره في حرب 67. أغيب عن المدرسة يوماً كل أسبوعين وآتي للزيارة، لم أذهب إلى عمل حجازي يوماً إلا وكان هناك، يجلس صبوراً بملابس مكوية، يتوقف عن حديثه ليعطي رخصة أو يخلص مخالفة عربة كارو ــ ذلك ما يُسمى بالنقل البطيء ــ لزبون لا يعرف القراءة والكتابة ويرتدي جلباباً متسخاً عادة، ثم يعود بعد ذلك ليتحدث عن ماركس أو تشيكوف أو عن كوارث الانفتاح الاقتصادي وكامب ديفيد. لم يكن هناك من عمل، المكتب للقراءة والكتابة وشرب الشاي مع الضيوف والنشطين السياسيين.قدمني حجازي إلى أفراد وجماعات من محبي الكتابة والقراءة، من أعضاء التنظيمات المعروفة والتي تحت الأرض، أعارني عشرات الكتب من الأدب الروسي المترجم وتحليلات مجتمعات ما قبل وبعد الرأسمالية. بفضله عرفت روايات صنع الله ابراهيم وعبد الحكيم قاسم ومجلة "أدب ونقد" و"الثقافة الجديدة". بكرم بالغ كان يقوم بدور الدليل، الدليل الذي سيصنع مني كاتبة "ملتزمة" بقضايا الوطن والناس. من مكتب النقل البطيء تسارع انخراطي في أنشطة كثيرة منها "لجنة مناصرة الشعب الفلسطيني" في حزب التجمع، وربما كان أهم من ذلك مقابلتي لمهندسة شابة اسمها هالة إسماعيل والتي كانت مع رفيقة أخرى اسمها ثريا عبد الراضي تحلمان بمشروع مجلة نسائية يسارية اختارتا لها اسم "بنت الأرض" فانضممت إليهما بدون تردد. باختصار وقبل أن ألتحق بكلية الآداب جامعة المنصورة في 1984، بدت الجامعة حُجة لأعيش ولأمارس كل هذه النشاطات التي أحبها، بينما لم يكن لفكرة دراسة الأدب العربي نفسها سبب منطقي.لعل وعي شخص ما باختلافه عن الآخرين هو أول عتبات وعيه بذاته، لكن أن تكون مختلفا ليس له قيمة مستقلة. الآخرون على كل حال يساعدونك بدأب على اكتشاف اختلافك عنهم وعليك وقتها أن تنفي ذلك كتهمة أو تفخر به كميزة أو أن تتعامل معه فقط كواقع..أفكر أن أحلام أبي كان لها دور كبير في حبي للمدينة وما تقدمه لي منذ ذلك العمر المبكر: أبي الريفي الذي ظل أبي الشاب لأنه يكبرني بأقل من عشرين عاما، حصل على شهادة متوسطة أورثته الندم، يصدق أنه كان يمكن أن يكون شخصا ناجحاً لو اختلف الشرط. ومثل آلاف غيره ممن صدقوا أن التعليم هو الباب الوحيد للنجاة، بدأ في استثماري مبكراً بتعليمي حروف العربية وأنا في الثالثة. موت أمي جعل الاستثمار يتضاعف بحجم التضحية التي قدمها لتربيتنا. أصبح التفوق الدراسي عزاء. التشجيع على القراءة من أجل التميز. الاشتراك في المعسكرات الطلابية تنمي روح المنافسة. لم يكن ذلك يتطلب أن أشارك في الأعمال المنزلية أو أتعلم الطبيخ. كان لابد من فصلي عن تلك الصديقات اللواتي سيتزوجن مبكراً لأنهن لسن من ذوات الطموح. قدم لي أبي حرية خارج شروطها التاريخية؛ لا يهم أن أعود من المنصورة وحدي في المساء طالما أنني كنت هناك لأحضر ندوة، يدعو الكتاب الشباب للشاي حتى نخطط لمجلة الحصاد ــ تأمل العنوان ــ ويشتري نسخاً لزملائه بفخر..أظن أن تلك العلاقة بالمدينة والتي سبقت التحاقي بالجامعة هي مما جعلني أتصور أنني "مختلفة" وأن اختلافي واقع يجب ممارسته. بمجرد أن تصدق أنك مختلف ستبحث عن مختلفين مثلك. عادة ما تتصور أنهم أشباهك. يتكون سرب دون أن تنتبه. لتمارس دوراً داخله، تنتمي لشيء، تحمي نفسك من القطيع الذي في خيالك. في حالتي كان التنظيم السياسي والجمعية النسائية وجيتوهات الكتابة: كان الخروج من هذه الأسراب أقسى كثيرا من الخروج من العائلة.وهم دراسة الأدب العربيتفوقي الكبير في الثانوية العامة (القسم الأدبي) كان هو العقبة الأولى في التحاقي بآداب المنصورة والتي كانت تسمى "كلية الكعب العالي" حيث كان لها صورة كلية يلتحق بها البنات المترفات ممن لا يمثل العمل بعد التخرج ضرورة لهن. أصرّ والدي الذي كان يرى في التعليم الطريق الوحيد لحياة أفضل لمن هم مثلنا أن ألتحق بإحدى كليات القمة كالإعلام أو السياسة والاقتصاد في القاهرة أو على أسوأ تقديرقسم اللغة الانجليزية بكلية التربية في المنصورة حتى أجد عملاً بمجرد التخرج. قبولي بإعلام القاهرة ثم تحويلي لقسم اللغة الانجليزية بتربية المنصورة ثم إصراري على الوصول لكلية الآداب وقسم اللغة العربية وآدابها تحديدا... كل هذا أدى إلى تأخري في إدراك المقلب المحترم الذي اخترته بكامل براءتي. منذ دخولي قاعة المحاضرات ورؤيتي لزملاء السنوات المقبلة وإحساس هائل بالاحباط لم يغادرني. دراسة اللغة العربية لم تكن أبداً اختيار معظم هؤلاء الزملاء، فكل من لم تؤهله درجاته في اللغات الأجنبية للالتحاق بأقسامها، أو ظن أن فرص العمل أكثر توفراً في هذا القسم منها في أقسام مثل الاجتماع وعلم النفس وجد نفسه هنا. طلاب اللغة العربية كانوا يسمون بـ "الفلاحين" وكأن الأقسام الأخرى لا يلتحق بها إلا أبناء المدينة. بنظرة عابرة على قاعة المحاضرات كان يمكن أن يعرف المرء أن هذا القسم يفوق عدد طالباته طلابه، وعدد محجباته سافراته، وعدد فقرائه مستوريه.
 هذه الصورة في فناء كلية الكعب العالي (آداب المنصورة) وفيها الدكتور حلمي بدير أستاذ النقد الحديث والأدب المقارن وبعض طلاب دفعة قسم عربي لا أذكر منهم إلا محمد الخريبي الذي يقف خلفي ويلبس أبيض وكان شاعراً موهوباً ولا أدري إلى أين ذهبت به الحياةبالطبع لم يكن طه حسين ولا سهير القلماوي اللذان طالما استمعت إلى أحاديثهما في الراديو أساتذة في القسم، وكانت فكرة دراسة الأدب آخر ما تنمّ عنه المناهج الدراسية. لكن خبرة الاحباط كانت أعمق من كل ذلك السراب؛ أتذكر الذهاب إلى مكتب تصويرمغطى بأكوام التراب في شارع الجلاء لشراء الملازم الدراسية التي كان يلخص فيها الأساتذة المناهج ويبيعونها بأسعار باهظة من أجل زيادة دخولهم المنخفضة، أتذكر مكتبة الكلية التي لم أفلح مرة واحدة في إيجاد أي كتاب بها، ناهيك عن استعارته منها. أتذكر تقسيم الأدب العربي طبقاً لتصور مستشرقي القرن التاسع عشر: دراسة الأدب الجاهلي في السنة الأولى، الأموي والعباسي في السنة الثانية، عصر الانحطاط في السنة الثالثة ثم بعد ذلك تصل إلى الأدب الحديث؛ لم يكن هذا المدعو "حديث" يضم حتى كاتباً مثل نجيب محفوظ أو شاعراً مثل بدر شاكر السياب، كان هناك اختيار كأنه مقصود للأكثر رداءة مما كتب في مدرسة الإحياء من شعر وتجاهل تام لما كتب منذ أواخر القرن التاسع عشر من نثر. عرفت بعد ذلك أنه كان ممنوعاً تدريس الكتّاب الأحياء حيث يجب أن يكون الكاتب ميتاً أولاً لأن الموت أوالتاريخ ربما هو ما يحدد القيمة النهائية لعمله.عندما أفكر في نشاطي الطلابي السياسي وكل المظاهرات التي شاركت فيها ضد أمريكا واسرائيل وأمن الجامعة والجماعات الاسلامية ــ التي شهدت قمة ازدهارها في ذلك الوقت ــ وعندما أتذكر مجلات الحائط التي سهرت عليها من أجل حرية المرأة أو يوم الأرض الفلسطيني أشعر بالعبث؛ لا لأن هذه الأشياء لم تكن تستحق الغضب بل لأنه كانت هناك أسباب متوفرة للغضب اليوميّ لم يفكر أحد في صياغة أية جملة عنها أو اعتراضاً عليها؛ مثلاً لم يكن يوجد حمّام للبنات في كلية الآداب! كان من العاديّ أن تدفع نقوداً لدخول حمام الأساتذة سراً، أو أن تذهب الطالبة إذا كانت مقتدرة إلى إحدى الكافيتيريات القريبة. كانت عادة كافتيريات معتمة من الداخل كأنها تبيع شيئاً غير الطعام والشراب، حيث يجلس رجال كبار السن مع سكرتيراتهم الصغيرات، ويكون على الطالبة أن تشتري شيئاً أولاً قبل أن يفتح لها بوابة النعيم في حمّام عادة ما يلخص قبحه حداثة الثمانينيات. كان هناك آلات تصوير في مكاتب ضيقة لا تعمل أو تشعر عندما تنظر إليها أنه من الأفضل أن لا تعمل، وانتظار أساتذة من المفروض أن يصلوا من القاهرة أو الاسكندرية أو طنطا ولا يصلون. أتذكر أني رأيت الدكتور محمد السباعي، الأستاذ الشهير في تدريس اللغة الفارسية، أقل من خمس مرات طوال الأربع سنوات التي كان من المفروض أن يعلمنا فيها. كان هناك طالب دراسات عليا يأتي كدوبلير له بدون اعتذار ولا مقدمات، وكان ينطق الفارسية برقة عربية مسبّلاً صوته في اتجاه الطالبات.وصل إلى فصلنا في السنة الثانية طالب روسي أشقر، لا أعرف أي قدر أرسله إلى هذه الخرابة من أجل إكمال معرفته التي كانت أفضل منا كثيراً باللغة العربية. كان لحضوره دور في أن يمارس الأساتذة خفة دمهم على لكنته، وكان هدفاً لدخول الجنة عند الكثير من الطلاب الذين يمشون خلفه في كل مكان ليقنعوه بدخول الإسلام لأنه الدين الحق. بعد شهرين أو ثلاثة بدأ هذا الطالب يجلس في آخر المدرج، ويصرخ في أي شخص يقترب منه، بدأ يأتي بملابس متسخة وشعر طويل وبعيون لم تنم، وخيل إليّ أنه لم يعد أشقر كما رأيناه أول مرة. ذات يوم اختفى من الكلية ولم نره أبداً بعد ذلك..
هذه الصورة في فناء كلية الكعب العالي (آداب المنصورة) وفيها الدكتور حلمي بدير أستاذ النقد الحديث والأدب المقارن وبعض طلاب دفعة قسم عربي لا أذكر منهم إلا محمد الخريبي الذي يقف خلفي ويلبس أبيض وكان شاعراً موهوباً ولا أدري إلى أين ذهبت به الحياةبالطبع لم يكن طه حسين ولا سهير القلماوي اللذان طالما استمعت إلى أحاديثهما في الراديو أساتذة في القسم، وكانت فكرة دراسة الأدب آخر ما تنمّ عنه المناهج الدراسية. لكن خبرة الاحباط كانت أعمق من كل ذلك السراب؛ أتذكر الذهاب إلى مكتب تصويرمغطى بأكوام التراب في شارع الجلاء لشراء الملازم الدراسية التي كان يلخص فيها الأساتذة المناهج ويبيعونها بأسعار باهظة من أجل زيادة دخولهم المنخفضة، أتذكر مكتبة الكلية التي لم أفلح مرة واحدة في إيجاد أي كتاب بها، ناهيك عن استعارته منها. أتذكر تقسيم الأدب العربي طبقاً لتصور مستشرقي القرن التاسع عشر: دراسة الأدب الجاهلي في السنة الأولى، الأموي والعباسي في السنة الثانية، عصر الانحطاط في السنة الثالثة ثم بعد ذلك تصل إلى الأدب الحديث؛ لم يكن هذا المدعو "حديث" يضم حتى كاتباً مثل نجيب محفوظ أو شاعراً مثل بدر شاكر السياب، كان هناك اختيار كأنه مقصود للأكثر رداءة مما كتب في مدرسة الإحياء من شعر وتجاهل تام لما كتب منذ أواخر القرن التاسع عشر من نثر. عرفت بعد ذلك أنه كان ممنوعاً تدريس الكتّاب الأحياء حيث يجب أن يكون الكاتب ميتاً أولاً لأن الموت أوالتاريخ ربما هو ما يحدد القيمة النهائية لعمله.عندما أفكر في نشاطي الطلابي السياسي وكل المظاهرات التي شاركت فيها ضد أمريكا واسرائيل وأمن الجامعة والجماعات الاسلامية ــ التي شهدت قمة ازدهارها في ذلك الوقت ــ وعندما أتذكر مجلات الحائط التي سهرت عليها من أجل حرية المرأة أو يوم الأرض الفلسطيني أشعر بالعبث؛ لا لأن هذه الأشياء لم تكن تستحق الغضب بل لأنه كانت هناك أسباب متوفرة للغضب اليوميّ لم يفكر أحد في صياغة أية جملة عنها أو اعتراضاً عليها؛ مثلاً لم يكن يوجد حمّام للبنات في كلية الآداب! كان من العاديّ أن تدفع نقوداً لدخول حمام الأساتذة سراً، أو أن تذهب الطالبة إذا كانت مقتدرة إلى إحدى الكافيتيريات القريبة. كانت عادة كافتيريات معتمة من الداخل كأنها تبيع شيئاً غير الطعام والشراب، حيث يجلس رجال كبار السن مع سكرتيراتهم الصغيرات، ويكون على الطالبة أن تشتري شيئاً أولاً قبل أن يفتح لها بوابة النعيم في حمّام عادة ما يلخص قبحه حداثة الثمانينيات. كان هناك آلات تصوير في مكاتب ضيقة لا تعمل أو تشعر عندما تنظر إليها أنه من الأفضل أن لا تعمل، وانتظار أساتذة من المفروض أن يصلوا من القاهرة أو الاسكندرية أو طنطا ولا يصلون. أتذكر أني رأيت الدكتور محمد السباعي، الأستاذ الشهير في تدريس اللغة الفارسية، أقل من خمس مرات طوال الأربع سنوات التي كان من المفروض أن يعلمنا فيها. كان هناك طالب دراسات عليا يأتي كدوبلير له بدون اعتذار ولا مقدمات، وكان ينطق الفارسية برقة عربية مسبّلاً صوته في اتجاه الطالبات.وصل إلى فصلنا في السنة الثانية طالب روسي أشقر، لا أعرف أي قدر أرسله إلى هذه الخرابة من أجل إكمال معرفته التي كانت أفضل منا كثيراً باللغة العربية. كان لحضوره دور في أن يمارس الأساتذة خفة دمهم على لكنته، وكان هدفاً لدخول الجنة عند الكثير من الطلاب الذين يمشون خلفه في كل مكان ليقنعوه بدخول الإسلام لأنه الدين الحق. بعد شهرين أو ثلاثة بدأ هذا الطالب يجلس في آخر المدرج، ويصرخ في أي شخص يقترب منه، بدأ يأتي بملابس متسخة وشعر طويل وبعيون لم تنم، وخيل إليّ أنه لم يعد أشقر كما رأيناه أول مرة. ذات يوم اختفى من الكلية ولم نره أبداً بعد ذلك..مرة كنا نتدافع إلى فصل قاعة المحاضرات عندما شعرت بطالبة خلفي تصرخ بفزع أن أنتظر، وقف خلفنا طابور من الطلاب يتفرجون؛ قوة عمياء شبكت الأنسيال الذهب بشراشيبه وأحصنته وجِماله وجنيهاته – كان ذلك موضة ذلك الوقت – المربوط حول معصمها الأيمن في خيوط التريكو الزرقاء فوق كتفي الأيسر، لعدة دقائق كانت طالبات ما يساعدن في تسليك خيط الذهب من خيوط الصوف، كانت النتيجة مروعة بالنسبة لي فقد تم عمل خرم محترم في كتف البلوفر ولم تعتذر صاحبة الذهب بعد أن استردت ثروتها!
محمد المخزنجيبعد أن قرأت رشق السكين، ورغم أن كثيرين من شيوعيي المدينة والجامعة كانوا ينتقدون محمد المخزنجي باعتباره "ليس شيوعياً" ولا "مناضلاً"، أصبح حلمي أن أقابله. في يوم من بداية دراستي في السنة الثانية، انتظرنا في ساحة الجامعة أن يأتي أستاذ ما لمحاضرة ما ولم يأت. ذهبت لأتمشى في شارع الثانوية في اتجاه النيل وفجأة وبدل من أن أدخل على الكورنيش يميناً اتجهت يساراً ثم يساراً آخر لأدخل إلى بوابة مستشفى الأمراض النفسية بالمنصورة. على البوابة سألت الحارس عن دكتور محمد المخزنجي وسمح لي بالدخول، ومن شخص لشخص وجدت نفسي في فناء مليء بالنزلاء.كان هناك امرأة في ثلاثيناتها تغطي شعرها بشال أحمر، جاءت في اتجاهي لتسألني عن محمود. بعد ذلك سأراها مرات في زيارات تالية وهي تمشي في دوائر لتعيد نفس السؤال على كل من ينظر إليها. في طرف الفناء كانت هناك غرفة صغيرة تشبه غرفة التليفون في دوار عمدة، وفي هذه الغرفة التي تحتوي على مكتب بسيط وكرسي واحد كان يجلس الشخص الذي سيزرع بداخلي الشك في فكرة الأيديولوجيا النهائية والمتماسكة، ربما بدون قصد.قابلت المخزنجي في لحظة من حياته كان قد عبر فيها كل التجارب التي يمكن أن تقدمها مدينة كالمنصورة لكاتب مثله، ربما نفس التجارب التي كنت أهفو لمعيشتها: الانخراط في النشاط السياسي ثم الانسحاب منه بوعي، الرهان على الحب ثم التسليم بخسارته، تحمل مسؤلية الأسرة حتى تصل لبر أمان ما ثم اكتشاف وهم وجود هذا البر، رعاية مرضى نفسيين قليلي الحيلة في مستشفى المنصورة والتورط في قصصهم ومحبتهم لسنوات ثم اكتشاف الرغبة في ترك هذا الجنون والذهاب لمكان آخر. كنت في التاسعة عشر من عمري، ممتلئة بالأمل ليس في المستقبل وحسب بل ربما في أن يكون لي دور ما في تغيير العالم، فتاة موزعة بين آباء وزعماء ونصوص وهويات ومتأرجحة بين السياسة والأدب بينما كان هو الذي يكبرني بأكثر من ستة عشر عاماً يمارس هويته الوحيدة ككاتب بل وككاتب وحيد بامتياز.منذ أول لقاء بيننا عرفت أنني أحب أن أكون معه وأنه يقدم لي هدايا لم يقدمها لي أحدٌ من قبل: متعة الارتباك أمام أسئلة وليس اجابات، متعة الحكي وليس التوجيه، متعة الضحك وليس الاتفاق في الرأي والهدف. مرة عاكسني جنود يجلسون في أحد عربات الأمن أمام باب الجامعة وأنا في طريقي إلى مكتبه في المستشفى، وصلت إليه في سمت الفيمنست الغاضبة بآراء عن تخلف الجنود وجهلهم، ابتسم مقترحاً أنهم لابد ينتظرون بملل في الحر منذ الصباح وعندما يرون بنتاً جميلة وصغيرة فمن حقهم أن يعبروا عن السعادة. مرة أخرى كنت أقول له باستياء أن زميلين شيوعيين اكتشفا أن زعيماً طلابياً شيوعياً في كلية الطب لا يعرف بنود البيان الشيوعي! فقال لي ولماذا يكون على أي أحد أن يحفظ بنود البيان الشيوعي؟قدمني المخزنجي لقراءات كثيرة لم يكن ممكناً في ذلك السياق أن أتعرف عليها وحدي منها ماركيز وناتالي ساروت وأدجار آلن بو وشعراء السبعينيات وغيرهم. كان أول من جعلني أشعر بمجرد قراءة قصيدة أمامه أين تكمن ادعاءات الكتابة وأن انتبه بشكلٍ طبيعي لأهمية الحذف والبعد عن التقعر والقواميس ولكن الأهم من ذلك هو الشعور بالأمان من مجرد أنه يعيش في نفس المدينة، شعور بالطراوة وبنضارة الأشياء كان يتلبسني عندما نلتقي.
لم يعاملني المخزنجي أبداً كحبيبة محتملة. أعتقد أن أمانته الشخصية واحساسه الأخلاقي بالمسؤولية عن فتاة وصلت لحياته في لحظة خاطئة، متأخرة أكثر من اللازم، صغيرة أكثر مما يجب، جعلاه أيضاً مرتبكاً بين تقديم أبوة روحية حيث يقف مني على مسافة من الوعي والخبرة بالحياة وبين ممارسة صداقة كان من الصعب إثبات نديّتها. ذات ظهيرة أخذني إلى مكان لطيف على نيل طلخا للغداء، كانت تلك هي المرة الوحيدة التي أذهب معه لمكان كهذا ولا أظن ذلك كان يمكن أن يحدث إلا لأنه جهز حقائبه بالفعل للسفر إلى كييف في نفس الأسبوع ولأجل غير مسمى. يومها وضعت الكحل لأول مرة في حياتي ولم أكن أعرف كيف أقوم بذلك باتقان. عندما جاء الحساب توترت لأنه سيدفع ذلك المبلغ الكبير من وجهة نظري وأنا عادة أدفع حسابي كفتاة "ماركسية مستقلة" في أي مكان أذهب إليه. غطيت توتري بالضحك: "أنا ماليش دعوة ". سفر المخزنجي إلى كييف كان بداية شعور خفيّ بالفقد وأحياناً باليتم خلال السنتين المتبقيتين لي في الجامعة. رغم انخراطي في الكثير من الأحداث وتصور الكثيرين أنهم يحبونني وتحولي إلى مصدر إلهام في قصائد كانت تبدو مهمة في ذلك المشهد الأدبي ــ بالطبع ليس من أجلي بل بسبب قانون الندرة الذي كان سيجعل أية فتاة في مكاني تحظى بالانتباه والتميز ــ فلم أدخل في أية علاقة عاطفية حتى تركت المنصورة. بدوت محمية بذكرى حبيب غائب ومحصنة ضد أية رغبة في الدخول في تجارب. في تلك الفترة بدأت أمارس هواية المشي من مبنى الكلية إلى مستشفى الأمراض النفسية ومنها إلى الشارع الذي تسكن فيه أسرته قرب وسط المدينة. كنت أمشي ممتلئة بحضور المخزنجي وباحثة عن علامات وجوده في الطرقات.
انخراط في الجماعات
 أيمن عبد الرحيم، إيمان مرسال، محمود الزيات والشاعر الرائع عماد أبو صالح. أمامنا محمد سالم واقفاً وأحمد الخضري جالساً وخلفنا محمد عبد المعطي ودكتور علي الأخ الأصغر لمحمد المخزنجي وكان عازف جيتار ممتازفشل ما توقعته من تعلم أو معرفة داخل الجامعة وغياب المخزنجي من حياتي كان قوة طاردة دفعتني للانخراط أكثر في نشاطات شتى سأنسحب بالتدريج منها فيما بعد. نادي أدب جامعة المنصورة والذي تعرفت عليه منذ سنتي الجامعية الأولى كان نتاج مشهد أدبيّ ثريّ في المدينة وكان أيضاً ساحة صراع أيديولوجي بين الجهاد والشيوعيين من ناحية وبينهما معاً ضد ما يسمى بـ "أمن الجامعة" من ناحية ثانية. لقاءات هذا النادي كانت تتم كل يوم خميس في الحادية عشرة ظهراً، كان هناك طاولة كبيرة وأنيقة يمكن أن يجلس حولها أكثر من عشرين شخصاً وكانت قاعة الاجتماع نفسها فسيحة ومرتبة ولها شبابيك زجاجية كبيرة يمكنك أن ترى منها الأشجار وأحواض الزهور من ثلاث جهات. كان التيار الإسلامي يمارس معاييره الأدبية من خلال شخصية أساسية لها حضورها وتأثيرها في الجامعة كلها خلال منتصف الثمانينيات؛ محمود الزيات والذي كان طالباً في كلية الهندسة منذ سنوات طويلة وكان غنياً لدرجة أنه لم يكن يهتم بالتخرج. الزيات كان منخرطاً في تنظيم الجهاد كمُنظر وفيلسوف، وكان يمشي وحوله هالة تبدأ من غموض النظارة الشمسية التي يرتديها في كل مكان، ولا تنتهي بمريديه الذين يقرأون نصوصهم وعيونهم على تعبيرات وجهه، ولا بهدوئه وقصائده الجميلة وصوته الرخيم وبيت له وحده في وسط المدينة يتردد عليه المهمومون والمأرّقون في أي ساعة من الليل.كان هذا الأب الروحي لفلول من الكتّاب الشباب في منتصف ثمانينيات المنصورة هو أحد الألغاز التي قابلتها في تلك السن الصغيرة؛ ورغم التحذيرات الكثيرة من شيوعيي المرحلة الذين يرون أنني أنتمي لهم بألا أقترب من هذا الشخص البتة، بدأت صداقتي الغريبة به من تقارب ذوقنا الشعري رغم اختلافنا البين في كل شيء آخر. لقد كنت أشك بسبب انتقاءاته وتحيزاته للشعر في هويته المنَظمة سياسياً ودينياً من الأساس. كان يخيل لي أن لديه حياة أخرى غامضة وفي خلال سنة وجدت نفسي مشتركة معه في برنامج قراءة مكثف يبدأ بسيد قطب والمودودي ويشمل الكثير من الأوراق والأبحاث الجهادية النظرية التي لم تكن تخلو من ذكاء وتماسك. ادعى الزيات – أو هكذا أظن الآن – أنه يقرأ الماركسية عبر استعارته لكتب كثيرة مني. كان ذلك يرضي غروري باعتبار أن نقاشاتنا متكافئة، وأن كلينا يبحث عن شيء ما. تطورت نقاشاتنا حول ما نقرأه سريعاً إلى صراع خفيّ بين الجهاديين والشيوعيين حول استقطاب رفيقة أو أخت ممكنة. لم "أرتد" عن قناعاتي ولم تبدُ علامات الإيمان عليّ وبالطبع لم يكن مطروحاً أن يحدث له ذلك وتحولت تلك الصداقة إلى حرب معلنة بيننا كما بين طابورين من المدعمين للطرفين. أصبح يقضي وقته في فناء كلية الآداب رغم أنها تقع خارج الحرم الجامعي حيث توجد كلية الهندسة وأصبح له عيون إذا غاب لتتابع وتحوّل حياة أي طالب يتحدث مع الشيوعيين أو يقترب منهم إلى جحيم.مؤكد أنني أتحدث عن زمن آخر يبدو خيالياً في 2010 ولكنه كان واقعاً ويومياً في 87 و88 من القرن الماضي. أتذكر لحظة الوصول للجامعة وكأنها استعداد لمعركة ممكنة بالأيدي والأظافر إذا لزم الأمر. مرة قطع أحد الاسلاميين مجلة حائط لي بمجرد ما أن أتممت تعليقها، في المرة الثانية وقف الزيات يحرس مجلتي التالية مدافعاً عن حرية التعبير ومشجعاً فلولاً من أتباعه ليكتبوا ويعلقوا أقذع الشتائم بجانبها. لعب دوراً في تجييش كل الطلاب المتأسلمين ضدي في انتخابات اتحاد طلاب الكلية في السنة الرابعة، وأصبح مستحيلاً عليّ أن أدخل نادي الأدب الذي ذهبت إليه آخر مرة في بداية ذلك العام مع نبيل القط وعبد المنعم الباز فوجدنا رجالاً ملتحين وقويي البنية وفي يد كل منهم قصيدة لابد أن الزيات نفسه قد كتبها لهم. استمر بعض الليبراليين والشيوعيين في مواجهة أسلمة نادي الأدب بتفانِ حيث رأوا أن مهمتهم الأساسية منع تأثير هذا الزعيم على القادمين الجدد. وبدأت في سنتي الجامعية الأخيرة أنسحب من الصراع مع الأعداء إلى التعالي عليهم. أتذكر أن أكثر الكلمات التي كانت على لساني في تلك الفترة كانت من قبيل "متخلف"، "رجعي"، "عفن".. بعد التخرج بسنوات كان الزيات قد مر بتجربة السجن التي غيرته كثيراً بطريقة ليس هنا مجال لوصفها. كنت أعيش في القاهرة بقلق يختلف عن سنوات المنصورة. تقابلنا مرات كأصدقاء ليس لديهم قناعات يموتون من أجلها ولا رغبة في استقطاب عضو جديد لتنظيماتهم السياسية. بدأت أكتشف خفة دمه وبعض آلامه التي تظهر في حسه السوداوي المتهكم على نفسه وعلى العالم. معرفتي بالزيات كانت واحدة من تجاربي الهامة في سنوات الجامعة، كانت طريقتي في أن أكون مستقلة نسبياً عن الأخوة الشيوعيين، أن أجرب شيئاً لا يخلو من خطورة على مسئوليتي الشخصية، وكانت أول تجربة عزل وأذى لا تخلو من قسوة مررت بها من أجل ما كنت أعتقد أنه "قناعاتي". لا أستطيع أن أحدد الآن ماذا كانت تلك القناعات، ما أهميتها؟ إلى أي حد شغلت ساعات وأياماً وسنوات؟ ولكن لابد أنها كانت هناك. ربما، على أي حال، كانت تستحق النضال من أجلها.
أيمن عبد الرحيم، إيمان مرسال، محمود الزيات والشاعر الرائع عماد أبو صالح. أمامنا محمد سالم واقفاً وأحمد الخضري جالساً وخلفنا محمد عبد المعطي ودكتور علي الأخ الأصغر لمحمد المخزنجي وكان عازف جيتار ممتازفشل ما توقعته من تعلم أو معرفة داخل الجامعة وغياب المخزنجي من حياتي كان قوة طاردة دفعتني للانخراط أكثر في نشاطات شتى سأنسحب بالتدريج منها فيما بعد. نادي أدب جامعة المنصورة والذي تعرفت عليه منذ سنتي الجامعية الأولى كان نتاج مشهد أدبيّ ثريّ في المدينة وكان أيضاً ساحة صراع أيديولوجي بين الجهاد والشيوعيين من ناحية وبينهما معاً ضد ما يسمى بـ "أمن الجامعة" من ناحية ثانية. لقاءات هذا النادي كانت تتم كل يوم خميس في الحادية عشرة ظهراً، كان هناك طاولة كبيرة وأنيقة يمكن أن يجلس حولها أكثر من عشرين شخصاً وكانت قاعة الاجتماع نفسها فسيحة ومرتبة ولها شبابيك زجاجية كبيرة يمكنك أن ترى منها الأشجار وأحواض الزهور من ثلاث جهات. كان التيار الإسلامي يمارس معاييره الأدبية من خلال شخصية أساسية لها حضورها وتأثيرها في الجامعة كلها خلال منتصف الثمانينيات؛ محمود الزيات والذي كان طالباً في كلية الهندسة منذ سنوات طويلة وكان غنياً لدرجة أنه لم يكن يهتم بالتخرج. الزيات كان منخرطاً في تنظيم الجهاد كمُنظر وفيلسوف، وكان يمشي وحوله هالة تبدأ من غموض النظارة الشمسية التي يرتديها في كل مكان، ولا تنتهي بمريديه الذين يقرأون نصوصهم وعيونهم على تعبيرات وجهه، ولا بهدوئه وقصائده الجميلة وصوته الرخيم وبيت له وحده في وسط المدينة يتردد عليه المهمومون والمأرّقون في أي ساعة من الليل.كان هذا الأب الروحي لفلول من الكتّاب الشباب في منتصف ثمانينيات المنصورة هو أحد الألغاز التي قابلتها في تلك السن الصغيرة؛ ورغم التحذيرات الكثيرة من شيوعيي المرحلة الذين يرون أنني أنتمي لهم بألا أقترب من هذا الشخص البتة، بدأت صداقتي الغريبة به من تقارب ذوقنا الشعري رغم اختلافنا البين في كل شيء آخر. لقد كنت أشك بسبب انتقاءاته وتحيزاته للشعر في هويته المنَظمة سياسياً ودينياً من الأساس. كان يخيل لي أن لديه حياة أخرى غامضة وفي خلال سنة وجدت نفسي مشتركة معه في برنامج قراءة مكثف يبدأ بسيد قطب والمودودي ويشمل الكثير من الأوراق والأبحاث الجهادية النظرية التي لم تكن تخلو من ذكاء وتماسك. ادعى الزيات – أو هكذا أظن الآن – أنه يقرأ الماركسية عبر استعارته لكتب كثيرة مني. كان ذلك يرضي غروري باعتبار أن نقاشاتنا متكافئة، وأن كلينا يبحث عن شيء ما. تطورت نقاشاتنا حول ما نقرأه سريعاً إلى صراع خفيّ بين الجهاديين والشيوعيين حول استقطاب رفيقة أو أخت ممكنة. لم "أرتد" عن قناعاتي ولم تبدُ علامات الإيمان عليّ وبالطبع لم يكن مطروحاً أن يحدث له ذلك وتحولت تلك الصداقة إلى حرب معلنة بيننا كما بين طابورين من المدعمين للطرفين. أصبح يقضي وقته في فناء كلية الآداب رغم أنها تقع خارج الحرم الجامعي حيث توجد كلية الهندسة وأصبح له عيون إذا غاب لتتابع وتحوّل حياة أي طالب يتحدث مع الشيوعيين أو يقترب منهم إلى جحيم.مؤكد أنني أتحدث عن زمن آخر يبدو خيالياً في 2010 ولكنه كان واقعاً ويومياً في 87 و88 من القرن الماضي. أتذكر لحظة الوصول للجامعة وكأنها استعداد لمعركة ممكنة بالأيدي والأظافر إذا لزم الأمر. مرة قطع أحد الاسلاميين مجلة حائط لي بمجرد ما أن أتممت تعليقها، في المرة الثانية وقف الزيات يحرس مجلتي التالية مدافعاً عن حرية التعبير ومشجعاً فلولاً من أتباعه ليكتبوا ويعلقوا أقذع الشتائم بجانبها. لعب دوراً في تجييش كل الطلاب المتأسلمين ضدي في انتخابات اتحاد طلاب الكلية في السنة الرابعة، وأصبح مستحيلاً عليّ أن أدخل نادي الأدب الذي ذهبت إليه آخر مرة في بداية ذلك العام مع نبيل القط وعبد المنعم الباز فوجدنا رجالاً ملتحين وقويي البنية وفي يد كل منهم قصيدة لابد أن الزيات نفسه قد كتبها لهم. استمر بعض الليبراليين والشيوعيين في مواجهة أسلمة نادي الأدب بتفانِ حيث رأوا أن مهمتهم الأساسية منع تأثير هذا الزعيم على القادمين الجدد. وبدأت في سنتي الجامعية الأخيرة أنسحب من الصراع مع الأعداء إلى التعالي عليهم. أتذكر أن أكثر الكلمات التي كانت على لساني في تلك الفترة كانت من قبيل "متخلف"، "رجعي"، "عفن".. بعد التخرج بسنوات كان الزيات قد مر بتجربة السجن التي غيرته كثيراً بطريقة ليس هنا مجال لوصفها. كنت أعيش في القاهرة بقلق يختلف عن سنوات المنصورة. تقابلنا مرات كأصدقاء ليس لديهم قناعات يموتون من أجلها ولا رغبة في استقطاب عضو جديد لتنظيماتهم السياسية. بدأت أكتشف خفة دمه وبعض آلامه التي تظهر في حسه السوداوي المتهكم على نفسه وعلى العالم. معرفتي بالزيات كانت واحدة من تجاربي الهامة في سنوات الجامعة، كانت طريقتي في أن أكون مستقلة نسبياً عن الأخوة الشيوعيين، أن أجرب شيئاً لا يخلو من خطورة على مسئوليتي الشخصية، وكانت أول تجربة عزل وأذى لا تخلو من قسوة مررت بها من أجل ما كنت أعتقد أنه "قناعاتي". لا أستطيع أن أحدد الآن ماذا كانت تلك القناعات، ما أهميتها؟ إلى أي حد شغلت ساعات وأياماً وسنوات؟ ولكن لابد أنها كانت هناك. ربما، على أي حال، كانت تستحق النضال من أجلها.بيت لي وحديالتحاق طلاب من قرى ومدن بعيدة بالجامعة كان يعني أن أمامهم عدة اختيارات – ربما كلمة "اختيارات" غير دقيقة لأنها لم تكن ترتبط فقط بالمزاج الشخصي بل بالوضع الاجتماعي والطبقي؛ إما السفر اليومي بين بيت الأهل والجامعة حيث المواصلات العشوائية على الطرق الزراعية والحوادث والانتظار تحت المطر أو في الحر لساعات أحياناً، أوالسكن في المدينة الجامعية وتناول وجباتها الرديئة والالتزام بالتواجد تحت نظر المشرفين في الثامنة مساء وعدم الاقتراب من المظاهرات أو إظهار التدين الشديد لأن نتيجته المباشرة هي الطرد من جنة الدعم الحكومي. كان هناك بعض الطلاب ممن عندهم المال والشجاعة ليشتركوا في إيجارشقة مما يسمح لهم بحرية التعرف على المدينة ويجعلهم مسئولين عن طعامهم وأوقات عودتهم. الصدفة وحدها جعلتني خارج هذه الاختيارات؛ لقد عشت سنواتي الجامعية في شقة لي وحدي في الدور الرابع من عمارة مكونة من خمسة أدوار تقع على بعد دقائق مشي من كلية الآداب. كان خالي المدرس يعيش مع أسرته في شقتيّ الدور الثاني وتعيش خالتي المدرسة أيضاً وأسرتها في شقتيّ الدور الثالث، وكانت الشقة الوحيدة المؤجرة في بيت أسرة أمي تقع أمام شقتي وتسكنها سيدة في العشرينيات مع ابنها الذي اسمه وحيد بينما الدور الخامس مغلق في انتظار أن يكبر أولاد الخال أو الخالة ويتزوجوا فيه.
بيت لي وحدي في سنوات الجامعة كان خبرة مؤثرة في شخصيتي وعاداتي ومعاناتي في المستقبل من الحياة مع آخرين. لم يكن للأمر علاقة بـ "الحرية"؛ بالطبع كانت هناك رقابة سكان الأدوار السفلى، عندما أتأخر عن التاسعة في اجتماع بنت الأرض أو بالذهاب للسينما، في المشي على الكورنيش وشرب الشاي في مقهى أدريانا أو في قراءة شعرية أرمي حجر صغير في شباك غرفة أميمة ابنة خالي حتى تفتح نور البلكونة فأعرف أن الطريق أمان حيث خالي في الشقة الأخرى أو في الخارج. عندما تطفيء النور أو تفتحه لتطفئه يكون عليّ أن أتمشى بعض الوقت حتى تأتي الإشارة بأن الوقت مناسب للدخول. مرة ذهبت مع بنات بنت الأرض (هالة اسماعيل وثريا عبدالراضي) إلى القاهرة منذ الصباح؛ كان يوماً لا يُنسى قابلنا فيه عبدالعزيز جمال الدين في مقهى علي بابا، كنا نعرفه بسبب مجلته مصرية وكان يساعدنا متبرعاً في الإخراج الفني لمجلة بنت الأرض، وقابلنا سناء المصري في مقهى آخر وكانت أول مرة أتعرف عليها وبعد ذلك حضرنا ندوة في شارع ضريح سعد في جمعية نوال السعداوي النسائية وعدت للبيت حوالي الحادية العشرة مساء فرميت حجر صغير في شباك بنت الخال وأضيء النور فدرت حول البيت ووضعت المفتاح في بوابة المبنى كالمعتاد... وجدت خالي أمامي ينتظرني وعلى وجهه تعبير:عرفت أفعالكن أيتها "الخائنات".إذا وضعت هذه الرقابة وبعض المواجهات الحادة مع خالي جانباً، إذا تناسيت ذلك الرعب من التخبط في قطة نائمة في سلام أثناء صعود السلالم ليلاً، فتلك الشقة كانت إحدى هدايا السماء التي لا تتوقعها فتاة في وضعي. أتذكر سعادة لصق رسومات على الحائط والجلوس في البلكونة في ساعات الليل أستمع إلى الموسيقى حيث مصابيح الشارع الممتد والمحلات التي تغلق بالتدريج، الاستيقاظ في الصباح بكآبة خفيفة لم يكن ليخدشها إفطارعائليّ أو الاضطرار للحديث مع أحد. كان يمكن أيضاً ترك كتاب مفتوح على الأرض أو قصيدة لم تكتمل على السرير.
أخوة الأدببدأنا نُدعى لنقرأ في قرى ومدن صغيرة، وما زلت أذكر بهجة التجمع في مبنى كلية أو أمام بوابة الجامعة: السؤال عن المواصلات، الميكروباسات المجنونة على طرق زراعية، وجلوسي منكمشة بين رجال– شباب من الشعراء؛ كنت أبدو دائماً بينهم كأخت صغرى ليس لحجمي وحسب ولكن ربما – أظن الآن– أن التوتر المكتوم بسبب "الجندر" كان يتم تحويله إلى أخوة أدبية وتضامن سرب صغير ضد قطيع العالم الخارجي الذي كان بالضرورة غير أدبي. أتذكر الوصول لمكان القراءة معاً وكأننا فرقة موسيقية؛ إحساس لطيف بروح "العازفين" فيما بيننا. كان من يدعونا عادة طالب آخر في الجامعة وله في السياسة أو الأدب أو كليهما، لكن وللصدق، كان يحدث ان نتواطأ أحياناً مع طالب وجيه في قومه، يريد أن يُحضر شعراء إلى مضيفة أو نادي شباب قريته وأن يعزمنا على طعام دسم في بيت والده. ذهبنا إلى أماكن لم أر بعضها بعد ذلك: بدواي، أجا، بلقاس، المحلة، المنزلة، ديم الشلت... كيف لم يستوقفني أني البنت الوحيدة عادة وأبداً؟في مساء يوم جمعة كنا مدعويين إلى نادي شباب منية النصر، كان حماسي كبيراً لتلبية دعوة هشام قشطة الذي كنت قد تعرفت عليه منذ سنوات. ولكن كانت خطوبة ابنة خالي أميمة التي هي صديقة طفولتي في نفس اليوم. بعد تردد قررت الذهاب إلى الندوة! لابد أن تياراً ما كان يجرفني بعيداً عن صديقات الطفولة، فحين حضرت فرح نفس ابنة الخال بعد ذلك بعام فوجئت بأنني فقدت مكاناً كنت أشغله قبل ذلك والآن نسيت وجوده: لم تسألني العروس عن رأيي في الفستان أو المكياج، لم أكن قادرة على المساهمة في احترام الطقوس أو المجاملات. أنوثة صديقات الطفولة في حميمية الحكي والاشتراك في تفاصيل الحفل وفي الرحلات الدؤوبة إلى متاجر السكة الجديدة ازدهرت واستقرت بينما أنا خارجها.
لديّ صورة من هذا الفرح. أبدو فيها بنظارة سميكة وقوام منحن قليلاً، وجهي ليس واضحاً بسبب انعكاس الفلاش على زجاج النظارةوصلت إلى منية النصر مع شعراء أذكر منهم محمود الزيات ومحمد عبدالوهاب السعيد وأحمد الخضري وآخرين. كان في انتظارنا هشام قشطة وفنان تشكيلي يساريّ التوجه يحتفل بافتتاح معرضه الأول في نفس القاعة اسمه عاطف وبدأ ألم عنيف يضرب بطني. في نادي الشباب حيث لا فتاة غيري، بدأ الكابوس بإدراك أنها بداية الدورة الشهرية. ادعيت الصداع حتى أذهب إلى صيدلية وأشتري فوطاً صحية لكن أحد الشعراء الحنونين أصر أن يأتي معي لأني لا يجب أن أمشي وحدي في مدينة غريبة، وبعنف لعله بدا غير مبرر صممت أنني لا أريد منه أن يصحبني. مؤكد أنه كان مرعباً مجرد تخيل أن أخاً في الأدب يراني أشتري شيئاً كهذا. مشهد آخر في الكابوس بدأ بعد أن عدت ظافرة بالفوط مخبأة في قعر الحقيبة: لا يوجد حمام في نادي الشباب، فقط مبولة شديدة القذارة وبابها لا يغلق. بعد نجاحي في حماية البنطلون من أية بقع دموية محتملة ظل أصدقائي يسألونني عن الصداع فأقول من قلبي: الحمد لله. بدا الصداع ولا يزال مقبولاً أكثر من آلام البطن. أقل سرية، وبالتأكيد أقل أنوثة وسط إخوان الأدب.
نُشِر هذا النص في العدد العاشر من مجلة "أمكنة". كل الشكر لعلاء خالد
Published on December 26, 2013 21:33
November 16, 2013
محمود عمر - حتّى تتخلّى إيمان مرسال عن فكرة البيوت
ترى إيمان مرسال (1966) ما نعجز نحن، لفرط انشغالنا، عن رؤيته. تمسك بلحظات إنسانيّة تكاد تبدو عاديّة قبل أن نكتشف حين تصيّر تلك اللحظة شعرًا كم كنّا نحن مخطئين وعاديين. الشاعرة المصريّة المقيمة في كندا تكتب قصيدة سرديّة حديثة تطول حينًا وتقصر أحيانًا، لكنها تظلّ، في كلّ الأحوال، محتفظة بنصيب وافر من الذكاء والخفّة وربما قلنا: من الفلسفة.
في ديوانها الأخير «حتى أتخلى عن فكرة البيوت» الذي صدر عن داري «شرقيات» و «التنوير» تهجس إيمان مرسال بالحب، بالمنفى والمسافات الطويلة. الديوان الذي يقع في 92 صفحة ويضم 37 قصيدة مكتوبة بين 2007 و 2010 مقسّم إلى ثلاثة أجزاء هي: «وفاتتني أشياء». «ونصنع وهمًا ونتقنه». «الحياة في شوارعها الجانبيّة». صدرت لمرسال من قبل أربعة دواوين هي: «اتصافات» (1990)، «ممر معتم يصلح لتعلم الرقص» (1995)، «المشي أطول وقت ممكن» (1997)، و «جغرافيا بديلة» (2006). ويبدو أنّ الشاعرة التي طلّقت الشعارات الكبيرة لا يزال في جعبتها المزيد.
 Mahmoud Omarفي حديثها لإذاعة مونت كارلو الدوليّة، قالت إيمان مرسال عن الديوان: «طبيعة اللحظات والتجارب التي عشتها ساعدتني كثيرًا في الكتابة». اللحظات تلك، حين نقرأ الديوان، نكتشف كم هي لحظات هشّة وعابرة لولا نقاط تفتيش إيمان مرسال التي تستوقفها وتفتّش فيها عمّا هو أبديّ. في قصيدتها «مقبرةٌ سأحفرها» ترسم مرسال مشهدًا لها وهي في طريقها إلى المقبرة التي ستحفرها للعصفور الميّت بين يديها. الجنازة المكونة من شخص واحد كان يجب أن تكون مهيبة، تقول القصيدة، «لولا هذا الحذاء الرياضيّ» تقول القصيدة والقواعد التي لم يكتبها أحد، واتّفق عليها الجميع .التخلّي كلمة مركزيّة في حياة الشاعرة الأربعينيّة، وفي اشتغالاتها الفكريّة. سواء كان ذاك التخلّي كبيرًا وقديمًا حين يتعلق الأمر بشعارات القوميّة والقضايا الكبرى (في الديوان قصيدة عنوانها «كأس مع أحد القوميين العرب»)، أو كان تخليًا متأخرًا وفرديًا. عن الأخير قالت إيمان مرسال: «هذا هو النضج بالنسبة لي، أن تتخلى عن مقولات حول الكتابة والغرض منها. مقولاتٌ كنت أنت نفسك قد وقفت وراءها ودافعت عنها».«"الربيع العربيّ» ليس ربيعًا حقًا بالنسبة لإيمان مرسال. في لحظة الاندلاع، لحظة القمّة، كانت تشعر، وكثيرون معها، أنّ ما يحصل «أكبر منّا كأفراد». ربما سمعت هي أيضًا «أجنحة التاريخ ترفرف فوق ميدان التحرير»، لكن المستقبل القريب كشف عن بؤس الخطاب الثوري، إذ قدّمت الانتفاضات جديدًا في الغرافيتي والموسيقى لكن «أبدًا ليس في اللغة»، حسب رأي الشاعرة البعيدة.في قصائد الديوان الأخير، ليس هنالك مستوى واحد للواقع، بل عدّة مستويات. في قصيدة قصيرة نسبيًا، يمكن لإيمان مرسال أن تنتقل، وتنقل معها القارئ، من قارة إلى قارة، من توقيت إلى توقيت. إقامتها في بلد بعيد عن «هنا» جعلها تورده في القصائد على أنّه «هناك» وتتساءل بسخرية بيضاء: «ماذا يفعل شخصٌ جاء إلى «هنا» ليقرأ قصائده عن «هناك» / لأناسٍ ليسوا من «هناك» حين يأكله الذنب / سوى أن يقف مثلي الآن في شرفة فندق خمس نجوم ويشعل سيجارة / ثم يلعن العالم بالصراخ والهمهمة».عن اليوميّ والمعاصر، عن السير الذاتيّة وتلك «الحياة التي حَشرَ فيها أكثر من أب طموحه، أكثر من أمّ مقصاتها / أكثر من طبيب مهدئاته، أكثر من مناضل سيفه، أكثر من مؤسسة غباوتها، أكثر من مدرسة شعرية تصوّرها عن الشعر». عن العالم الذي ينقصه شبّاك أزرق، عن الحبّ الذي قد يكون نسيان رجل لساعته بجوار السرير، وعن فكرة البيوت تكتب إيمان مرسال. تكتب حتى تتخلّى وتقول: «ليكن البيت هو المكان الذي لا تلاحظ البتة إضاءته / السيئة، جدار تتسع شروخه حتى تظنها يومًا بديلاً / للأبواب».
Mahmoud Omarفي حديثها لإذاعة مونت كارلو الدوليّة، قالت إيمان مرسال عن الديوان: «طبيعة اللحظات والتجارب التي عشتها ساعدتني كثيرًا في الكتابة». اللحظات تلك، حين نقرأ الديوان، نكتشف كم هي لحظات هشّة وعابرة لولا نقاط تفتيش إيمان مرسال التي تستوقفها وتفتّش فيها عمّا هو أبديّ. في قصيدتها «مقبرةٌ سأحفرها» ترسم مرسال مشهدًا لها وهي في طريقها إلى المقبرة التي ستحفرها للعصفور الميّت بين يديها. الجنازة المكونة من شخص واحد كان يجب أن تكون مهيبة، تقول القصيدة، «لولا هذا الحذاء الرياضيّ» تقول القصيدة والقواعد التي لم يكتبها أحد، واتّفق عليها الجميع .التخلّي كلمة مركزيّة في حياة الشاعرة الأربعينيّة، وفي اشتغالاتها الفكريّة. سواء كان ذاك التخلّي كبيرًا وقديمًا حين يتعلق الأمر بشعارات القوميّة والقضايا الكبرى (في الديوان قصيدة عنوانها «كأس مع أحد القوميين العرب»)، أو كان تخليًا متأخرًا وفرديًا. عن الأخير قالت إيمان مرسال: «هذا هو النضج بالنسبة لي، أن تتخلى عن مقولات حول الكتابة والغرض منها. مقولاتٌ كنت أنت نفسك قد وقفت وراءها ودافعت عنها».«"الربيع العربيّ» ليس ربيعًا حقًا بالنسبة لإيمان مرسال. في لحظة الاندلاع، لحظة القمّة، كانت تشعر، وكثيرون معها، أنّ ما يحصل «أكبر منّا كأفراد». ربما سمعت هي أيضًا «أجنحة التاريخ ترفرف فوق ميدان التحرير»، لكن المستقبل القريب كشف عن بؤس الخطاب الثوري، إذ قدّمت الانتفاضات جديدًا في الغرافيتي والموسيقى لكن «أبدًا ليس في اللغة»، حسب رأي الشاعرة البعيدة.في قصائد الديوان الأخير، ليس هنالك مستوى واحد للواقع، بل عدّة مستويات. في قصيدة قصيرة نسبيًا، يمكن لإيمان مرسال أن تنتقل، وتنقل معها القارئ، من قارة إلى قارة، من توقيت إلى توقيت. إقامتها في بلد بعيد عن «هنا» جعلها تورده في القصائد على أنّه «هناك» وتتساءل بسخرية بيضاء: «ماذا يفعل شخصٌ جاء إلى «هنا» ليقرأ قصائده عن «هناك» / لأناسٍ ليسوا من «هناك» حين يأكله الذنب / سوى أن يقف مثلي الآن في شرفة فندق خمس نجوم ويشعل سيجارة / ثم يلعن العالم بالصراخ والهمهمة».عن اليوميّ والمعاصر، عن السير الذاتيّة وتلك «الحياة التي حَشرَ فيها أكثر من أب طموحه، أكثر من أمّ مقصاتها / أكثر من طبيب مهدئاته، أكثر من مناضل سيفه، أكثر من مؤسسة غباوتها، أكثر من مدرسة شعرية تصوّرها عن الشعر». عن العالم الذي ينقصه شبّاك أزرق، عن الحبّ الذي قد يكون نسيان رجل لساعته بجوار السرير، وعن فكرة البيوت تكتب إيمان مرسال. تكتب حتى تتخلّى وتقول: «ليكن البيت هو المكان الذي لا تلاحظ البتة إضاءته / السيئة، جدار تتسع شروخه حتى تظنها يومًا بديلاً / للأبواب». شبكة قدس الإخبارّيّة، 17 أبريل 2013.
Published on November 16, 2013 21:52
عبلة الرويني - لم تُصفق الباب وراءها
 عبلة الرويني
عبلة الروينيلم تمارس إيمان مرسال لعبة الأمهات فى إخفاء الوجه عن أطفالهن، ثم كشفه سريعاً، لتعود الضحكة إلى وجوه الأطفال، لم تمارس تلك اللعبة مع أطفالها أبداً، فقبل أكثر من ثلاثين عاماً ماتت أمها، وما زالت تنتظر وجهها أن يظهر مرة أخرى.. تمسك إيمان بالصورة الفوتوغرافية الوحيدة التى تجمعها وأمها، طفلة فى الخامسة (لا تبتسم)، تقف إلى جوار أمها (التى لا تبتسم أيضاً، رغم أنها لم تكن تعرف أنها ستموت بعد ذلك بسبعة وأربعين يوماً، بالضبط) صورة فوتوغرافية هى كل ما تبقى من الأم، هى كل الذاكرة، وكل الشعر (سيكون مضحكاً التفكير أن علاقتى بألعاب الأطفال شكلها غياب أمى، والأنكى الادعاء أن موتها هو سبب وجودى هنا، بعد أكثر من ثلاثين عاماً، وكأننى أجرب غياباً وهمياً عن كل هؤلاء الذين أريد أن أكون معهم)..
قبل عشر سنوات، غادرت إيمان مرسال مصر، إلى كندا (أستاذة فى إحدى جامعاتها) تزوجت أمريكياً، وأنجبت أبناء أمريكيين، تنقلت من مدينة إلى مدينة، ومن فندق إلى متحف، إلى معرض، إلى مهرجان، ومن (طريق الحرير) شرقاً، إلى (طريق العبيد) جنوباً.. سافرت كى تمشى وحدها أياماً، أو سنوات، لتكتشف بعد كل هذه السنوات، أنه لا جغرافيا بديلة، وأنها تحتاج أكثر، إلى كل هؤلاء الذين تصحو وتنام بدونهم، وأنها سافرت لتجرب غياباً وهمياً عن كل الذين تريد أن تكون معهم.. غادرت إيمان مصر دون أن تصفق الباب وراءها، كما سبق وفعلت (نورا) فى مسرحية أبسن (بيت الدمية)، إيمان تركت الباب مفتوحاً، لأنها ستعود دائماً..صفقة الباب المدوية التى أطلقتها (نورا) وهى تغادر بيت الزوجية إلى الأبد، تلك الصفقة التى هزت أوروبا كلها فى القرن الـ19، بحثاً عن سؤال المرأة، وجودها وحريتها.. صفقة نورا التى عصفت برومانسية عصرها، واتخذت مثالاً للتمرُّد على البيت والتقاليد، حاسمة العلاقة بين الحقيقة والوهم.. ظلت خارج ذاكرة الشاعرة المصرية، فلم تكن إيمان يوماً تلك الدمية، ولم يكن خروجها مدوياً، ولم تصفق الباب وراءها، بحثاً عن حرية، أو رغبة فى التمرّد على البيت والأهل والتقاليد، خرجت لتمارس الاكتشاف والرغبة فى المعرفة، وتواصل لعبة الأمهات، يختفين، ليظهرن مرة أخرى أكثر حباً والتصاقاً..ديوان إيمان مرسال الخامس (حتى أتخلى عن فكرة البيوت) الصادر قبل أسابيع عن دارى (شرقيات - التنوير) سردية أقرب إلى السيرة، سيرة على اتساع حركتها، وتنقلاتها بين أزمنة الطفولة وأماكنها، بين وجوه الأهل والأصدقاء، لم تقع فى (النوستالجيا) فاللغة محايدة، خالية من المبالغات العاطفية.. ورغم استخدام السرد، فالشاعرية تحضر بكثافة، مفارقات مدهشة ربما أقل سخرية من قصائد سابقة، لكنها أكثر عذوبة، كسر للمتوقع الجمالى، خروج متواصل، وكثافة فى الحركة منحت الديوان حيوية الإيقاع، وحرية مضاعفة فى التقاط التفاصيل ورؤيتها وإدهاشنا.
جريدة الوطن 31 مارس 2013.
Published on November 16, 2013 21:30
August 23, 2013
تشارلز سيميك: "ذُبابة في الحساء"، الفصل الأول
قصتي قصة قديمة وأصبحت الآن مألوفة. لقد تشرّد كثيرٌ من الناس في هذا القرن: أعدادهم مهولة ومصائرهم الفردية والجماعية متنوعة، سيكون مستحيلاً لي أن أدّعي وضعاً متميّزاً كضحية، أنا أو أي شخصٍ آخر- إذا أردتُ الصدق. خاصةً أن ما حدث لي منذ خمسين سنة يحدث لآخرين اليوم. رواندا، البوسنة، أفغانستان، كوسوفو، والأكراد المهانون بصورة لا تنتهي- وهكذا يستمر الحال. قبل خمسين سنة كانت الفاشية والشيوعية، الآن هناك القومية والأصولية الدينية مما يجعل الحياة لا تطاق في أماكن كثيرة. في الآونة الأخيرة، على سبيل المثال، كنت أترجم قصائد من سراييفو لأنطولوجيا شعرية واجه محرّروها صعوبات كبيرة في العثور على الشاعرة التي كتبتها. لقد اختفت. هي لم تكن مغمورة، كان لديها الكثير من الأصدقاء، لكن يبدو أن لا أحد يعرف ما حدث لها في فوضى الحرب."مشردون"
الحقيقة هي أننا لم يكن عندنا أجوبة واضحة. بعد ترجرجنا في القطارات المخيفة وفوق الشاحنات والسفن التجارية المهلهلة، أصبحنا لغزاً حتى لأنفسنا. في البداية، كان ذلك صعباً علينا ولكن بمرور الوقت بدأنا نتعوّد. بدأنا نتذوق هذا الوضع ونستمتع به. أن تكون لا أحد بدا لي شخصياً أكثر إثارة من أن تكون شخصاً ما. الشوارع كانت مليئة بأولئك الأشخاص المهمين وهم يصنعون أجواء الثقة حولهم. نصف الوقت كنت أحسدهم، نصف الوقت كنت أنظر إليهم في شفقة. لقد كنت أعرف شيئاً لم يعرفوه، شيئاً من الصعب معرفته إذا لم يركلك التاريخ بقوة في مؤخرتك: كيف يبدو الأفراد غير ضروريين وعديمي الأهمية ضمن أي صورة كبيرة! كيف أن هؤلاء القُساة لا يفهمون احتمال أن يكون ذلك هو مصيرهم أيضاً
يسخر سيميك بوضع "DP" بين قوسين للاشارة إلى المصطلح Displaced Persons الستار الحديدي Iron Curtainبمعنييه المادي والمجازي هو ما كان يفصل بين أوروبا الغربية والشرقية، وقد ظل هذا الستار الذي فرضه الاتحاد السوفيتي السابق قائما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 وحتى نهاية الحرب الباردة بانهيارالاتحاد السوفيتي عام 1990. مؤتمر يالطا عقد بين 4 و11 فبراير 1945، وحضره رؤساء أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي لإعادة ترتيب أوربا التي مزقتها الحرب العالمية الثانية.
الحقيقة هي أننا لم يكن عندنا أجوبة واضحة. بعد ترجرجنا في القطارات المخيفة وفوق الشاحنات والسفن التجارية المهلهلة، أصبحنا لغزاً حتى لأنفسنا. في البداية، كان ذلك صعباً علينا ولكن بمرور الوقت بدأنا نتعوّد. بدأنا نتذوق هذا الوضع ونستمتع به. أن تكون لا أحد بدا لي شخصياً أكثر إثارة من أن تكون شخصاً ما. الشوارع كانت مليئة بأولئك الأشخاص المهمين وهم يصنعون أجواء الثقة حولهم. نصف الوقت كنت أحسدهم، نصف الوقت كنت أنظر إليهم في شفقة. لقد كنت أعرف شيئاً لم يعرفوه، شيئاً من الصعب معرفته إذا لم يركلك التاريخ بقوة في مؤخرتك: كيف يبدو الأفراد غير ضروريين وعديمي الأهمية ضمن أي صورة كبيرة! كيف أن هؤلاء القُساة لا يفهمون احتمال أن يكون ذلك هو مصيرهم أيضاً
يسخر سيميك بوضع "DP" بين قوسين للاشارة إلى المصطلح Displaced Persons الستار الحديدي Iron Curtainبمعنييه المادي والمجازي هو ما كان يفصل بين أوروبا الغربية والشرقية، وقد ظل هذا الستار الذي فرضه الاتحاد السوفيتي السابق قائما منذ نهاية الحرب العالمية الثانية عام 1945 وحتى نهاية الحرب الباردة بانهيارالاتحاد السوفيتي عام 1990. مؤتمر يالطا عقد بين 4 و11 فبراير 1945، وحضره رؤساء أمريكا وبريطانيا والاتحاد السوفيتي لإعادة ترتيب أوربا التي مزقتها الحرب العالمية الثانية.
Published on August 23, 2013 07:43
August 18, 2013
تشارلز سيميك: ذبابة في الحساء. ترجمة: إيمان مرسال
_1_ قصتي قصة قديمة وأصبحت الآن مألوفة. لقد تشرّد كثيرٌ من الناس في هذا القرن: أعدادهم مهولة ومصائرهم الفردية والجماعية متنوعة،
سيكون مستحيلاً لي أن أدّعي وضعاً متميّزاً كضحية، أنا أو أي شخصٍ آخر- إذا أردتُ الصدق. خاصةً أن ما حدث لي منذ خمسين سنة
يحدث لآخرين اليوم. رواندا، البوسنة، أفغانستان، كوسوفو، والأكراد المهانون بصورة لا تنتهي- وهكذا يستمر الحال. قبل خمسين سنة
كانت الفاشية والشيوعية، الآن هناك القومية والأصولية الدينية مما يجعل الحياة لا تطاق في أماكن كثيرة. في الآونة الأخيرة، على سبيل
المثال، كنت أترجم قصائد من سراييفو لأنطولوجيا شعرية واجه محرّروها صعوبات كبيرة في العثور على الشاعرة التي كتبتها.
لقد اختفت. هي لم تكن مغمورة، كان لديها الكثير من الأصدقاء، لكن يبدو أن لا أحد يعرف ما حدث لها في فوضى الحرب. "مشردون" الوثائقية القديمة أوجيوشاً يُحارب بعضها البعض، قرى ومُدناً تتصاعد منها النيران والدخان، لا يخطر ببالك الناس المتكدسون في الأقبية.
لقد دفع السيد البريء والسيدة البريئة وأسرتاهما ثمناً باهظاً في هذا القرن لمجرد وجودهم هناك. مدانون تاريخياً _ كما كان يحب
الماركسيون أن يقولوا _ ربما انتموا إلى طبقة خاطئة، جماعة عرقية خاطئة، دين خاطىء _ إلى آخره_ هم كانوا وما زالوا تذكيراً غير
سار بكل أخطاء اليوتوبيات الفلسفية والقومية. لقد جاءوا بخِرقهم البالية ومناظرهم التعسة ويأسهم، جاؤا زرافات ووحدانا من الشرق، هاربين من الشر بدون أية فكرة عمّا ينتظرهم. لم يكن لدى أحد في أوربا ما يكفيه ليأكل، وهنا جاء اللاجئون المتضورون جوعاً، مئات الألوف منهم في قطار
ات، مخيّمات، وسجون، يغمسون خبزاً يابساً في حساء مائي، يبحثون عن قمل في رؤوس أطفالهم، ويندبون بمختلف اللغات مصيرهم المروّع. أسرتي، مثل أسر أخرى عديدة، تمكنت من أن ترى العالم مجاناً، والفضل يعود لحروب هتلر وسيطرة ستالين على أوربا الشرقية. نحن لم نكن متعاونين مع الألمان ولا كنا من المنتمين إلى الطبقة الأرستقراطية، كما لم نكن بأي معنى من المنفيين السياسيين. عديمو الأهمية كُنا، لم نقرر شيئا لأنفسنا. كل شيء رتبه قادة العالم في وقتها. كالكثير من النازحين لم يكن لدينا طموح يتعدى حدود مدينتنا بلجراد. كنا على ما يُرام مع ذلك. اتفاقيات عُقدت حول مجالات النفوذ، حدود أعيد ترسيمها، وما يسمى بالستار الحديديّYugoslav passport issued June 18, 1953 for Simic (top) and his brotherأتذكر الوقوف في طوابير لا نهاية لها أمام مقر البوليس في باريس من أجل استلام أو تجديد تصريح الإقامة. يبدو ذلك وكأنه كل ما كنا نقوم به عندما كنا نعيش هناك. ننتظر نهاراً كاملاً فقط لنكتشف أن القوانين قد تغيّرت منذ زيارتنا الماضية، أنهم الآن يطلبون، على سبيل المثال، شيئاً على قدر من العبث مثل وثيقة زواج والديّ أمي أو شهادة تخرّجها من المدرسة، هذا على الرغم من أنها في طريقها للحصول على شهادة فرنسية لأنها أنهت دراستها العليا في باريس. وبينما كنا نقف هناك نتأمل في استحالة ما يطلبونه منا، كنا نستمع إلى شخص أمام الشباك المجاور يحاول أن يقول في فرنسية ضعيفة كيف احترق بيتهم، كيف غادروا مهرولين بحقيبة واحدة صغيرة، وهلم جرا، إلى أن يهز الضابط كتفيه ويشرع في إعلامهم أنه إذا لم تُقدّم الوثائق فوراً فسيتم إلغاء تصريح الإقامة.
أسرتي، مثل أسر أخرى عديدة، تمكنت من أن ترى العالم مجاناً، والفضل يعود لحروب هتلر وسيطرة ستالين على أوربا الشرقية. نحن لم نكن متعاونين مع الألمان ولا كنا من المنتمين إلى الطبقة الأرستقراطية، كما لم نكن بأي معنى من المنفيين السياسيين. عديمو الأهمية كُنا، لم نقرر شيئا لأنفسنا. كل شيء رتبه قادة العالم في وقتها. كالكثير من النازحين لم يكن لدينا طموح يتعدى حدود مدينتنا بلجراد. كنا على ما يُرام مع ذلك. اتفاقيات عُقدت حول مجالات النفوذ، حدود أعيد ترسيمها، وما يسمى بالستار الحديديّYugoslav passport issued June 18, 1953 for Simic (top) and his brotherأتذكر الوقوف في طوابير لا نهاية لها أمام مقر البوليس في باريس من أجل استلام أو تجديد تصريح الإقامة. يبدو ذلك وكأنه كل ما كنا نقوم به عندما كنا نعيش هناك. ننتظر نهاراً كاملاً فقط لنكتشف أن القوانين قد تغيّرت منذ زيارتنا الماضية، أنهم الآن يطلبون، على سبيل المثال، شيئاً على قدر من العبث مثل وثيقة زواج والديّ أمي أو شهادة تخرّجها من المدرسة، هذا على الرغم من أنها في طريقها للحصول على شهادة فرنسية لأنها أنهت دراستها العليا في باريس. وبينما كنا نقف هناك نتأمل في استحالة ما يطلبونه منا، كنا نستمع إلى شخص أمام الشباك المجاور يحاول أن يقول في فرنسية ضعيفة كيف احترق بيتهم، كيف غادروا مهرولين بحقيبة واحدة صغيرة، وهلم جرا، إلى أن يهز الضابط كتفيه ويشرع في إعلامهم أنه إذا لم تُقدّم الوثائق فوراً فسيتم إلغاء تصريح الإقامة.
هكذا، ما الذي كنا نفعله؟ حسنٌ، عندما يكون الجو لطيفاً كنا نذهب لنجلس على مقعد شارع نشاهد الباريسيين المحظوظين وهم يتنزهون، يحملون البقالة، يدفعون عربات أطفالهم، يُمشّون كلابهم، وحتى يُصفّرون. في بعض الأحيان يقف أمامنا اثنان ليتعانقا، بينما نحن نلعن الفرنسيين وحظنا التعس. في النهاية نُجرجر أقدامنا بتثاقل إلى غرفتنا الصغيرة بالفندق ونكتب رسائل للأهل. بالطبع، لا يصل البريد بسرعة. كُنا نُجَن كل يوم ولمدة أسابيع في انتظار البوسطجي الذي لم يكن يتحمّل رؤيتنا لأننا كنّا نضايقه، مع ذلك، وبشكل ما، كانت الوثائق تصل، بفضل قريب ما من بعيد. ولا بد من ترجمتها بعد ذلك على يد مترجم مُعتمد، يكون عادة غير قادر على التفرقة بين رأس وذيل طيّات الورقة ذات الخمسين عاماً من مدرسة في مقاطعة في البلقان أو من دفتر تسجيل كنيسة. في كل الأحوال، كنا نعود إلى الطابور الطويل فقط لنكتشف أن هذه الوثائق لم تعد مهمة، ولكن شيئاً آخر أصبح مطلوباً. في كل مكتب لجوازات سفر، في كل قسم بوليس، في كل قنصلية، يوجد مكتب وخلفه موظف حذر سيء المزاج يشتبه في أننا ندعي غير حقيقتنا. لا أحد يحب اللاجئين. الوضع المبهم لأن تُسمّى "مُشرّداً" جعل الأمر أكثر سوءاً. المسئولون الذين يقابلوننا لا يعرفون من أين أتينا ولماذا، ولكن هذا لم يمنعهم من إصدار حكمهم علينا. قد يجلب لك قدراً من التعاطف أن تكون مطروداً بسبب النازية، أما أن تُغادر بلدك بسبب الشيوعية فهذا ما يصعب قبوله. إذا كان المسئولون يساريين، فسيقولون لنا بفظاظة أننا تُعساء ناكرون للجميل، أننا تركنا خلفنا أكثر المجتمعات تقدماً وعدالة على وجه الأرض. الآخرون حسبونا مجرد رعاع بشهادات مزيفة وماضٍ مشبوه. حتى الدُمى المبتسمة خلف فتارين المحلات في شارع فيكتور هيجو الأنيق عاملتنا وكأننا هناك لنسرق شيئاً. في الحقيقة كان الأمر بسيطاً للغاية: إما أننا كنا سنحصل على موطيء قدم هنا أو في مكان آخر، أو سنعود إلى مخيم للاجئين، أو، الأسوأ، إلى "التجسيد الكامل لشوق الانسان العميق للعدالة والسعادة" كما اعتاد العالم الشيوعي أن يوصف في بعض الجهات. الهجرة، المنفى، أن تكون بلا جذور وأن تصبح منبوذاً، ربما يكون ذلك أكثر الطرق المبتكرة لاقناع الفرد بالطبيعة الاعتباطيّة لوجوده أو وجودها. لسنا في حاجة إلى طبيب نفسيّ أو مُرشد روحيّ طالما أن كل من نقابلهم يسألوننا من أنتم بمجرد أن نفتح أفواهنا ويسمعون اللكنة . الحقيقة هي أننا لم يكن عندنا أجوبة واضحة. بعد ترجرجنا في القطارات المخيفة وفوق الشاحنات والسفن التجارية المهلهلة، أصبحنا لغزاً حتى لأنفسنا. في البداية، كان ذلك صعباً علينا ولكن بمرور الوقت بدأنا نتعوّد. بدأنا نتذوق هذا الوضع ونستمتع به. أن تكون لا أحد بدا لي شخصياً أكثر إثارة من أن تكون شخصاً ما. الشوارع كانت مليئة بأولئك الأشخاص المهمين وهم يصنعون أجواء الثقة حولهم. نصف الوقت كنت أحسدهم، نصف الوقت كنت أنظر إليهم في شفقة. لقد كنت أعرف شيئاً لم يعرفوه، شيئاً من الصعب معرفته إذا لم يركلك التاريخ بقوة في مؤخرتك: كيف يبدو الأفراد غير ضروريين وعديمي الأهمية ضمن أي صورة كبيرة! كيف أن هؤلاء القُساة لا يفهمون احتمال أن يكون ذلك هو مصيرهم أيضاً.
2- عندي صورة لوالدي وهو يلبس بدلة سوداء و يحمل خنزيراً صغيراً تحت إبطه. إنه في مركز الصورة وبجانبه امرأتان جميلتان في فساتين سهرة قصيرة وضحكة جميلة في عيونهما السواداء. هو أيضاً يضحك. فم الخنزير مفتوح ولكن لا يبدو أنه يضحك. إنه حفل رأس السنة. السنة هي 1928 ويبدو أنهم في أحد الملاهى الليليّة. عند منتصف الليل أُطفئت الأنوار وتم الإفراج عن الخنزير. أثناء الهرج والمرج قبض والدي على الخنزير المتألم. أصبح ملكه. بعد تشجيع الناس، أخذ حبلاً من النادل وربط الخنزير برجل الطاولة. زار والدي والمرأتان عدداً من الأماكن الأخرى في تلك الليلة. وذهب معهم الخنزير وهو مربوط بالحبل. لقد أجبروه على شرب الشمبانيا معهم وعلى لبس قبعة الحفلات. بعد سنوات عديدة سيسميه والدي "الخنزير المسكين". عند الفجر كان والدي وحده مع الخنزير يشربان في بار متواضع بالقرب من محطة السكة الحديد. في الطاولة بجانبهما كان هناك كاهن سكران يكلّل عروسين. رفع الشوكة والسكين في وضع صليب ليبارك الزوجيْن. بعد ذلك أهداهما والدي الخنزير كهدية لزواجهما. الخنزير المسكين. لكن هذه ليست نهاية القصة. ففي 1948، عندما كان والدي في طريقه إلى أمريكا ونحن نتضور جوعاً في بلجراد، اعتدنا أن نقايض ممتلكاتنا بالطعام. بإمكانك أن تحصل على دجاجة مقابل حذاء رجالي بحال جيد. الساعات والفضيات ومزهريّات الكريستال وأطباق الصيني الفخمة تم مقايضتها بلحم ودهن الخنزير والسجق وأشياء من هذا القبيل. في إحدى المرّات، طلب غجريٌّ قبعة والدي الرسمية. لم تكن على مقاسه. مقابل هذه القبعة التي غطت عينيه عندما جرّبها، ناولنا بطة حية. بعد ذلك بأسابيع جاء أخوه ليرانا. بدا ثريّاً. سنّة أمامية من الذهب، ساعتان، واحدة في كل يد. الآخر، كما يبدو، كان قد انتبه لبذلة سهرة سوداء عندنا. في الواقع كنا نترك هؤلاء الناس يتجولون بين الغرف يقيّمون البضائع. يتصرفون كأنه بيتهم، يفتحون الأدراج، ينظرون في الخزانات. يعرفون أننا لن نعترض. كنّا جوعى. على أي حال، أحضرت أمي بذلة سهرة 1926. كان باستطاعتنا أن نرى فوراً كيف وقع الرجل في غرامها. عرض علينا في مقابلها أولاً دجاجة ثم دجاجتيْن. لسبب ما أصبحت أمي عنيدة. الأعياد على الأبواب. لقد أرادت خنزيراً رضيعاً. الغجريّ أصبح غاضباً، أو مثّل أنه غاضب. الخنزير أكثر مما ينبغي. لكن أمي لم تستسلم. عندما تركب رأسها فهي تساوم بضراوة. بعد ذلك بسنوات في دوفر نيوهامشر، راقبتها وهي توصل بائع أثاث إلى شفا الجنون. عرض عليها أن تأخذ الكنبة مجاناً فقط ليتخلّص منها. الغجريّ كان أكثر تشدّداً. غادرنا. بعدها بأيام عاد ليُلقي نظرةً أخرى. وقف يحدّق في البذلة عند أمي كأنه يريد أن يتخلّص منّا في نفس الوقت. نظر ونظرنا. في النهاية، تنفّس الصعداء كرجلٍ يتخذ قراراً صعباً ولا رجعة فيه. حصلنا على الخنزير في اليوم التالي. كان حيّاً ويشبه إلى حد كبير الخنزير في الصورة.
3- في البدء ... الراديو. كان على طاولة بجانب سريري. كان له زر تحكّم يُضيء، ثم تظهر أسماء المحطات. ولم يكن باستطاعتي القراءة بعد فكنتُ أسأل الآخرين أن يقرأوها لي. هناك أوسلو، لشبونة، موسكو، برلين، بودابست، مونت كارلو، وغيرها الكثير. تضع السهم الأحمر موازياً للاسم، فتنبثق لغة غريبة وموسيقى غير مألوفة. في العاشرة، تتوقف المحطات عن البث. الحرب مستمرة. هذا العام هو 1943. لقد أمضيت ليالي طفولتي مع هذا الراديو، إنني أُرجع الأرق الذي صاحبني طوال حياتي لسِحره. لم يكن ممكناً أن أبعد يديّ عنه. حتى بعد أن تتوقف المحطات عن البث. استمرُّ في تحريك زرّ التحكّم وأدرس الضوضاء المختلفة. مرة سمعت صفارات شفرة مورس. فكرت أن هناك جواسيس. أحياناً كنت ألتقط محطة بعيدة خافتة ويكون عليّ أن أضع أذني على خشونة الغطاء التي تغطي مركز الصوت. أحياناً كانت تندلع موسيقى رقص أو تكون اللغة جذابة جداً فأستمع إليها مدة طويلة، وأشعر أنني على وشك أن أفهمها. كل ذلك كان ممنوعاً منعاً باتاً. كان من المفروض أن أكون نائماً. أفكر في ذلك الآن، ربما كنت خائفاً من الوحدة في تلك الغرفة الكبيرة. الحرب مستمرة. البلاد محتلة. أشياء فظيعة حدثت في الليل. كان هناك حظر تجول. أحدهم كان متأخراً. شخصٌ آخر في الغرفة المجاورة يمشي جيئة وذهاباً. ستائر من الورق الأسود معلقة على الشبابيك. كان شيئاً مرعباً أن تنظر من خلالها إلى الشارع _ الشارع الخالي المظلم. أتخيل نفسي وأنا أمشي على أطراف أصابعي ويدٌ على الستارة، أريد أن أنظر ولكني خائف من انعكاس الضوء الخافت للراديو على جدار غرفة النوم. والدي متأخر والثلج يغطي السطوح في الخارج. في 6 إبريل 1941، كان عمري ثلاث سنوات، ضربت قنبلة في الخامسة صباحاً المبنى المقابل من الشارع مما أدى إلى اشتعال النار فيه. بلجراد التي وُلدتُ فيها، لديها فرادة غير مؤكّدة فقد قصفها النازيون في عام 1941، والحلفاء في عام 1944، والناتو في عام 1999. عدد القتلي في ذلك اليوم من أبريل _ والذي أطلق عليه الألمان "عملية عقابية" _ يتراوح بين خمسة وسبعة عشر ألفاً، وهو أكبر عدد من القتلى المدنيين في يوم واحد خلال العشرين شهر الأولى من الحرب. كانت المدينة قد تعرضت لأربع مئة قاذفة وأكثر من مئتيّ طائرة مقاتلة في يوم أحد الشعانين هل كان العالم حقاً رماديّاً وقتها؟ في ذكرياتي المبكرة كان العالم دائماً في أواخر الخريف. الجنود رماديون، وهكذا كان الناس. الألمان يقفون في الزاوية. نحن نمرّ بجانبهم. "لا تنظر إليهم"، تهمس أمي. نظرت إليهم على أي حال، وواحد منهم ابتسم. لسبب ما أخافني ذلك. في ليلة جاء الجستابو لاعتقال والدي. كانوا يفتشون في كل مكان محدثين ضجة كبيرة. كان والدي قد ارتدى ملابسه بالفعل. كان يقول شيئاً، ربما كان ينكّت. تلك كانت طريقته. مهما كان الوضع قاتماً، كان يجد شيئاً مضحكاً ليقوله. بعد سنوات عديدة، محاطاً بالأطباء والممرضات بعد تعرضه لأزمة قلبية خطيرة، أجاب على سؤالهم "كيف تشعر الآن يا سيدي؟" بـ "أن طلب بيتزا وبيرة". ظن الأطباء أنه تعرض لتلف في المخ. كان عليّ أن أشرح لهم أن هذا سلوك طبيعي بالنسبة له. على الأرجح أنني عدت للنوم بعد أن أخذوا والدي. على كل حال لم يحدث شيءٌ في تلك المرة. أفرجوا عنه. لم يكن ذنبه أن أخاه الأصغر سرق شاحنة من الجيش الألماني ليأخذ صديقته في نزهة. الألمان كانوا مندهشين، تقريباً مذهولين من الجرأة. أرسلوه للعمل في ألمانيا. لقد قاموا بالمحاولة، ولكنه تسلّل من بين أصابعهم. وفّر لنا زمن الحرب ملاهي للرياضة وزحاليق وبيوتاً خشبية وحصوناً ومتاهات يمكن العثور عليها في ذلك الخراب عبر الشارع. كان هناك جزء قد تبقى من الدرج، كنا نصعد بين الحطام وفجأة تظهر السماء! ولد صغير سقط على رأسه ولم يعُد أبداً لما كان عليه. أمهاتنا حرّمن علينا الاقتراب من الدمار، هدّدننا، حاولن أن يشرحن المخاطر الكثيرة التي تنتظرنا، مع ذلك كنا نذهب. جالسون بسعادة بين أطلال غرفة طعام شخصٍ ما بالدور الثالث، يأتينا من الشارع تحتنا صياح واحدة من أمهاتنا وهي تشير إلينا بينما ابنها يهرول إلى أسفل مجاهداً في تذكر أين كان يضع قدميه أثناء الصعود. كنا نلعب جنوداً، استمرت الحرب. نزلت القنابل. ولعبنا جنوداً. أطلقنا النار على بعضنا البعض طوال النهار. طاخ طخ _ طيخ. سقطنا قتلى على الرصيف. ركضنا بين الزحام مقلدين صوت الطائرات المقاتلة وهي تغطس وتقب. ثم أصبحنا حاملات قذائف. أسقطنا أشياء من الشباك أو البلكونة على الناس في الشارع. الجاذبية الأرضية هي صديقة القنبلة، أتذكر قراءتي مرة في دليل للجيش. القنابل إما تُحمل تحت الجناح أو توضع في مقصورة خاصة داخل الطائرة. بالنسبة لنا، كان علينا فقط أن نفرد أذرعتنا، نزيد من سرعة المواتير، وندور كمروحة هوائية ونحن نحمل جسماً في أيدينا حتى يتم التخلص من حمولتنا. أحد أصدقائي كان عنده نظارات جيش واقية، وكان يسمح لنا باستعمالها أحياناً. لقد كانت تجعل قصف الشارع تحتنا أكثر واقعية في عيوننا. صوت الطيخ _ طاخ يخرج طبيعيّاً من جنس الذكور. من النادر أن تأتي هذه الضوضاء من فتاة بالشكل الصحيح. ألقينا الحصى على العابرين تحتنا، الطوب على القطط والكلاب الضالة، مدّعين أننا نسقط قنابل أمريكية على النازيين. بعد خمسين عاماً ما زلت أذكر المتعة المحرّمة والخبث في القيام بذلك. الآن حيث تتوفّر ألعاب الفيديو يُمكن للواحد أن يتمثّل الناتو قاصفاً يوغسلافيا، الأطفال يناقشون بدراية القنابل مسترشدين بالليزر وكاميرات التليفزيون. أظن أن فكرتنا عن المعنى الحقيقي لقصف بناية كانت أكثر وضوحاً، مع ذلك لم نتوقّف. كُنّا بلا عقل مثلنا مثل جنرالات اليوم وهم يضغطون الأزرار ويتابعون شاشة الكمبيوتر منتظرين بحماس نتيجة ما قاموا به.
بدأ البريطانيون والأمريكيون قصف بلجراد يوم أحد الفصح، 16 أبريل 1944. الرواية الرسمية الصادرة عن القوات الجوية الأمريكية تتحدث عن قاذفات ثقيلة "تستهدف قصف لوفتواف في 1972 قابلت أحد الرجال الذين قصفوني في 1944. كنت قد قمت بأول رحلة لبلجراد بعد عشرين عاماً تقريباً. بمجرد عودتي إلى الولايات المتحدة، ذهبت إلى تجمّع أدبي في سان فرانسيسكو حيث قابلت بالصدفة الشاعر ريتشارد هيوجو في مطعم. تحدّثنا، سألني كيف قضيت الصيف، أخبرته أنني عدت للتو من بلجراد. قال: "آي نعم، بإمكاني أن أرى هذه المدينة جيداً" دون أن يعرف خلفيتي، انطلق يرسم على مفرش المائدة، بقطع الخبز وبقع النبيذ، موقع المبنى الرئيسي لمكتب البريد، الكباري على نهريّ الدانوب والسافا، وبعض المعالم الأخرى الهامة. دون أية فكرة عن معنى ذلك، مفترضاً طوال الوقت أنه زار مرة المدينة كسائح، سألته كم من الوقت قضى في بلجراد. أجابني: "لم أزرها أبداً، أنا فقط قصفتها عدة مرات" بذهول من المفاجأة، اندفعت قائلاً لقد كنتُ هناك وقتها وأنني أنا من كان يقوم بقصفه. أصبح منزعجاً للغاية. في الحقيقة، كان مهزوزاً بشدة. بعد أن توقف عن الاعتذار وهدأ قليلاً، سارعت أؤكد له أنني لا أحمل شيئاً ضده وسألته ما هو السبب في أنهم لم يقصفوا مقر الجُستابو ولا أي مبنى آخر حيث كان يتواجد الألمان. شرح لي هيوجو أن الغارات الجوية كانت تنطلق من إيطاليا، مستهدفة أولاً حقول النفط الرومانية، التي كانت لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للنازيين حيث كان يتم الدفاع عنها بضراوة. في كل غارة جويّة كانوا يفقدون طائرة أو اثنتين، ومع ذلك كله، في طريق عودتهم لإيطاليا، كان عليهم أن يتخلصوا من حمولاتهم فوق بلجراد. حسنٌ، كانوا في غاية الحذر. يطيرون على ارتفاع عالٍ ويلقون ما تبقى من الحمولات بأي طريقة ممكنة، في استباق ليعودوا إلى إيطاليا، حيث يقضون بقية اليوم على الشاطيء مع بعض الفتيات المحليات. أكدتُ لهيوجو أن ذلك بالضبط ما كنت سأفعله عن نفسي، لكنه استمر يطلب الغفران ويبرر موقفه. لقد كبر في منطقة قاسية في سياتل، في أسرة فقيرة من الطبقة العاملة. أمه، كانت مراهقة، وكان عليها أن تتخلّى عنه بمجرد ولادته. كنا لاعبيْن صغيريْن مرتبكيْن في أحداث أكبر من سيطرتنا. هو على الأقل اعترف بمسئوليته عما فعل، هذا ما لا نسمع به في حروب اليوم الخالية من الخطر حيث الموضة هي تحميل مسئولية الأخطاء على التكنولوجيا. هيوجو كان رجلاً يتمتع بالنزاهة، واحداً من أفضل الشعراء في جيله، و، قد يبدو هذا غريباً، لم يخطر ببالي أن ألومه على ما قام به. مع أني كنت على الأرجح سأبصق في وجه ذلك الغبي الذي قرر الموافقة على طلب تيتو بأن يضرب الحلفاء مدينة مليئة هي نفسها بالحلفاء يوم عيد الفصح. مع ذلك، اندهشتُ عندما كتب هيوجو قصيدة عما فعله وأهداها لي. كيف تكون الأمور معقدة إلى هذه الدرجة، كيف لا تكفي محاولاتنا لأن نقف في وجه الريبة غير المعلنة حيث لا شيء في جحيمها يمكن فهمه على الإطلاق.
رسالة إلى سيميك من بولدر
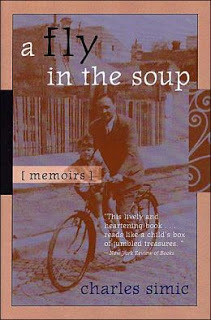
نُشرت هذه الترجمة بمجلة نزوى، سلطنة عُمان. العدد الخامس والسبعون يوليو 2013
سيكون مستحيلاً لي أن أدّعي وضعاً متميّزاً كضحية، أنا أو أي شخصٍ آخر- إذا أردتُ الصدق. خاصةً أن ما حدث لي منذ خمسين سنة
يحدث لآخرين اليوم. رواندا، البوسنة، أفغانستان، كوسوفو، والأكراد المهانون بصورة لا تنتهي- وهكذا يستمر الحال. قبل خمسين سنة
كانت الفاشية والشيوعية، الآن هناك القومية والأصولية الدينية مما يجعل الحياة لا تطاق في أماكن كثيرة. في الآونة الأخيرة، على سبيل
المثال، كنت أترجم قصائد من سراييفو لأنطولوجيا شعرية واجه محرّروها صعوبات كبيرة في العثور على الشاعرة التي كتبتها.
لقد اختفت. هي لم تكن مغمورة، كان لديها الكثير من الأصدقاء، لكن يبدو أن لا أحد يعرف ما حدث لها في فوضى الحرب. "مشردون" الوثائقية القديمة أوجيوشاً يُحارب بعضها البعض، قرى ومُدناً تتصاعد منها النيران والدخان، لا يخطر ببالك الناس المتكدسون في الأقبية.
لقد دفع السيد البريء والسيدة البريئة وأسرتاهما ثمناً باهظاً في هذا القرن لمجرد وجودهم هناك. مدانون تاريخياً _ كما كان يحب
الماركسيون أن يقولوا _ ربما انتموا إلى طبقة خاطئة، جماعة عرقية خاطئة، دين خاطىء _ إلى آخره_ هم كانوا وما زالوا تذكيراً غير
سار بكل أخطاء اليوتوبيات الفلسفية والقومية. لقد جاءوا بخِرقهم البالية ومناظرهم التعسة ويأسهم، جاؤا زرافات ووحدانا من الشرق، هاربين من الشر بدون أية فكرة عمّا ينتظرهم. لم يكن لدى أحد في أوربا ما يكفيه ليأكل، وهنا جاء اللاجئون المتضورون جوعاً، مئات الألوف منهم في قطار
ات، مخيّمات، وسجون، يغمسون خبزاً يابساً في حساء مائي، يبحثون عن قمل في رؤوس أطفالهم، ويندبون بمختلف اللغات مصيرهم المروّع.
 أسرتي، مثل أسر أخرى عديدة، تمكنت من أن ترى العالم مجاناً، والفضل يعود لحروب هتلر وسيطرة ستالين على أوربا الشرقية. نحن لم نكن متعاونين مع الألمان ولا كنا من المنتمين إلى الطبقة الأرستقراطية، كما لم نكن بأي معنى من المنفيين السياسيين. عديمو الأهمية كُنا، لم نقرر شيئا لأنفسنا. كل شيء رتبه قادة العالم في وقتها. كالكثير من النازحين لم يكن لدينا طموح يتعدى حدود مدينتنا بلجراد. كنا على ما يُرام مع ذلك. اتفاقيات عُقدت حول مجالات النفوذ، حدود أعيد ترسيمها، وما يسمى بالستار الحديديّYugoslav passport issued June 18, 1953 for Simic (top) and his brotherأتذكر الوقوف في طوابير لا نهاية لها أمام مقر البوليس في باريس من أجل استلام أو تجديد تصريح الإقامة. يبدو ذلك وكأنه كل ما كنا نقوم به عندما كنا نعيش هناك. ننتظر نهاراً كاملاً فقط لنكتشف أن القوانين قد تغيّرت منذ زيارتنا الماضية، أنهم الآن يطلبون، على سبيل المثال، شيئاً على قدر من العبث مثل وثيقة زواج والديّ أمي أو شهادة تخرّجها من المدرسة، هذا على الرغم من أنها في طريقها للحصول على شهادة فرنسية لأنها أنهت دراستها العليا في باريس. وبينما كنا نقف هناك نتأمل في استحالة ما يطلبونه منا، كنا نستمع إلى شخص أمام الشباك المجاور يحاول أن يقول في فرنسية ضعيفة كيف احترق بيتهم، كيف غادروا مهرولين بحقيبة واحدة صغيرة، وهلم جرا، إلى أن يهز الضابط كتفيه ويشرع في إعلامهم أنه إذا لم تُقدّم الوثائق فوراً فسيتم إلغاء تصريح الإقامة.
أسرتي، مثل أسر أخرى عديدة، تمكنت من أن ترى العالم مجاناً، والفضل يعود لحروب هتلر وسيطرة ستالين على أوربا الشرقية. نحن لم نكن متعاونين مع الألمان ولا كنا من المنتمين إلى الطبقة الأرستقراطية، كما لم نكن بأي معنى من المنفيين السياسيين. عديمو الأهمية كُنا، لم نقرر شيئا لأنفسنا. كل شيء رتبه قادة العالم في وقتها. كالكثير من النازحين لم يكن لدينا طموح يتعدى حدود مدينتنا بلجراد. كنا على ما يُرام مع ذلك. اتفاقيات عُقدت حول مجالات النفوذ، حدود أعيد ترسيمها، وما يسمى بالستار الحديديّYugoslav passport issued June 18, 1953 for Simic (top) and his brotherأتذكر الوقوف في طوابير لا نهاية لها أمام مقر البوليس في باريس من أجل استلام أو تجديد تصريح الإقامة. يبدو ذلك وكأنه كل ما كنا نقوم به عندما كنا نعيش هناك. ننتظر نهاراً كاملاً فقط لنكتشف أن القوانين قد تغيّرت منذ زيارتنا الماضية، أنهم الآن يطلبون، على سبيل المثال، شيئاً على قدر من العبث مثل وثيقة زواج والديّ أمي أو شهادة تخرّجها من المدرسة، هذا على الرغم من أنها في طريقها للحصول على شهادة فرنسية لأنها أنهت دراستها العليا في باريس. وبينما كنا نقف هناك نتأمل في استحالة ما يطلبونه منا، كنا نستمع إلى شخص أمام الشباك المجاور يحاول أن يقول في فرنسية ضعيفة كيف احترق بيتهم، كيف غادروا مهرولين بحقيبة واحدة صغيرة، وهلم جرا، إلى أن يهز الضابط كتفيه ويشرع في إعلامهم أنه إذا لم تُقدّم الوثائق فوراً فسيتم إلغاء تصريح الإقامة. هكذا، ما الذي كنا نفعله؟ حسنٌ، عندما يكون الجو لطيفاً كنا نذهب لنجلس على مقعد شارع نشاهد الباريسيين المحظوظين وهم يتنزهون، يحملون البقالة، يدفعون عربات أطفالهم، يُمشّون كلابهم، وحتى يُصفّرون. في بعض الأحيان يقف أمامنا اثنان ليتعانقا، بينما نحن نلعن الفرنسيين وحظنا التعس. في النهاية نُجرجر أقدامنا بتثاقل إلى غرفتنا الصغيرة بالفندق ونكتب رسائل للأهل. بالطبع، لا يصل البريد بسرعة. كُنا نُجَن كل يوم ولمدة أسابيع في انتظار البوسطجي الذي لم يكن يتحمّل رؤيتنا لأننا كنّا نضايقه، مع ذلك، وبشكل ما، كانت الوثائق تصل، بفضل قريب ما من بعيد. ولا بد من ترجمتها بعد ذلك على يد مترجم مُعتمد، يكون عادة غير قادر على التفرقة بين رأس وذيل طيّات الورقة ذات الخمسين عاماً من مدرسة في مقاطعة في البلقان أو من دفتر تسجيل كنيسة. في كل الأحوال، كنا نعود إلى الطابور الطويل فقط لنكتشف أن هذه الوثائق لم تعد مهمة، ولكن شيئاً آخر أصبح مطلوباً. في كل مكتب لجوازات سفر، في كل قسم بوليس، في كل قنصلية، يوجد مكتب وخلفه موظف حذر سيء المزاج يشتبه في أننا ندعي غير حقيقتنا. لا أحد يحب اللاجئين. الوضع المبهم لأن تُسمّى "مُشرّداً" جعل الأمر أكثر سوءاً. المسئولون الذين يقابلوننا لا يعرفون من أين أتينا ولماذا، ولكن هذا لم يمنعهم من إصدار حكمهم علينا. قد يجلب لك قدراً من التعاطف أن تكون مطروداً بسبب النازية، أما أن تُغادر بلدك بسبب الشيوعية فهذا ما يصعب قبوله. إذا كان المسئولون يساريين، فسيقولون لنا بفظاظة أننا تُعساء ناكرون للجميل، أننا تركنا خلفنا أكثر المجتمعات تقدماً وعدالة على وجه الأرض. الآخرون حسبونا مجرد رعاع بشهادات مزيفة وماضٍ مشبوه. حتى الدُمى المبتسمة خلف فتارين المحلات في شارع فيكتور هيجو الأنيق عاملتنا وكأننا هناك لنسرق شيئاً. في الحقيقة كان الأمر بسيطاً للغاية: إما أننا كنا سنحصل على موطيء قدم هنا أو في مكان آخر، أو سنعود إلى مخيم للاجئين، أو، الأسوأ، إلى "التجسيد الكامل لشوق الانسان العميق للعدالة والسعادة" كما اعتاد العالم الشيوعي أن يوصف في بعض الجهات. الهجرة، المنفى، أن تكون بلا جذور وأن تصبح منبوذاً، ربما يكون ذلك أكثر الطرق المبتكرة لاقناع الفرد بالطبيعة الاعتباطيّة لوجوده أو وجودها. لسنا في حاجة إلى طبيب نفسيّ أو مُرشد روحيّ طالما أن كل من نقابلهم يسألوننا من أنتم بمجرد أن نفتح أفواهنا ويسمعون اللكنة . الحقيقة هي أننا لم يكن عندنا أجوبة واضحة. بعد ترجرجنا في القطارات المخيفة وفوق الشاحنات والسفن التجارية المهلهلة، أصبحنا لغزاً حتى لأنفسنا. في البداية، كان ذلك صعباً علينا ولكن بمرور الوقت بدأنا نتعوّد. بدأنا نتذوق هذا الوضع ونستمتع به. أن تكون لا أحد بدا لي شخصياً أكثر إثارة من أن تكون شخصاً ما. الشوارع كانت مليئة بأولئك الأشخاص المهمين وهم يصنعون أجواء الثقة حولهم. نصف الوقت كنت أحسدهم، نصف الوقت كنت أنظر إليهم في شفقة. لقد كنت أعرف شيئاً لم يعرفوه، شيئاً من الصعب معرفته إذا لم يركلك التاريخ بقوة في مؤخرتك: كيف يبدو الأفراد غير ضروريين وعديمي الأهمية ضمن أي صورة كبيرة! كيف أن هؤلاء القُساة لا يفهمون احتمال أن يكون ذلك هو مصيرهم أيضاً.
2- عندي صورة لوالدي وهو يلبس بدلة سوداء و يحمل خنزيراً صغيراً تحت إبطه. إنه في مركز الصورة وبجانبه امرأتان جميلتان في فساتين سهرة قصيرة وضحكة جميلة في عيونهما السواداء. هو أيضاً يضحك. فم الخنزير مفتوح ولكن لا يبدو أنه يضحك. إنه حفل رأس السنة. السنة هي 1928 ويبدو أنهم في أحد الملاهى الليليّة. عند منتصف الليل أُطفئت الأنوار وتم الإفراج عن الخنزير. أثناء الهرج والمرج قبض والدي على الخنزير المتألم. أصبح ملكه. بعد تشجيع الناس، أخذ حبلاً من النادل وربط الخنزير برجل الطاولة. زار والدي والمرأتان عدداً من الأماكن الأخرى في تلك الليلة. وذهب معهم الخنزير وهو مربوط بالحبل. لقد أجبروه على شرب الشمبانيا معهم وعلى لبس قبعة الحفلات. بعد سنوات عديدة سيسميه والدي "الخنزير المسكين". عند الفجر كان والدي وحده مع الخنزير يشربان في بار متواضع بالقرب من محطة السكة الحديد. في الطاولة بجانبهما كان هناك كاهن سكران يكلّل عروسين. رفع الشوكة والسكين في وضع صليب ليبارك الزوجيْن. بعد ذلك أهداهما والدي الخنزير كهدية لزواجهما. الخنزير المسكين. لكن هذه ليست نهاية القصة. ففي 1948، عندما كان والدي في طريقه إلى أمريكا ونحن نتضور جوعاً في بلجراد، اعتدنا أن نقايض ممتلكاتنا بالطعام. بإمكانك أن تحصل على دجاجة مقابل حذاء رجالي بحال جيد. الساعات والفضيات ومزهريّات الكريستال وأطباق الصيني الفخمة تم مقايضتها بلحم ودهن الخنزير والسجق وأشياء من هذا القبيل. في إحدى المرّات، طلب غجريٌّ قبعة والدي الرسمية. لم تكن على مقاسه. مقابل هذه القبعة التي غطت عينيه عندما جرّبها، ناولنا بطة حية. بعد ذلك بأسابيع جاء أخوه ليرانا. بدا ثريّاً. سنّة أمامية من الذهب، ساعتان، واحدة في كل يد. الآخر، كما يبدو، كان قد انتبه لبذلة سهرة سوداء عندنا. في الواقع كنا نترك هؤلاء الناس يتجولون بين الغرف يقيّمون البضائع. يتصرفون كأنه بيتهم، يفتحون الأدراج، ينظرون في الخزانات. يعرفون أننا لن نعترض. كنّا جوعى. على أي حال، أحضرت أمي بذلة سهرة 1926. كان باستطاعتنا أن نرى فوراً كيف وقع الرجل في غرامها. عرض علينا في مقابلها أولاً دجاجة ثم دجاجتيْن. لسبب ما أصبحت أمي عنيدة. الأعياد على الأبواب. لقد أرادت خنزيراً رضيعاً. الغجريّ أصبح غاضباً، أو مثّل أنه غاضب. الخنزير أكثر مما ينبغي. لكن أمي لم تستسلم. عندما تركب رأسها فهي تساوم بضراوة. بعد ذلك بسنوات في دوفر نيوهامشر، راقبتها وهي توصل بائع أثاث إلى شفا الجنون. عرض عليها أن تأخذ الكنبة مجاناً فقط ليتخلّص منها. الغجريّ كان أكثر تشدّداً. غادرنا. بعدها بأيام عاد ليُلقي نظرةً أخرى. وقف يحدّق في البذلة عند أمي كأنه يريد أن يتخلّص منّا في نفس الوقت. نظر ونظرنا. في النهاية، تنفّس الصعداء كرجلٍ يتخذ قراراً صعباً ولا رجعة فيه. حصلنا على الخنزير في اليوم التالي. كان حيّاً ويشبه إلى حد كبير الخنزير في الصورة.
3- في البدء ... الراديو. كان على طاولة بجانب سريري. كان له زر تحكّم يُضيء، ثم تظهر أسماء المحطات. ولم يكن باستطاعتي القراءة بعد فكنتُ أسأل الآخرين أن يقرأوها لي. هناك أوسلو، لشبونة، موسكو، برلين، بودابست، مونت كارلو، وغيرها الكثير. تضع السهم الأحمر موازياً للاسم، فتنبثق لغة غريبة وموسيقى غير مألوفة. في العاشرة، تتوقف المحطات عن البث. الحرب مستمرة. هذا العام هو 1943. لقد أمضيت ليالي طفولتي مع هذا الراديو، إنني أُرجع الأرق الذي صاحبني طوال حياتي لسِحره. لم يكن ممكناً أن أبعد يديّ عنه. حتى بعد أن تتوقف المحطات عن البث. استمرُّ في تحريك زرّ التحكّم وأدرس الضوضاء المختلفة. مرة سمعت صفارات شفرة مورس. فكرت أن هناك جواسيس. أحياناً كنت ألتقط محطة بعيدة خافتة ويكون عليّ أن أضع أذني على خشونة الغطاء التي تغطي مركز الصوت. أحياناً كانت تندلع موسيقى رقص أو تكون اللغة جذابة جداً فأستمع إليها مدة طويلة، وأشعر أنني على وشك أن أفهمها. كل ذلك كان ممنوعاً منعاً باتاً. كان من المفروض أن أكون نائماً. أفكر في ذلك الآن، ربما كنت خائفاً من الوحدة في تلك الغرفة الكبيرة. الحرب مستمرة. البلاد محتلة. أشياء فظيعة حدثت في الليل. كان هناك حظر تجول. أحدهم كان متأخراً. شخصٌ آخر في الغرفة المجاورة يمشي جيئة وذهاباً. ستائر من الورق الأسود معلقة على الشبابيك. كان شيئاً مرعباً أن تنظر من خلالها إلى الشارع _ الشارع الخالي المظلم. أتخيل نفسي وأنا أمشي على أطراف أصابعي ويدٌ على الستارة، أريد أن أنظر ولكني خائف من انعكاس الضوء الخافت للراديو على جدار غرفة النوم. والدي متأخر والثلج يغطي السطوح في الخارج. في 6 إبريل 1941، كان عمري ثلاث سنوات، ضربت قنبلة في الخامسة صباحاً المبنى المقابل من الشارع مما أدى إلى اشتعال النار فيه. بلجراد التي وُلدتُ فيها، لديها فرادة غير مؤكّدة فقد قصفها النازيون في عام 1941، والحلفاء في عام 1944، والناتو في عام 1999. عدد القتلي في ذلك اليوم من أبريل _ والذي أطلق عليه الألمان "عملية عقابية" _ يتراوح بين خمسة وسبعة عشر ألفاً، وهو أكبر عدد من القتلى المدنيين في يوم واحد خلال العشرين شهر الأولى من الحرب. كانت المدينة قد تعرضت لأربع مئة قاذفة وأكثر من مئتيّ طائرة مقاتلة في يوم أحد الشعانين هل كان العالم حقاً رماديّاً وقتها؟ في ذكرياتي المبكرة كان العالم دائماً في أواخر الخريف. الجنود رماديون، وهكذا كان الناس. الألمان يقفون في الزاوية. نحن نمرّ بجانبهم. "لا تنظر إليهم"، تهمس أمي. نظرت إليهم على أي حال، وواحد منهم ابتسم. لسبب ما أخافني ذلك. في ليلة جاء الجستابو لاعتقال والدي. كانوا يفتشون في كل مكان محدثين ضجة كبيرة. كان والدي قد ارتدى ملابسه بالفعل. كان يقول شيئاً، ربما كان ينكّت. تلك كانت طريقته. مهما كان الوضع قاتماً، كان يجد شيئاً مضحكاً ليقوله. بعد سنوات عديدة، محاطاً بالأطباء والممرضات بعد تعرضه لأزمة قلبية خطيرة، أجاب على سؤالهم "كيف تشعر الآن يا سيدي؟" بـ "أن طلب بيتزا وبيرة". ظن الأطباء أنه تعرض لتلف في المخ. كان عليّ أن أشرح لهم أن هذا سلوك طبيعي بالنسبة له. على الأرجح أنني عدت للنوم بعد أن أخذوا والدي. على كل حال لم يحدث شيءٌ في تلك المرة. أفرجوا عنه. لم يكن ذنبه أن أخاه الأصغر سرق شاحنة من الجيش الألماني ليأخذ صديقته في نزهة. الألمان كانوا مندهشين، تقريباً مذهولين من الجرأة. أرسلوه للعمل في ألمانيا. لقد قاموا بالمحاولة، ولكنه تسلّل من بين أصابعهم. وفّر لنا زمن الحرب ملاهي للرياضة وزحاليق وبيوتاً خشبية وحصوناً ومتاهات يمكن العثور عليها في ذلك الخراب عبر الشارع. كان هناك جزء قد تبقى من الدرج، كنا نصعد بين الحطام وفجأة تظهر السماء! ولد صغير سقط على رأسه ولم يعُد أبداً لما كان عليه. أمهاتنا حرّمن علينا الاقتراب من الدمار، هدّدننا، حاولن أن يشرحن المخاطر الكثيرة التي تنتظرنا، مع ذلك كنا نذهب. جالسون بسعادة بين أطلال غرفة طعام شخصٍ ما بالدور الثالث، يأتينا من الشارع تحتنا صياح واحدة من أمهاتنا وهي تشير إلينا بينما ابنها يهرول إلى أسفل مجاهداً في تذكر أين كان يضع قدميه أثناء الصعود. كنا نلعب جنوداً، استمرت الحرب. نزلت القنابل. ولعبنا جنوداً. أطلقنا النار على بعضنا البعض طوال النهار. طاخ طخ _ طيخ. سقطنا قتلى على الرصيف. ركضنا بين الزحام مقلدين صوت الطائرات المقاتلة وهي تغطس وتقب. ثم أصبحنا حاملات قذائف. أسقطنا أشياء من الشباك أو البلكونة على الناس في الشارع. الجاذبية الأرضية هي صديقة القنبلة، أتذكر قراءتي مرة في دليل للجيش. القنابل إما تُحمل تحت الجناح أو توضع في مقصورة خاصة داخل الطائرة. بالنسبة لنا، كان علينا فقط أن نفرد أذرعتنا، نزيد من سرعة المواتير، وندور كمروحة هوائية ونحن نحمل جسماً في أيدينا حتى يتم التخلص من حمولتنا. أحد أصدقائي كان عنده نظارات جيش واقية، وكان يسمح لنا باستعمالها أحياناً. لقد كانت تجعل قصف الشارع تحتنا أكثر واقعية في عيوننا. صوت الطيخ _ طاخ يخرج طبيعيّاً من جنس الذكور. من النادر أن تأتي هذه الضوضاء من فتاة بالشكل الصحيح. ألقينا الحصى على العابرين تحتنا، الطوب على القطط والكلاب الضالة، مدّعين أننا نسقط قنابل أمريكية على النازيين. بعد خمسين عاماً ما زلت أذكر المتعة المحرّمة والخبث في القيام بذلك. الآن حيث تتوفّر ألعاب الفيديو يُمكن للواحد أن يتمثّل الناتو قاصفاً يوغسلافيا، الأطفال يناقشون بدراية القنابل مسترشدين بالليزر وكاميرات التليفزيون. أظن أن فكرتنا عن المعنى الحقيقي لقصف بناية كانت أكثر وضوحاً، مع ذلك لم نتوقّف. كُنّا بلا عقل مثلنا مثل جنرالات اليوم وهم يضغطون الأزرار ويتابعون شاشة الكمبيوتر منتظرين بحماس نتيجة ما قاموا به.
بدأ البريطانيون والأمريكيون قصف بلجراد يوم أحد الفصح، 16 أبريل 1944. الرواية الرسمية الصادرة عن القوات الجوية الأمريكية تتحدث عن قاذفات ثقيلة "تستهدف قصف لوفتواف في 1972 قابلت أحد الرجال الذين قصفوني في 1944. كنت قد قمت بأول رحلة لبلجراد بعد عشرين عاماً تقريباً. بمجرد عودتي إلى الولايات المتحدة، ذهبت إلى تجمّع أدبي في سان فرانسيسكو حيث قابلت بالصدفة الشاعر ريتشارد هيوجو في مطعم. تحدّثنا، سألني كيف قضيت الصيف، أخبرته أنني عدت للتو من بلجراد. قال: "آي نعم، بإمكاني أن أرى هذه المدينة جيداً" دون أن يعرف خلفيتي، انطلق يرسم على مفرش المائدة، بقطع الخبز وبقع النبيذ، موقع المبنى الرئيسي لمكتب البريد، الكباري على نهريّ الدانوب والسافا، وبعض المعالم الأخرى الهامة. دون أية فكرة عن معنى ذلك، مفترضاً طوال الوقت أنه زار مرة المدينة كسائح، سألته كم من الوقت قضى في بلجراد. أجابني: "لم أزرها أبداً، أنا فقط قصفتها عدة مرات" بذهول من المفاجأة، اندفعت قائلاً لقد كنتُ هناك وقتها وأنني أنا من كان يقوم بقصفه. أصبح منزعجاً للغاية. في الحقيقة، كان مهزوزاً بشدة. بعد أن توقف عن الاعتذار وهدأ قليلاً، سارعت أؤكد له أنني لا أحمل شيئاً ضده وسألته ما هو السبب في أنهم لم يقصفوا مقر الجُستابو ولا أي مبنى آخر حيث كان يتواجد الألمان. شرح لي هيوجو أن الغارات الجوية كانت تنطلق من إيطاليا، مستهدفة أولاً حقول النفط الرومانية، التي كانت لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة للنازيين حيث كان يتم الدفاع عنها بضراوة. في كل غارة جويّة كانوا يفقدون طائرة أو اثنتين، ومع ذلك كله، في طريق عودتهم لإيطاليا، كان عليهم أن يتخلصوا من حمولاتهم فوق بلجراد. حسنٌ، كانوا في غاية الحذر. يطيرون على ارتفاع عالٍ ويلقون ما تبقى من الحمولات بأي طريقة ممكنة، في استباق ليعودوا إلى إيطاليا، حيث يقضون بقية اليوم على الشاطيء مع بعض الفتيات المحليات. أكدتُ لهيوجو أن ذلك بالضبط ما كنت سأفعله عن نفسي، لكنه استمر يطلب الغفران ويبرر موقفه. لقد كبر في منطقة قاسية في سياتل، في أسرة فقيرة من الطبقة العاملة. أمه، كانت مراهقة، وكان عليها أن تتخلّى عنه بمجرد ولادته. كنا لاعبيْن صغيريْن مرتبكيْن في أحداث أكبر من سيطرتنا. هو على الأقل اعترف بمسئوليته عما فعل، هذا ما لا نسمع به في حروب اليوم الخالية من الخطر حيث الموضة هي تحميل مسئولية الأخطاء على التكنولوجيا. هيوجو كان رجلاً يتمتع بالنزاهة، واحداً من أفضل الشعراء في جيله، و، قد يبدو هذا غريباً، لم يخطر ببالي أن ألومه على ما قام به. مع أني كنت على الأرجح سأبصق في وجه ذلك الغبي الذي قرر الموافقة على طلب تيتو بأن يضرب الحلفاء مدينة مليئة هي نفسها بالحلفاء يوم عيد الفصح. مع ذلك، اندهشتُ عندما كتب هيوجو قصيدة عما فعله وأهداها لي. كيف تكون الأمور معقدة إلى هذه الدرجة، كيف لا تكفي محاولاتنا لأن نقف في وجه الريبة غير المعلنة حيث لا شيء في جحيمها يمكن فهمه على الإطلاق.
رسالة إلى سيميك من بولدر
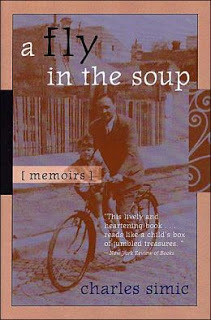
نُشرت هذه الترجمة بمجلة نزوى، سلطنة عُمان. العدد الخامس والسبعون يوليو 2013
Published on August 18, 2013 09:48
June 11, 2013
كلام قديم عن تفكيك وزارة الثقافة المصرية
كلام قديم عن تفكيك وزارة الثقافة المصرية
نُشر هذا المقال على الفيسبوك في 16 فبراير 2011..لم يعد يعنيني ما فيه من أفكار، بل وأشعر بالخجل من التفاؤل الذي به.. لكن لم أكن أتصور أن المثقفين سيعتصمون بعد ذلك بأكثر من عامين من أجل إقالة وزير الثقافة أو ضد أخونة الدولة .. بدون أي تصور لما يريدون عمله بهذه الوزارة بعد ذلك الوزير أو ذاك February 16, 2011 at 7:35 pm
مقدمة لابد منها
أعزائي، سألني الصديق محمد فرج عن الاشتراك في تحقيق لجريدة الأخبار المصرية عن ضرورة وجود وزارة ثقافة من عدمه وعن مهامها إن وجدت في المرحلة القادمة، وقد طال رأيي لدرجة أنه لم يعد يصلح لهذا التحقيق وأصبح هذه الورقة أو المسودة التي أتمنى أن تقرأوها وتنتقدوا بنودها وتضيفوا ما ترونه هاماً، فهي ليست مقالة بل رغبة في فتح حوار جماعي يناقش مؤسسة محددة تعرفون جميعاً مدى فسادها وتعرفون أيضاً أن تغيير وزيرها أو بعض رموزها لن يفكك هذا الفساد
بعد أيام من تنحي مبارك توجد مؤشرات كثيرة أن نظامه لم ولن ينتهي في 18 يوماً. أعتقد أن هناك أسئلة كثيرة عندنا جميعاً عن أهمية وكيفية تفكيك هذا النظام من أجل خلق نظام ديمقراطي حقيقي وعادل، قادر على حماية نفسه من الفساد، يحترم المواطنة وحرية التعبير ويعطي للجميع الحق في الانتماء والتفكير والتغيير. لن أعيد المطالب التي اتفقت عليها معظم القوى الوطنية هنا، ولن أناقش المخاوف الحقيقية من التلاعب بها. أعتقد أن فتح حوار حول تفكيك إحدى مؤسسات نظام مبارك وهي "وزارة الثقافة" هو من الضرورات. وهذا يعني أنني شخصياً أشجع وأفهم ضرورة المظاهرات الفئوية والعمالية من ناحية، ودور الأفراد والجماعات فى فتح حوار فيما بينهم حول قوانين وتركيب وسياسة ورموز الحقول والمؤسسات التي يعملون أو يهتمون بها، حتى لا تصبح هذه الثورة مجرد انتفاضة تحصل على بعض المكاسب والترضيات بالتخلص من عدة رموز مع بقاء مؤسسات الفساد كما هي
من أجل حوار جماعي حول تفكيك وزارة الثقافة كثيراً ما تمنيت ألا تكون هناك وزارة ثقافة، ولكن ربما كان هذا الرأي العاطفي مجرد غضب ورفض لسياسة وزارات الثقافة في مصر. الآن، وأنت تشعر أن مساهمتك في مناقشة موضوع كهذا ربما يكون لها قيمة وهذا أحد انجازات ثورة 25 يناير بالتأكيد، أظن أن وجود مؤسسات تخدم الثقافة ضرورة في بلد كبلدنا، لأسباب كثيرة منها الفقر، ومستوى التعليم، وحتمية مشاركة مؤسسات الدولة في حماية أماكن التراث الروحي والمتاحف والمكتبات العامة من ناحية، وأهمية اشتراكها مع المؤسسات الأهلية التي ازدهرت في العشر سنوات الأخيرة في توفير مصادر المعرفة كحق لكل فرد من ناحية أخرى. سأطرح فقط بعض النقاط كبداية للنقاش: 1- واحدأول قانون يجب مناقشته والضغط لتغييره من أجل تشجيع الجمعيات الثقافية المستقلة التي هي أكثر الضمانات أهمية في مواجهة / ومع مؤسسات الدولة الثقافية هو قانون 84 لسنة 2002 والذي لم يكن إلا تعديلاً شكلياً لقانونيّ 32 لسنة 1964 و53 لسنة 1999المقيدان لحرية تشكيل جمعيات أهلية وبالذات ثقافية. هذه القوانين تقصر مفهوم مؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن نشجعها ونحميها على المؤسسات الخيرية وتفرض رقابتها القاتلة لوأد أي مشروع جماعي ثقافي
اثنين - 2 تفكيك الجسم الضخم الذي يسمى "وزارة الثقافة" والتركيز على مؤسسات ثقافية منوط بها خطط خدمية ثقافية محددة هو سعي للتحرر من تراث الدولة الشمولية الذي بدأ تأسيسه في الخمسينيات وظل فاعلاً حتى الآن، وزارة الثقافة في مصر اشتغلت دائماً على أنها وزارة إرشاد قومي تسيد خطاباً ما، أو تبعية ما، أو ذوق أدبي ما، وكان أول أولوياتها تجميع المثقفين في حظيرة وتوزيع الفتات عليهم طبقاً لقربهم أو بعدهم من سياسة الدولة. ما يمكن مناقشته الآن هو مجموعة من المؤسسات التي تتبنى خططا مدروسة لتوفير أماكن (مكتبات، دور سينما، مسارح، قاعات عرض) ومصادر المعرفة المتعددة لكل مراكز مصر وأطرافها
3- ثلاثةإنها مؤسسات خدمية مجالها الثقافة وليست مؤسسات ثقافية مهمتها تمرير ونشر خطاب السلطة السياسة أياً كانت حتى لو كانت هذه السلطة مختارة وديمقراطية. كما نعرف جميعاً لا يوجد حل سحري لإبطال أجهزة الدولة الأيديولوجية من تمرير خطاب سلطة ما إلى كل مكان ولكن هناك طرق لتحجيم هذا التمرير على الأقل
4- أربعةليس نشر الكتب عبر الهيئة العامة للكتاب والمركز القومي للترجمة وهيئة قصور الثقافة وغيرها فقط بل توزيع هذه الكتب مجاناً على مكتبات الجامعات وقصور الثقافة بل والمكتبات الأهلية. وجود مخازن تتعرض فيها الكتب المكدسة للمياة وللفئران هو عبث لا يمكن تصوره إلا في أفلام الرعب. دعم دور النشر المستقلة والصغيرة بشراء مطبوعاتها وتوزيعها على المكتبات العامة وإجراء اتفاقيات يتم عبرها بيع هذه الكتب لمكتبات في العالم العربي وخارجه هو جزء من الخدمة الثقافية التي يجب أن تقوم بها مؤسسات الدولة
5- خمسة
مصادر المعرفة ليست كتباً فقط، بل أفلام، ووسائل اتصال تكنولوجية توفر المعلومات والبحث في الجامعات والمدارس والمراكز الثقافية. فهناك مدن وقرى كبيرة بلا مكتبة عامة واحدة، وهناك مكتبات فيها كتب فقط ولا يتوفر بها خرائط وأفلام ودورات تدريبية للرسم والكتابة والتطريزوالفيديو آرت وغيره وهذا نزوع لحصر مفهوم المعرفة في القراءة. مؤسسات خدمة الثقافة يجب أن توفر مواقع على الانترنت يمكن البحث فيها عن كل ما يخص نشاطاتها
6- ستةوزارة الثقافة كما عهدناها كانت معزولة ومتعالية على الوزارات الأخرى؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر ما كان يقوم به المجلس الأعلى للثقافة من مؤتمرات أكاديمية كان يمكن أن تقوم الجامعات بما هو أفضل منه من حيث التعدد والاتصال والمشاركة إذا توفر لها نفس المال بالإضافة إلى إلغاء كل القوانين المقيدة للبحث والتجمع ولحرية أعضاء هيئات التدريس. ما يجب التفكير فيه هو وسائل غير محدودة لربط مؤسسات خدمة الثقافة مع كافة المؤسسات الأخرى وسأضرب أمثلة قد تبدو بسيطة: مساهمة مثقفين ومتخصصين في إقامة دورات تدريبية دورية بالاشتراك مع وزارة التعليم للمدرسين والعاملين بالمكتبات المدرسية والحكومية. إخراج المؤتمرات الثقافية من مبنى الأوبرا إلى الجامعات والساحات العامة لأن الكتاب المدعويين والموسيقيين والأفلام يدفع تكلفتها كل المصريين ويجب أن تكون خدمة ثقافية لهم جميعاً. الاشتراك مع وزارة الصحة والإعلام في تعميم ونشر معلومات عن تحديد النسل وسرطان الثدي وخطر التلوث وحلوى الأطفال الملونة وغيره. أتحدث هنا عن مشاركة وتخطيط يوفر المعلومات ولا يهين ذكاء الناس وقدراتهم على التفكير ببرامج توعية أحادية ومتخلفة تذكروا برامج التوعية عن مرض البلهارسيا كمثال يجب التوقف عن انتاجه
7- سبعةأي دور ممكن لمؤسسات خدمة الثقافة بالدولة لا يمكن أن يكون بمحاربة الجمعيات الأهلية المستقلة يعزلها أو باستقطابهاعلى طريقة فاروق حسني، بل بالحفاظ على استقلاليتها مع الاستعانة بها في إيصال نشاطاتها لأكبر قدر ممكن من الأفراد. عندي مثال؛ جمعية مثل المورد الثقافي، لماذا لا يتم دعوة نشاطاتها في مراكز شتى. فورد فاونديشن التي حافظت على بقاء بعض الفرق الموسيقية مثل الطنبورة لماذا لا يتم التنسيق معها بدلاً من الاكتفاء بتجريم أي مؤسسة أجنبية وكأن الثقافة الوطنية النقية والعذراء مهددة ومستهدفة من كل غريب!!.
8- ثمانيةإقامة مهرجانات تحت عناوين مختلفة يتم فيها دعوة نفس الصحفيين والمتنفذين الثقافيين في بلادهم، وإقامة لجان ميتة للشعر والرواية والمسرح يقوم فيها بعض المصلحين من الداخل والانتهازيين بتسييد ذوقهم الأدبي ومصالحهم الضيقة من نقود مقابل الاجتماعات وسفريات وجوائز كان من مظاهر الفساد الذي تحكم في وزارة الثقافة لسنوات. لن أضرب أمثلة لأن الجميع يعرفها، ولكني أقول إن ذلك لن يتغير إلا بعمل قوانين صارمة تجعل أعضاء هذه اللجان – التي أتمنى ألا يكون لها وجود أصلاً- بالانتخاب، وتحرم عليهم السفريات والجوائز والمنح التي يتم تقريرها باللجان التي هم أعضاء فيها طوال فترة عضويتهم
9- تسعةالعالم الذي نعيش فيه ليس هو العالم العربي وأوربا فقط، افريقيا وإيران وآسيا وأمريكا اللاتينية هم جزء منه!! أن يحرم المصريين من مشاهدة الأفلام الإيرانية سنوات ما بعد ثورتهم الاسلامية أو يتم الحجر على فرق عرب اسرائيل المسرحية من المشاركة هو اعتداء على حرية المعرفة واستمرار لتحكم السياسي (السلطوي) في الثقافي (المتعدد) ويجب مراجعة مثل هذه القرارات من المثقفين أنفسهم
10- عشرةالمراكز الثقافية المصرية في الخارج هي مزج عادل بين خطاب الدولة الشمولية الستينية التي تسعى لتحسين صورتها من ناحية وفساد حكومة مبارك السابقة عبر تعيين الجهلاء وأصحاب الوسائط من ناحية أخرى. مهمة هذه المراكز الأولى يجب أن تكون تقديم خدمة ثقافية للمغتربين وللمهتمين بالآداب والفنون. يجب أن تقوم باقتراح ومد المكتبات والمؤسسات الثقافية في أماكن وجودها بقوائم للكتب ودور النشر الصغيرة وغيرها. يجب أن تقوم بتقديم منح واستضافة كتاب شباب ومعارض وفرق من داخل مصر ليجربوا لشهر أو أكثر الحياة في مكان آخر
وأخيراً ليست هذه المساهمة إلا لفتح حوار وأنا متأكدة أن هناك أفكار أكثر أهمية ستأتي ممن يعرفون أكثر مني تكوين ما نريد تفكيكه وهو وزارة الثقافة. الثورة المصرية لم تكن من أجل دولة ديمقراطية ومدنية فقط، بل من أجل أن يعود كل الذين اكتشفوا أن هناك أمل ليمارسوا انتمائهم عبر وجودهم في صفوف معارضة حقيقية في المستقبل
نُشر هذا المقال على الفيسبوك في 16 فبراير 2011..لم يعد يعنيني ما فيه من أفكار، بل وأشعر بالخجل من التفاؤل الذي به.. لكن لم أكن أتصور أن المثقفين سيعتصمون بعد ذلك بأكثر من عامين من أجل إقالة وزير الثقافة أو ضد أخونة الدولة .. بدون أي تصور لما يريدون عمله بهذه الوزارة بعد ذلك الوزير أو ذاك February 16, 2011 at 7:35 pm
مقدمة لابد منها
أعزائي، سألني الصديق محمد فرج عن الاشتراك في تحقيق لجريدة الأخبار المصرية عن ضرورة وجود وزارة ثقافة من عدمه وعن مهامها إن وجدت في المرحلة القادمة، وقد طال رأيي لدرجة أنه لم يعد يصلح لهذا التحقيق وأصبح هذه الورقة أو المسودة التي أتمنى أن تقرأوها وتنتقدوا بنودها وتضيفوا ما ترونه هاماً، فهي ليست مقالة بل رغبة في فتح حوار جماعي يناقش مؤسسة محددة تعرفون جميعاً مدى فسادها وتعرفون أيضاً أن تغيير وزيرها أو بعض رموزها لن يفكك هذا الفساد
بعد أيام من تنحي مبارك توجد مؤشرات كثيرة أن نظامه لم ولن ينتهي في 18 يوماً. أعتقد أن هناك أسئلة كثيرة عندنا جميعاً عن أهمية وكيفية تفكيك هذا النظام من أجل خلق نظام ديمقراطي حقيقي وعادل، قادر على حماية نفسه من الفساد، يحترم المواطنة وحرية التعبير ويعطي للجميع الحق في الانتماء والتفكير والتغيير. لن أعيد المطالب التي اتفقت عليها معظم القوى الوطنية هنا، ولن أناقش المخاوف الحقيقية من التلاعب بها. أعتقد أن فتح حوار حول تفكيك إحدى مؤسسات نظام مبارك وهي "وزارة الثقافة" هو من الضرورات. وهذا يعني أنني شخصياً أشجع وأفهم ضرورة المظاهرات الفئوية والعمالية من ناحية، ودور الأفراد والجماعات فى فتح حوار فيما بينهم حول قوانين وتركيب وسياسة ورموز الحقول والمؤسسات التي يعملون أو يهتمون بها، حتى لا تصبح هذه الثورة مجرد انتفاضة تحصل على بعض المكاسب والترضيات بالتخلص من عدة رموز مع بقاء مؤسسات الفساد كما هي
من أجل حوار جماعي حول تفكيك وزارة الثقافة كثيراً ما تمنيت ألا تكون هناك وزارة ثقافة، ولكن ربما كان هذا الرأي العاطفي مجرد غضب ورفض لسياسة وزارات الثقافة في مصر. الآن، وأنت تشعر أن مساهمتك في مناقشة موضوع كهذا ربما يكون لها قيمة وهذا أحد انجازات ثورة 25 يناير بالتأكيد، أظن أن وجود مؤسسات تخدم الثقافة ضرورة في بلد كبلدنا، لأسباب كثيرة منها الفقر، ومستوى التعليم، وحتمية مشاركة مؤسسات الدولة في حماية أماكن التراث الروحي والمتاحف والمكتبات العامة من ناحية، وأهمية اشتراكها مع المؤسسات الأهلية التي ازدهرت في العشر سنوات الأخيرة في توفير مصادر المعرفة كحق لكل فرد من ناحية أخرى. سأطرح فقط بعض النقاط كبداية للنقاش: 1- واحدأول قانون يجب مناقشته والضغط لتغييره من أجل تشجيع الجمعيات الثقافية المستقلة التي هي أكثر الضمانات أهمية في مواجهة / ومع مؤسسات الدولة الثقافية هو قانون 84 لسنة 2002 والذي لم يكن إلا تعديلاً شكلياً لقانونيّ 32 لسنة 1964 و53 لسنة 1999المقيدان لحرية تشكيل جمعيات أهلية وبالذات ثقافية. هذه القوانين تقصر مفهوم مؤسسات المجتمع المدني التي يجب أن نشجعها ونحميها على المؤسسات الخيرية وتفرض رقابتها القاتلة لوأد أي مشروع جماعي ثقافي
اثنين - 2 تفكيك الجسم الضخم الذي يسمى "وزارة الثقافة" والتركيز على مؤسسات ثقافية منوط بها خطط خدمية ثقافية محددة هو سعي للتحرر من تراث الدولة الشمولية الذي بدأ تأسيسه في الخمسينيات وظل فاعلاً حتى الآن، وزارة الثقافة في مصر اشتغلت دائماً على أنها وزارة إرشاد قومي تسيد خطاباً ما، أو تبعية ما، أو ذوق أدبي ما، وكان أول أولوياتها تجميع المثقفين في حظيرة وتوزيع الفتات عليهم طبقاً لقربهم أو بعدهم من سياسة الدولة. ما يمكن مناقشته الآن هو مجموعة من المؤسسات التي تتبنى خططا مدروسة لتوفير أماكن (مكتبات، دور سينما، مسارح، قاعات عرض) ومصادر المعرفة المتعددة لكل مراكز مصر وأطرافها
3- ثلاثةإنها مؤسسات خدمية مجالها الثقافة وليست مؤسسات ثقافية مهمتها تمرير ونشر خطاب السلطة السياسة أياً كانت حتى لو كانت هذه السلطة مختارة وديمقراطية. كما نعرف جميعاً لا يوجد حل سحري لإبطال أجهزة الدولة الأيديولوجية من تمرير خطاب سلطة ما إلى كل مكان ولكن هناك طرق لتحجيم هذا التمرير على الأقل
4- أربعةليس نشر الكتب عبر الهيئة العامة للكتاب والمركز القومي للترجمة وهيئة قصور الثقافة وغيرها فقط بل توزيع هذه الكتب مجاناً على مكتبات الجامعات وقصور الثقافة بل والمكتبات الأهلية. وجود مخازن تتعرض فيها الكتب المكدسة للمياة وللفئران هو عبث لا يمكن تصوره إلا في أفلام الرعب. دعم دور النشر المستقلة والصغيرة بشراء مطبوعاتها وتوزيعها على المكتبات العامة وإجراء اتفاقيات يتم عبرها بيع هذه الكتب لمكتبات في العالم العربي وخارجه هو جزء من الخدمة الثقافية التي يجب أن تقوم بها مؤسسات الدولة
5- خمسة
مصادر المعرفة ليست كتباً فقط، بل أفلام، ووسائل اتصال تكنولوجية توفر المعلومات والبحث في الجامعات والمدارس والمراكز الثقافية. فهناك مدن وقرى كبيرة بلا مكتبة عامة واحدة، وهناك مكتبات فيها كتب فقط ولا يتوفر بها خرائط وأفلام ودورات تدريبية للرسم والكتابة والتطريزوالفيديو آرت وغيره وهذا نزوع لحصر مفهوم المعرفة في القراءة. مؤسسات خدمة الثقافة يجب أن توفر مواقع على الانترنت يمكن البحث فيها عن كل ما يخص نشاطاتها
6- ستةوزارة الثقافة كما عهدناها كانت معزولة ومتعالية على الوزارات الأخرى؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر ما كان يقوم به المجلس الأعلى للثقافة من مؤتمرات أكاديمية كان يمكن أن تقوم الجامعات بما هو أفضل منه من حيث التعدد والاتصال والمشاركة إذا توفر لها نفس المال بالإضافة إلى إلغاء كل القوانين المقيدة للبحث والتجمع ولحرية أعضاء هيئات التدريس. ما يجب التفكير فيه هو وسائل غير محدودة لربط مؤسسات خدمة الثقافة مع كافة المؤسسات الأخرى وسأضرب أمثلة قد تبدو بسيطة: مساهمة مثقفين ومتخصصين في إقامة دورات تدريبية دورية بالاشتراك مع وزارة التعليم للمدرسين والعاملين بالمكتبات المدرسية والحكومية. إخراج المؤتمرات الثقافية من مبنى الأوبرا إلى الجامعات والساحات العامة لأن الكتاب المدعويين والموسيقيين والأفلام يدفع تكلفتها كل المصريين ويجب أن تكون خدمة ثقافية لهم جميعاً. الاشتراك مع وزارة الصحة والإعلام في تعميم ونشر معلومات عن تحديد النسل وسرطان الثدي وخطر التلوث وحلوى الأطفال الملونة وغيره. أتحدث هنا عن مشاركة وتخطيط يوفر المعلومات ولا يهين ذكاء الناس وقدراتهم على التفكير ببرامج توعية أحادية ومتخلفة تذكروا برامج التوعية عن مرض البلهارسيا كمثال يجب التوقف عن انتاجه
7- سبعةأي دور ممكن لمؤسسات خدمة الثقافة بالدولة لا يمكن أن يكون بمحاربة الجمعيات الأهلية المستقلة يعزلها أو باستقطابهاعلى طريقة فاروق حسني، بل بالحفاظ على استقلاليتها مع الاستعانة بها في إيصال نشاطاتها لأكبر قدر ممكن من الأفراد. عندي مثال؛ جمعية مثل المورد الثقافي، لماذا لا يتم دعوة نشاطاتها في مراكز شتى. فورد فاونديشن التي حافظت على بقاء بعض الفرق الموسيقية مثل الطنبورة لماذا لا يتم التنسيق معها بدلاً من الاكتفاء بتجريم أي مؤسسة أجنبية وكأن الثقافة الوطنية النقية والعذراء مهددة ومستهدفة من كل غريب!!.
8- ثمانيةإقامة مهرجانات تحت عناوين مختلفة يتم فيها دعوة نفس الصحفيين والمتنفذين الثقافيين في بلادهم، وإقامة لجان ميتة للشعر والرواية والمسرح يقوم فيها بعض المصلحين من الداخل والانتهازيين بتسييد ذوقهم الأدبي ومصالحهم الضيقة من نقود مقابل الاجتماعات وسفريات وجوائز كان من مظاهر الفساد الذي تحكم في وزارة الثقافة لسنوات. لن أضرب أمثلة لأن الجميع يعرفها، ولكني أقول إن ذلك لن يتغير إلا بعمل قوانين صارمة تجعل أعضاء هذه اللجان – التي أتمنى ألا يكون لها وجود أصلاً- بالانتخاب، وتحرم عليهم السفريات والجوائز والمنح التي يتم تقريرها باللجان التي هم أعضاء فيها طوال فترة عضويتهم
9- تسعةالعالم الذي نعيش فيه ليس هو العالم العربي وأوربا فقط، افريقيا وإيران وآسيا وأمريكا اللاتينية هم جزء منه!! أن يحرم المصريين من مشاهدة الأفلام الإيرانية سنوات ما بعد ثورتهم الاسلامية أو يتم الحجر على فرق عرب اسرائيل المسرحية من المشاركة هو اعتداء على حرية المعرفة واستمرار لتحكم السياسي (السلطوي) في الثقافي (المتعدد) ويجب مراجعة مثل هذه القرارات من المثقفين أنفسهم
10- عشرةالمراكز الثقافية المصرية في الخارج هي مزج عادل بين خطاب الدولة الشمولية الستينية التي تسعى لتحسين صورتها من ناحية وفساد حكومة مبارك السابقة عبر تعيين الجهلاء وأصحاب الوسائط من ناحية أخرى. مهمة هذه المراكز الأولى يجب أن تكون تقديم خدمة ثقافية للمغتربين وللمهتمين بالآداب والفنون. يجب أن تقوم باقتراح ومد المكتبات والمؤسسات الثقافية في أماكن وجودها بقوائم للكتب ودور النشر الصغيرة وغيرها. يجب أن تقوم بتقديم منح واستضافة كتاب شباب ومعارض وفرق من داخل مصر ليجربوا لشهر أو أكثر الحياة في مكان آخر
وأخيراً ليست هذه المساهمة إلا لفتح حوار وأنا متأكدة أن هناك أفكار أكثر أهمية ستأتي ممن يعرفون أكثر مني تكوين ما نريد تفكيكه وهو وزارة الثقافة. الثورة المصرية لم تكن من أجل دولة ديمقراطية ومدنية فقط، بل من أجل أن يعود كل الذين اكتشفوا أن هناك أمل ليمارسوا انتمائهم عبر وجودهم في صفوف معارضة حقيقية في المستقبل
Published on June 11, 2013 08:38
May 11, 2013
Poetry Parnassus, published by Southbank Centre. Summer 2...
Poetry Parnassus, published by Southbank Centre. Summer 2012.
http://www.youtube.com/watch?v=otO85Ymcgx4
Egypt – Iman Mersal
Translated by Khaled Mattawa
Amina
You order beer by phone
with the confidence of a woman who knows three languages
and who weaves words into unexpected contexts.
How did you find this sense of security
as if you’d never left your father’s house?
Why does your presence provoke this destructiveness
that is completely free of intent,
this gravity
that releases my senses from their darkness?
What else should I do
when a shared hotel room offers me
a perfect friend
except to lump my unrefined manners and fling them
at her face as a crudeness I have contrived?
Go ahead, amuse yourself.
I am fair.
I’ll let you have more than half the room’s oxygen
on the condition that you see me beyond comparisons,
you who are twenty years older than my mother.
You wear bright colours
and will never grow old.
My perfect friend,
why don’t you leave now.
Perhaps I’ll open the gray wardrobes
and try on your stylish things.
Why don’t you go
and leave me all the room’s oxygen.
The void of your absence may lead me
to bite my lip in despair
as I look at your toothbrush,
familiar… and wet.
http://www.youtube.com/watch?v=otO85Ymcgx4
Egypt – Iman Mersal
Translated by Khaled Mattawa
Amina
You order beer by phone
with the confidence of a woman who knows three languages
and who weaves words into unexpected contexts.
How did you find this sense of security
as if you’d never left your father’s house?
Why does your presence provoke this destructiveness
that is completely free of intent,
this gravity
that releases my senses from their darkness?
What else should I do
when a shared hotel room offers me
a perfect friend
except to lump my unrefined manners and fling them
at her face as a crudeness I have contrived?
Go ahead, amuse yourself.
I am fair.
I’ll let you have more than half the room’s oxygen
on the condition that you see me beyond comparisons,
you who are twenty years older than my mother.
You wear bright colours
and will never grow old.
My perfect friend,
why don’t you leave now.
Perhaps I’ll open the gray wardrobes
and try on your stylish things.
Why don’t you go
and leave me all the room’s oxygen.
The void of your absence may lead me
to bite my lip in despair
as I look at your toothbrush,
familiar… and wet.
Published on May 11, 2013 09:46
April 30, 2013
"بيرة في نادي البلياردو"، ترجمة إيمان مرسال وريم الريّس 2013.

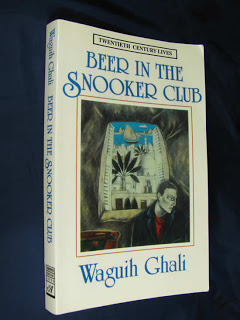
عن دار الشروق بالقاهرة صدرت ترجمة إيمان مرسال وريم الريّس لـرواية وجيه غالي الوحيدة "بيرة في نادي البلياردو"
Published on April 30, 2013 06:53



