الرواية بين الإمارات والكويت (1 من 5): من التجربة الروائية في دولة الإمارات العربية ــ كتب: عبدالله خليفة
تتجه هذه الدراسة نحو قراءة تأسيس للرواية في دولة الإمارات المتحدة. ورغم إن عدد الروايات المدروسة والمعروضة قليل في الدراسة إلا إن النقد يحاول الغوص إلى هياكل هذه الروايات، مبيناً بنيتها الفنية، ونمو الأحداث فيها وبناء الشخصيات، إضافة إلى تشكلها ودلالاتها. والنماذج التي يتناولها النقد هي رواية «شاهندة» لمؤلفها راشد عبدالله، و«ساحل الأبطال» لـ علي راشد محمد و«أحداث مدينة على الشاطئ» لـ محـمد حسن الحربي، و«الاعتراف» لـ علي أبوالريش.
«شاهندة» لـ راشد عبدالله

تمثل رواية «شاهندة» لمؤلفها راشد عبدالله النعيمي من دولة الإمارات العربية ، المستوى القديم للرواية العربية، فتقنيتها تعود إلى الأشكال المبكرة للرواية العربية، كأعمال جورجي زيدان، ذات البناء الفني القائم على كثرة المغامرات والصدف، وعلى التداخل بين الأسلوب الميلودرامي والأسلوب الرومانسي، وحيث تراكم الحوادث هو صلب الرواية.
ورواية «شاهندة» من الروايات المبكرة في منطقة الخليج، ومن التجارب القصصية الأولى في دولة الإمارات كذلك.
تدور رواية «شاهندة» حول عائلة مكونة من أبٍ اسمه «شهداد» وأم هي حليمة، وابنة اسمها «شاهندة»، وتهرب هذه الأسرة من فقر الساحل الشرقي للخليج، إلى الساحل الغربي المصاب بالمجاعة حسب سرد الرواية! راجع الفصل الأول ص 5 – 10.
إن قدوم هذه الأسرة وسفرها مصحوب بمغامرة وصدفة كبيرة، فقد تردت الأوضاع فجأة في القسم الشرقي للخليج، كما أن السفينة الصغيرة التي عبرت بالأسرة البحرَ فوجئت بعاصفةٍ شديدة، ألقت الربان في المياه بصدفة أخرى، وجعلتها تتوه وتلجأ إلى جزيرة صغيرة.
وفي تلك الجزيرة الصغيرة يصادف كذلك أن يراها مالك العبيد النخاس «سالم»، الذي يفرحُ فرحاً شديداً بهذه اللقية الإنسانية، ويتظاهرُ بالعطفِ عليها، حتى يجرها إلى بيته، ثم يقودها للصحراء لبيعها.
إن الفصل الأول الذي يصورُ فيه المؤلفُ واقعَ الجوع والمجاعة على الساحل العربي، والذي يبررهُ بظروف الحرب العالمية الثانية، سرعان ما ينساه، في كل فصول الرواية التالية، فهذا الواقع السياسي الاجتماعي – خلفية المشهد القصصي – سرعان ما يتلاشى ويزدادُ تلاشياً مع تنامي فصول الرواية.
لقد ظهر في هذا الفصل الافتتاحي القوي، ذلك الترابط العضوي والرائع، بين الشخصيات والظروف العامة، بين الذاتي والموضوعي، بين تحول البشر الجياع إلى أشباه للوحوش وبين عالم الحرب القاسي. لكن هذه اللوحة المتداخلة سرعان ما تتوقف عن النمو.
إن مجيء العائلة الفقيرة، غير العربية، على الشاطئ العربي، لاقيمة فينة له، فسرعان ما تغدو العائلة عربية، وتلاشى حواجز اللغة والأنتماء ببساطة.
والأبطال سوف يتحركون، ليس داخل لوحة صراع موضوعية، بل سوف تحركهم الأحداثُ السريعة، وستكون عواطفهم هي مولدات الطاقة في حركتهم، بينما تزول تضاريس المجتمع الموضوعية.
إن المؤلف تحكمهُ، منذ البداية، حكاية مسبقة لشاهندة التي لايعطيها الأصلُ العربي، نظراً لأنها ستتحول إلى ساقطة، ولهذا فهو يؤسس لها أصلاً خارج الجزء العربي، ثم يربطها بأبٍ سرعان ما يقتله في عاصفة بعد تحويله إلى ربان. وهناك فصلٌ كاملٌ يدورُ حول صراع المالك الغني حسين، مع نفسه، ومع الآخرين، عن شهداد وتحويله إلى ربان. ونعتقد بأن هذا الصراع سيكون له علاقة ببنية الرواية، لكن نكتشفُ أن ذلك كان بسبب فعل المؤلف الذاتي، ورغبته في جعل «شاهندة» بلا أبٍ متحكم، لتسهل حركتها الحرة، وخصوصاً تجاه السقوط المنتظر.
ويبدأ السقوط حين تنشىء علاقة مع محمود ابن سالم النخاس، وسرعان ما تسلمه نفسها، خلافاً لموضوعية التشكيل النفسي هنا. وكأن الموؤل يخاف اساسيات التشكيل الموضوعي للشخصيات والأحداث والواقع.
لكن التحولات المفاجئة تتصاعد وتنمو على مساحة الرواية، وتحدث انقلابات في مواقف الشخصيات مثل:
تحول حب شاهندة لمحمود إلى كرهٍ جارف – شهوة حسين المفاجئة لها وهو الذي كان يعتبرها مثل ابنته – بيع شاهندة فجأة بائع العبيد جابر في ليلة مدلهمة – محاولة جابر اغتصابها في الصحراء ثم قراره الزواج منها ! – تحول الكرهُ بينهما إلى حب – ثم فجأة عشقه لعبدةٍ أخرى وخيانة شاهندة له مع خادمه عبدالله – تحول شاهندة إلى مومس – بيعها إلى أحد الأمراء ثم صعودها إلى أن تكون زوجة الملك ! – ثم انتقامها من محمود باستدعائه من قرية الحيرة.
هكذا تتسارع الأحداثُ وتتراكم المصادفات والمفآجات وتنحلُ، فنرى علاقة شاهندة بالشخصيات الأساسية التي تشكلت في الفصول الأولى، كأبيها وأمها وأبنتها وحسين، تزول تماماً، وتتشكل شخصياتٌ أخرى في الفصول التالية، لتنقطع العلاقة بها ايضاً، فلا يبقى من الشخصيات القديمة سوى محمود والرغبة في الانتقام منه.
إن رواية «شاهندة» تمثل المحاولات الأولى البكر لصياغة فن رواية عربي في الخليج، وإذا كانت قد خلقت أسلوباً سردياً – حوارياً مشوقاً، إلا أن المرتكزات الأخرى، الأكثر أهمية لخلق الرواية، ظلت غائبة عن هذا العمل الريادي.
«ساحل الأبطال» لـ علي راشد محمد

تنتمي رواية «ساحل الأبطال» لـ علي راشد محمد إلى نمط الرواية التسجيلية المحضة، وهي تستعيدُ الأشكال الأولى للرواية العربية عبر مزجها البسيط للحدث السياسي التاريخي وحكاية الحب.
فبطل الرواية، الشخصية الخيالية: صالح بن علي الربان، صاحب العائلة، قد وضعه المؤلف في سياق حدث تاريخي هام، هو الحرب الوطنية التي خاضها شعب رأس الخيمة ضد الغزو البريطاني المسلح الدامي.
والمؤلف، رغم بساطة العمل، يتقن تشكيل البناء الروائي، وعرض الأحداث والشخصيات بتسلسل متنام، محافظاً على حبكة درامية مشوقة متصاعدة، مستخدماً التكثيف والإيجاز.
وإذا كانت قصة صالح بن علي قد ظهرت بشكلٍ واسع في الفصول الأولى، فسرعان ما تختفي في فصول الأحداث السياسية والحرب، ويأتي دخوله مرة أخرى كومضاتٍ صغيرة عندما تتفاقم الأحداث. فمرة هو مسؤول عن اختفاء السفن الحربية العربية، ومرة هو سفير للشيخ في مباحثاته مع الأنجليز، ومرة ثالثة هو جزء من قوة صغيرة مهاجمة يستشهدُ فيها ويحمل ابنه الراية من بعده.
إن قصة صالح لم تتداخلْ بعمقٍ مع القصة العامة، وكان دورُها كقصصِ الحرب في روايات جرجي زيدان، مجرد التعريف والكشف للحدث التاريخي. وإذا كان جرجي زيدان يضفر القصتين تضفيراً متشابكاً وبارعاً، فإن المؤلف هنا، علي محمد راشد، قد جعل التقرير التاريخي السياسي هو المسيطر، وقد كتبه بلغة عامة وطنية حماسية، مبتعداً عن حيثيات التاريخ الحقيقية، عبر التصوير الملموس للمجتمع العربي الإماراتي، منشئاً لغة عاطفية لا تتوغل في واقع الحياة.
«أحداث مدينة على الشاطئ» لـ محمد حسن الحربي
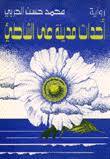
تعد رواية «احداث مدينة على الشاطئ» لمؤلفها محمد حسن الحربي، الصادرة سنة1986 ، من الأعمال القصصية الهامة التي حاولت أن تسبر اغوار التطور الاجتماعي في الخليج العربي، عبر نموذج مركزي، هو مدينة «مريبضة». إن الرواية المكثفة، عبر ثلاثة عقود من السنين في لمحات مكثفة، وعبر احداث صغيرة ، مبلورة لهذا الصراع بين أمير المدينة واهاليها.
ولأول مرة في الرواية الإماراتية الوليدة نجد هذا التوغل في صراعات وتناقضات التطور، وهذه البلورة لأحوال المدينة ومستوياتها الاجتماعية المتعددة، عبر ثيمة صراع مركزة، ولغة سردية جميلة، ولغة حوارية عامية بدوية، تفوحُ برائحة البشر والأرض والكائنات البرية.
بؤرة الأحداث والشخصيات:
تبدو لوحة الصراع التي يشكلها الروائي عفوية، وهي تنمو عبر أحداث صغيرة جانبية متطورة دائماً. ففي البدء نسمع صرخات الطفلة «حصة» وهي تسقط في الحفرة التي عملها «داوود – أبو مطلق» عين أمير المدينة، وإمام المسجد الغريب القادم من مكانٍ مجهول. ويبدو حدث السقوط الطفل في الحفرة معزولاً عن نسيج الرواية، فنحن لا نعرف لماذا عمل أبومطلق هذه الحفرة، وكيف استطاعت هذه الطفلة الصغيرة أن تنجو؟ «في حين إن أبا مطلق يموت في ذات الحفرة بعد سنوات عديدة؟»، ولا نعرف ما هي قيمة السقوط فنياً؟
إن طرقة سرد الرواية تمتاز بهذا التركيز على الحدث، ومتابعة تطوره، بلا توغل في النموذج وحواره الداخلي، فنجد إن أم حصة تفلي ابنتها وتنظفها وهي تسبح بحمدالله وتصفُ قدراته، وحين تتعوذ من الشيطان صارخة تذعر ابنيتها وتجري، فتسقط في الحفرة. وحين تأتي مناسبة الحفرة، فسرعان ما ننتقلُ إلى صانعها: أبي مطلق.
لقد تركنا الأمَ وابنتها، ومشاعرهما المختلفة، ولن نتابع هذه المشاعر والأفكار حين تتطور أو تتجمد لديهما.
إن الحدث الاجتماعي، الخارجي، هو الذي يمسكُ بعنق الرواية مشكلاً مساراتها. فنجد أن حدث السقوط في الحفرةِ يقودنا إلى صانعها، وهنا لا تدخل ذات أبي مطلق، بل نتابع حركته الخارجية، كيف جاء إلى «مريبضة» متخلفاً عن إحدى القوافل، وكيف بنى مسجداً، مستغلاً إياه في غايات تجارية وسياسية غامضة.
ويثير اسمه الحقيقي «الحاج داوود» تساؤلات الأهالي، ويبدو كأن أبا مطلق هو جذر الشر في المدينة. ولا نعرفُ سرَ هذه المكانة العميقة التي اكتسبها الرجلُ في نفس الأمير مجلاد، ولكن يبدو التحالف بين الغريب ذي الأصل اليهودي والأمير، غريباً ومريباً، خاصة حين تنفجر فضائح داوود، مثلما حاول اغتصاب أحد الصبية، فرآه أحد الرجال المهمين في الرواية، وهو حمد بن خميس، وفضحهُ، فحصلَ على جلد من قبل الحاكم، وطرد عائلته إلى اعماق الصحراء.
هنا ينمي الحدثُ الشخصية، ويجلبها إلى دائرته، فتنبثقُ شخصياتٌ عدة من هذا الحدث المسرود، والذي يُقال من فم الراوي – الكاتب، الذي يستعين بالذاكرة الشعبية ورواياتها.
تظهرُ لنا من الحدث شخصية سليمان العبدالله «أبوحصة»، ويطلع كوالدٍ لها، وأيضاً كحارس في القوة العسكرية للأمير مجلاد، وينبثقُ حمد بن خميس، الذي بدا كنقيض مباشر لأبي مطلق المخبر، السييء، الشاذ، كما يطلع حماد السلمي كمهرجٍ غير ذي رجولة، وكنقيض لشخصية سليمان، ويظهر الأميرُ الحاكمُ، الجميل الصورة، المكروه.
إن الروائي في مثل هذه المناسبة يتحول إلى راوٍ، يدهشنا بنقله لأقوال البدويات وحبهن الشديد للأمير وهو يستغلُ مناسبة الحدث الخاص، لاستعادة الموروث البيئي، وعلاماته من اسماء وأشياء، فيبدو الحدثُ، في هذا التوغل التفصيلي، وكأنه رصد «طبيعي» للحياة.
ولكن الحدث لا يتوقف عند الرسم الطبيعي للبيئة البدوية، بل هو يتوغلُ وراء سيرورة الفعل الروائي. ولأن الرواية تمتاز بهذه الصنعة العفوية، فإن حديث الحفرة وشبكته المتعددة، سرعان ما ينطفئ ونجد بؤرته تتركز – فجأة – لا على حصة أو أمها، أو أبي مطلق ، ولكن على الحارس الذي انبثق عفوياً، من داخل هذا النسيج، وهو أبو حصة، سليمان العبدالله.
إننا نغادر، فجأة، الشخصيات العادية، لنقترب من شخصية غير عادية، «مفكرة» لها خصائص هامة جنينية، فهذا الحارس التابع للأمير، والذي يغادر معه إلى الحج، سرعان ما يتحول إلى شخصية أخرى، لم تنبثق من شخصيته السابقة.
إن اختزال الشخصيات يقودُ إلى عفوية لقاءاتها وبساطة شديدة للحدث.
فالحدث هنا لا يسيرُ متوغلاً في الروح والماضي، مكسباً الشخصيات أعماقاً وأبعاداً، بل هو يعودُ إلى طبيعته الأولى، كحدث خارجي، ظاهري، سياسي.
وهنا يتجهُ الحدثُ نحو بؤرته، أي إلى تعاون المعارضين ضد سلطة الأمير مجلاد المطلقة، فسليمان يلتقي بحمد بن خميس مشكلين عنصرين متعاونين ضد مجلاد. بل أن حماد السلمي الذي كان الأمير قد حوله إلى اراجوز لتسليته وتسلية أصحابه، ينقلب إنقلاباً ميلودرامياً، منتقلاً من اللاشخصية إلى الشخصية الفاعلة المغيرة، ويذكرنا هذا التحول المفاجئ والكامل بتحول سليمان نفسه، كما يذكرنا بسلسلة التحولات الكاملة المفاجئة في الشخصية الروائية الإماراتية عموماً.
الزمان والمكان الموضوعيان:
حين حدث سقوط حصة في الحفرة، أو سقوط «الأمة في الهزيمة»، كان الوقت شهر يونيو القائظ، في لحظة غير مؤرخة من زمن الخليج السابق للنفط. وبعدئذٍ يبدأ الزمن بالتدفق السريع، فنجد إن الزمن يقفز، بعد فصولٍ قليلة، ثلاثة عشر عاماً، بدت كأنها ومض، وصار الصغار كباراً، ويمضي الزمن بسرعة في الفصول الأخيرة، فتبدو انعكاسات التغير الاجتماعي الحادة على اتساع المدينة وتبدل سكانها.
إن الزمن الموضوعي يمضي في الرواية بصورة عفوية، فنجد حدثاً ذا زمن محدود يحصل على رصدٍ مطول، بينما تغورُ سنواتٌ عديدة في الغياب الفني، وتأتي لحظاتٌ قصيرة أخرى، لتحصل على زمن روائي مطول.
إن بعض انقطاعات الزمن الموضوعية تعني انقطاعات هامة في تطور الشخصيات، فالثلاثة عشر عاماً المفقودة تشير إلى فقدان ركائز وحيثيات هامة للشحصيات، وكان من الممكن أن تحدث انقلاباتها بصورة متجذرة في الماضي. ولذا فإن ثغرات الزمن هي ثغرات في الشخصية، أو قل بأن الزمن الفني العفوي ترك بصماته على تشكيل الشخصية بشكل مماثل، مما أفقدها الجذور الاجتماعية والنفسية المُبرِّرة لتحولاتها.
وكذلك فإن زمن النفط والتمرد تسارع بشكل كبير، بصورةٍ غير متضافرة مع تحول الشخصيات في حين نجد لحظات روائية محددة تأخذ عقوداً من السنين، وبصورة سريعة، مما يؤدي إلى عدم إشباع هذا الزمن الروائي. مثل لحظة وقوف سليمان العبدالله في الكعبة وتذكره لشريط حياته، بدءاً من استرجاع كلام أمه إلى عمله مع مجلاد. إن هذا التسريع للزمن الموضوعي، في زمن روائي مكثف، يشير إلى هذه الصفة.
إن زمن الرواية الموضوعي يمتدُ إلى نحو ثلاثين عاماً، بدا فيها الزمن الروائي قصيراً وومضياً، لم يتوغل إلى كثافة الزمن الموضوعي واتساعه، رغم استطاعته تسليط الأضواء مركزة على جوانب منه.
وبخلاف الزمن ، كان المكان الروائي أكثر كثافة وحضوراً. إن مدينة «مريبضة» تمثل قرية الصايدين والبدو المتحولة إلى مدينة نفطية. وقد توغل الكاتب إلى تضاريسها الاجتماعية والمكانية المتعددة، فهناك الأكواه، والبيوت، والقصر، والسجن، والصحراء، والكعبة، والشاطئ، والمحكمة، والبادية بخيامها وعالمها، بل نجد هذه الرؤية الدقيقة لتباين المساكن وتناقض التطور في المدينة وانقساماتها إلى طبقات مختلفة. ص 72.
إن البشر في الرواية ينتمون لإماكن محددة متناقضة، وأغلبهم ينتمي للأزقة والبادية، في حين يقفُ القصر بعيداً ومتوارياً.
إن الكاتب يضفرُ بصورة جميلة بين تضاريس المكان وقوة الحياة الاجتماعية، ويضع الشخصية على جذور المصالح المتصارعة، ولهذا نجدُ هذا التداخلَ بين الموضوعي والذاتي، المكان والشخصيات، التاريخ والطبقات، الأجواء والمشاعر، الوجود والفاعلية.
ولهذا فإن الرواية تضعُ قدمها على بداية الواقع، وتحاولُ أن تقوم بتعميمات فنية إبداعية، تعبر عن مرحلة كاملة. وإذا كانت هذه التعميمات لم تصل، بعد، في هذه التجربة، إلى درجة الاكتمال، فإنها تشكلُ بداية لهذا التوغل الجريء والجديد.
«الاعتراف» لـ علي أبوالريش

تدورُ رواية علي أبوالريش «الإعتراف» الصادرة سنة 1982، حول حياة عائلتين متشابكتي المصير، هما عائلة سهيل وعائلة سمحان.
ففي الفصل الأول، وفي حدث مفاجئ مشوق عنيف، يهجم شخصٌ ما، على سهيل وهو جاثم في أرضه الزراعية، ويقتله بضراوة.
ليس القاتل إلا سمحان، أب العائلة الثانية، والتي سوف تتداخل علاقتها وحياتها مع عائلة سهيل، ولكننا في البدء، لا نعرف هذا الفاعل القاتل، ولا سبب هذه الهجمة الضارية. وسوف نبقى إلى آخر الرواية نجهل القاتل، ولكن دون الأسباب المعقولة لهذا الحدث العنيف.
هنا يتقدم إلى مسرح الفعل الروائي صارم ابن سهيل، وهو يهدد ويتوعد بالثأر وتظلل بيت القتيل سحابة كثيفة من الحزن والألم الفاجع، في حين تستمر صرخات صارم المتوعدة حتى بعد انقضاء المأتم، ويذهب لبستان أبيه، ويحملُ بندقيته ويخفيها في بيته من أجل الثأر المنتظر.
إن مجريات الحياة العادية، غير الدرامية، تبدأ بالاستحواذ على سرد الرواية وحوارها المتداخلين المطولين إلى درجة واسعة.
فنجد إن محور الثأر، والبحث عن القاتل، سرعان ما يختفي لتحل المسارات التالية:
تقوم الأمُ رفيعة والأختُ ريحانة بتهدئة صارم وتبديان خوفهما عليه، حتى لا تفقدان الأب والابن – الأخ في حادث واحد، وهو يطاوعهما مخفياً نيته الباطنة بالانتقام، لكن هذه النية الباطنة تتلاشى تماماً، إلا من بضع جملٍ متناثرة في فصول الرواية التالية.
يتجهُ صارم إلى المدرسة ليلتقي بالأصدقاء، ويفاجأ بسقوط صديقه الأثير محمد الدراسي، في امتحان الإعادة، ويتحول هذا السقوط إلى قنبلةٍ بين الأصدقاء، وفي نفس صارم، ثم نجد محمداً وهو يعاني هذا السقوط الدراسي، الذي بدا رهيباً وأشبه بكارثة طبيعية.
ويبدأ مسار الطالب الآخر محمد يأخذنا إلى عالمهِ الخاص الذي لا يعدو حبه الصامت لريحانة وحبها له، وشراسة ابيه سمحان، ومحاولة تزويجه لابنة صديقه الغني، لكن محمداً يرفضُ ذلك متحملاً «العواصف» داخل بيته، بترك المدرسة ويتوسط له أحدهم بعمل جيد، فيندفع للزواج من ريحانة، ويوافق صديقه صارم على رغبته هذه بكل سهولة وود.
وفي مثل هذه الأحداث لم يستغل اللغم المدفون الذي زرعه الرواية، فانسابتْ العلاقة بين ابن القتيل وابن القاتل، بهدوء تام، وتزوج محمد ريحانة وأقيم فرح صاخب، كان القاتل وحده بعيداً عنه، ليس بسبب فعل الجريمة، لكن بسبب عدم طاعة ابنه له، وزواجه من فتاة فقيرة، هي ابنة غريمه السابق.
الأحداث قليلة ومحدودة في الرواية، وهي تصيغُ عملاً من نوع الرواية العائلية، التي تدورُ حول الأسرة وعاداتها وإعادة إنتاج ذاتها عبر الزواج، فأغلب الأحداث تجر داخل العائلتين المتضادتين، عائلة سهيل وعائلة سمحان، وداخل مجالس وغرف بيتيمها، أو في البستان الذي يملكهُ سهيل، أو الدكان الذي يملكهُ سمحان، وإذا انطلقت الأحداثُ خارجهما، في الشوارع أو الجامعة، فتكون قليلة، وسرعان ما تعود إلى دائرتها الأسرية.
لكن ليس لقتل أب الأسرة الأولى، أي تأثير درامي على حياتها، سواء في انهيار معيشتها أو تماسكها الداخلي، فموت الأب كوجوده. ولا تظهرُ سوى غلالة مؤقتة من الحزن سرعان ما تتلاشى كذلك ليتركز البناء على عرض المجرى المعتاد لحياة الأسرة من استقبال للزوار وبحث عن زوجة أو تزويج الابنة.
إن عدم تحول الوقائع الجزئية الصغيرة الكثيرة إلى حلقات فنية متنامية لتجسيد صراع جوهري، أو تصوير علامات روحية هامة، يعودُ كذلك إلى بقاء النماذج – الشخصيات كحالات حاضرة عفوية سريعة، فليس ثمة تاريخ عميق وراء هذه النماذج. وكان ابرز مثال هو «سهيل الأب»، الشخصية الغائبة والمحورية، والمقتولة. فإننا لا نكاد نعرفُ عنه شيئاً، فما بالك بتجسده كشخصية فنية؟
إن كل الشخصيات تحيا وقائعها الآنية الصغيرة المحضة، بلا تاريخ، وبلا نمو وحفر خاص في عالمها المتفرد اللااجتماعي واللاتاريخي، فتصيرُ انفعالات سريعة متبدلة، غير قادرةٍ على التحول إلى عواطف وأفكار قوية هامة. فصارم لا يكاد يتذكرُ شيئاً من ابيه؛ صوته، وكلماته، ومشاعره، ليتجذر فيها فينمو موقفاً وإرادة وفعلاً، ولا يصارع الجريمة وشبكتها الاجتماعية، فيتشكل فكراً، ويتكثف المجتمع علاقات وصراعاً.
وهو يتذكرُ حبيبته فجأة، بعد عدة فصول، دون أن تتحول هي الأخرى إلى علاقات ذات ماضٍ وتواريخ وأحداث. ومن هنا تغدو العلاقات بين الشخصيات واهية، مما يقودُ إلى ضعف سماتها وتفردها.
وتفتقر الشخصيات كذلك إلى الصراع المتوتر بينها، المتمثل في تشكيل العقدة، حسب المعايير الكلاسيكية. فلقد كانت العقدة الأساسية هي معرفة القاتل، التي خلقت جذباً وتوتراً في بدء الرواية، لكن هذه العقدة مالبثت أن أُزيحت حتى آخر فصول الرواية، لتبدأ عقدة أخرى في الحلول مكانها، وهي عقدة رغبة صارم ومحمد في الزواج. ولكن هذه العقدة القصصية لم تخلق توتراً قصصياً، بل هي تنسابُ بسهولة وتـُحل بلا أي صدامات، ولهذا راح إيقاع الرواية يتمدد كمياً ويتعثر.
ولعل الأسلوب الخاص بالمؤلف يمتلك ميزة إيجابية هامة في اتجاه المباشر لوصف حركة الشخصية الخارجية والداخلية، ويحركها في وسطها بشكل دقيق، لكن هذه الحركة الهامة تبقى جزئية وصغيرة بدون المعمار الكلي القوي للرواية، وهو يغرقُ في هذه اللغة الوصفية السردية الطويلة أو الحوارية غير الموظفة.
ونرى هنا كيف أن الاسلوب القصصي الإماراتي اتجه إلى حيثيات الحياة، إلى الدراما العائلية، وإلى تضاريس الشوارع والمدن عن لغة المغامرات المجردة، فالكاتب يتوجهُ في روايته هنا إلى عرض عائلتين محددتين ولكنهما تغوصان في مشكلاتهما الخاصة المفصولة عن إيقاعات وصراعات المجتمع.
إن هذه الواقعية الملموسة، ذات الموضوع العائلي، تجري بأسلوب ميلودرامي – قدري وديني، فنجد التحولات والانقلابات المفاجئة هي التي تتحكم في بنية الأحداث، وهي أحداثٌ تجري في دائرة الحياة اليومية، وتنفيذاً لآلية قدرية ميتافيزيقية عليا.
فلو رتبنا الأحداث بصورة أخرى، فسنجدها كما يلي:
سمحان يعتدي على سعدية – موت مفاجئ لسعدية – سهيل يقلب صداقته مع سمحان إلى عداوة – سمحان يقتل سهيلاً – صارم يصرخ للثأر – صارم ينسى الثار ويغرق في الحب المفاجئ – محمد الذكي يرسب في الامتحان – سفرٌ مفاجئ لعائلة رحاب وعودة مفاجئة كذلك.
والميلودراما تتشابك برومانسية هادئة؛ مرض خطر لسمحان وانقلابه نحو الخير – القدر الإلهي يعاقب الشرير ويثيب الخير.
إن ميلودرامية «الإعتراف» أقل من ميولدرامية شاهندة ولكن الحبل السري لا يزال قوياً ومشدوداً بين الروايتين. إن ذلك يشير إلى هذا الغياب للتحليل العميق للحياة، وهلامية البناء الفني، وعدم تناسب أجزائه، وعدم تبلور نماذجه وصراعه و«عقدته» وتضخم لغته السردية المطولة.
استنتاجات:
أولاً: إن الرواية لم تظهر في الخليج العربي إلا في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين وبشكلٍ محدود وقليل، وإن هذا التأخير يعود إلى تأخر النهضة الاجتماعية في المنطقة ومن ثم بروزها بشكل خافت في منتصف القرن قبل انفجارها في العقد الأخير.
وإن الوعي الفني الذي شكل المسرحية لعرض المشكلات الاجتماعية البارزة هو نفسه الذي راح ينعطف بالقصة القصيرة نحو القصة الطويلة أو نحو الرواية.
وإن المدن البحرية الواقعة على طريق تجاري دولي، وفي ظل تطور اقتصادي ثقافي متسارع، شهدت ميلاد ونمو الرواية ، لأن هذه المدن التي كانت جزءاً أساسياً من نسيج مجتمع الغوص ، بدأت قبل غيرها من الانفلات من شبكة العلاقات الاجتماعية التقليدية.
ثانياً: إن نمو الرواية من معطف القصة القصيرة يدلُ بوضوح على بكارة النسيج الروائي، وعدم وجود خلفية تاريخية فنية عميقة، لأن معظم الروايات هي من النوع القصير في الحجم والبنية الفنية.
ثالثاً: إن سمة القصر والتكثيف ليست سمات شكلية بحتة بل هي مرتبطة بالتشكل الإبداعي، لأنه يقود إلى عدم تشبع التحليل الفني للواقع فالشخصيات القليلة والأحداث الصغيرة، لا تقومُ بمد شبكتها الوساعة في الحياة، واكتشاف تعدد مستوياتها وصراعاتها وعوالمها الخفية ووجودها النفسي والروحي، بل هي تركز دائماً على جوانب صغيرة كما جاء في روايات علي أبوالريش المركزة على حدثٍ يعيشُ على ضفاف المدينة الخليجية المعاصرة.
رابعاً: إن الرواية في الإمارات ليست بعيدة عن مسار وإشكالات الرواية الخليجية، فقد نمت بخطى صاعدة، ولكن بكمية محدودة ومتقطعة وأن اختلف التوجه ما بين على ابوالريش وراشد عبدالله في «شاهندة» عكست سمات قديمة في الرواية العربية من كثرة المغامرات والتحولات المفاجئة ، فإن لدى على ابو الريش التحليل الاجتماعي والسيكولوجي للشخصية عبر لغة سردية – حوارية واسعة ومتغلغلة في كيان الشخصية.
في حين إن محمد حسن الحربي يمثل توجهاً مختلفاً يصور في روايته تناقضات المدينة ذاتها، فالمدينة هنا كائنٌ اجتماعي تاريخي نام، وليس شكلاً عمرانياً متميزاً ومادياً محضاً، إذ يغوصُ الحربي عبر نماذجه الكثيرة في هذه البلدة البحرية – البدوية المتحولة إلى تجمعٍ ضخم، وهو يصيغُ ذلك عبر السرد الواسع والأحداث السريعة الوامضة.
خامساً: إن بذور مدرسة فنية تتضح ،فأغلب النماذج المدروسة تتجه إلى تصوير الواقع ونقده، إلا أنها لم تتغلغل بعد إلى الطبقات التحتية الكثيفة لهذا الواقع ، وخاصة في المستويين الروحي والنفسي و لاتزال تمشي فوق تضاريس الواقع الاقتصادية والاجتماعية المباشرة.
سادساً: هذه النماذج الروائية تركز على الاستخدام الموسع للسرد الذي يبدو مكثفاً وامضاً واجتماعياً معتمداً على البحث الاجتماعي ومندمجاً بوصف وحوار – بلا فواصل – لدى علي أبوالريش، وواسعاً مسيطراً عند محمد حسن الحربي، وغالباً ما يكون الحوار والوصف في تبعية شبه مطلقة للسرد، فتبدو الرواية أنها تبدأ خطواتها الصغيرة في فهم الواقع وتشكيل بنية متضافرة، ولهذا فإنها لا تستطيع أن تسيطر على أدواتها الفنية تماماً، فتبدأ بتشكيل مفرداتها الأساسية، وتبقى امامها مهمات جمالية – اجتماعية كبيرة للسيطرة على عالمها الفني.



