حوار مع الكاتب عبدالله خليفة: المؤلف الجيّد عاجز عن الوصول الى الناس
مجلة «الجديد» التابعة للحزب الشيوعي الإسرائيلي، تنقل مقابلة لعبدالله خليفة نشرت اصلاً في مجلة «اليوم السابع» سنة 1988.
The Palestinian Museum Digital Archive – أرشيف المتحف الفلسطيني الرقمي: العدد الثاني عشر من مجلة الجديد، كانون الأول 1988.
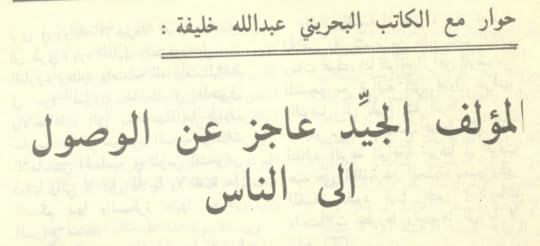
يعتبر الكاتب البحريني عبدالله خليفة، من ذلك الرعيل الذي ظهر منذ أواسط السبعينات، وسط زخم أدبي بحريني متميز شهد ظهور أسماء عديدة على الساحة العربية، وهو كاتب قصة ورواية ونقد، صدرت له روايات عديدة ومجموعات قصصية، ويستعد حالياً لإصدار كتب أخرى.
في البحرين التقى به يوسف مكي، مكاتب «اليوم السابع» وطرح عليه أسئلة عديدة تنشرها «الجديد» فيما يلي لإطلاع القراء على هذا الكاتب وتجربته الأدبية:
■ بدأت بكتابات القصة القصيرة وانتهيت إلى كتابة الرواية منذ بداية الثمانينات، لماذا هذا التحول؟ في البداية أود ان اقول ان القصة القصيرة التي كتبتها كانت تتسم بالبحث الشمولي في الحياة والواقع، إذ أنها تتطلب تكثيفاً وتركيزاً على اللحظة النفسية أو الاجتماعية المحددة. ولكن كانت القصة التي اكتبها تهتم بهذا التركيز وترفض بعض جوانب الواقع، وتكشف اللحظة النفسية في ارتباطها بجوانب أعمق في الحياة. وقد دفعتني هذه المسألة الى الاهتمام بتوسيع هذه اللحظة وتعميق اللحظة القصصية وبالتالي ربطها بدلالات اجتماعية وتاريخية أعمق. فعلى سبيل المثال كتبت في بداية حياتي الأدبية قصة تتحدث عن مغني البحر، عن شخص في سفينة الغوص يغني ويطرب البحارة ويدفعهم لمزيد من العمل والإنتاج. هذه القصة مكثفة تهتم بلحظة نفسية مكثفة جدا، ولكن عندما ازددت معرفة وازددت عمقاً وفهماً للحياة والإنسان أخذت هذه اللحظة تتسع فلم اكتف بمغني البحر وحده في مشكلته الجزئية، وإنما صار هناك اهتمام بمرحلة الغوص واهتمام بتحليل هذه المرحلة بنماذجها المتعددة والاتجاه الى ربطها بجذورها التاريخية والاجتماعية فغدت اللحظة الصغيرة في القصة القصيرة نوعاً من الملحمة المكثفة التي تهتم بصراع هؤلاء البشر في لحظة زمنية عميقة المحتوى.
في البداية أود ان اقول ان القصة القصيرة التي كتبتها كانت تتسم بالبحث الشمولي في الحياة والواقع، إذ أنها تتطلب تكثيفاً وتركيزاً على اللحظة النفسية أو الاجتماعية المحددة. ولكن كانت القصة التي اكتبها تهتم بهذا التركيز وترفض بعض جوانب الواقع، وتكشف اللحظة النفسية في ارتباطها بجوانب أعمق في الحياة. وقد دفعتني هذه المسألة الى الاهتمام بتوسيع هذه اللحظة وتعميق اللحظة القصصية وبالتالي ربطها بدلالات اجتماعية وتاريخية أعمق. فعلى سبيل المثال كتبت في بداية حياتي الأدبية قصة تتحدث عن مغني البحر، عن شخص في سفينة الغوص يغني ويطرب البحارة ويدفعهم لمزيد من العمل والإنتاج. هذه القصة مكثفة تهتم بلحظة نفسية مكثفة جدا، ولكن عندما ازددت معرفة وازددت عمقاً وفهماً للحياة والإنسان أخذت هذه اللحظة تتسع فلم اكتف بمغني البحر وحده في مشكلته الجزئية، وإنما صار هناك اهتمام بمرحلة الغوص واهتمام بتحليل هذه المرحلة بنماذجها المتعددة والاتجاه الى ربطها بجذورها التاريخية والاجتماعية فغدت اللحظة الصغيرة في القصة القصيرة نوعاً من الملحمة المكثفة التي تهتم بصراع هؤلاء البشر في لحظة زمنية عميقة المحتوى.
والملاحظ أنه كثيراً ما يبدأ القصاصون بالقصة القصيرة وتتعمق رؤاهم ومعرفتهم ثم يتجهون الى الأنواع الأدبية الأكثر إطالة وتوسعاً لتعميق القضايا التي كانوا يطرحونها. فعلى سبيل المثال «تشيخوف» بدأ بالقصة القصيرة ثم اتجه الى الرواية والمسرحية على وجه التحديد لأن اللحظات القصصية القصيرة المكثفة التي كان يكتبها كان بحاجة الى تعميقها أكثر. وهذا ما حدث بالنسبة لعدد من القصاصين العرب والعالميين.
■ هل يعني ذلك التحول الانتقال من حدث فردي تتناوله القصة القصيرة الى حدث اجتماعي متمثل في الغوص وصراع الأفراد. وبالتالي لا بد من تناوله في رواية؟ القضية ليست هكذا بالتحديد وإنا القصة القصيرة هي لحظة مكثفة موجزة تتناول خيطاً ما من هذا الإنسان أو من هذه الحادثة. هذا الخيط من الممكن أن يطرح بأشكال متعددة عن كل مناحي الحياة ولا بد من ربط النواحي التراثية النفسية والناحية الاجتماعية. والقصة القصيرة لا بد أن تربط بين هذين الجانبين. ولكنك وانت تكتب القصة القصيرة تكتشف باستمرار جوانب عديدة في الحياة الاجتماعية وفي هذه الحالة تلح عليك الأنواع الأدبية الأخرى لكي تستوعب المشكلات والأجزاء الكبيرة في الواقع والجوانب الروحية. والملاحظ هنا في البحرين إن التطور الأدبي كان مهتماً بالقصة القصيرة والشعر باعتبارها يمثلان نوعين يعبران عن مستوى وعي المبدعين الشباب، ولم يكن حينها يوجد لدينا تراث محلي من نوع الرواية وبالتالي كان لا بد إذ تكون القصة القصيرة في مجتمع ما زال في بداية انفتاحه على العالم ومن خلال ملاحقة التطورات الأدبية الجديدة في العالم العربي، وبعد سنوات من الخبرة والتطور، كانت هناك مسائل كثيرة ومستجدة تنمو في الحياة. وقد كنا فى حاجة الى تطوير الأدب والأدوات الخاصة به وفي ظل وضعية المجتمع بشكل عام كان لا بد أن تكون الأمور مرتبطة بالقصة القصيرة ومن ثم الانتقال الى نوع جديد وهو الرواية أو المسرحية.
القضية ليست هكذا بالتحديد وإنا القصة القصيرة هي لحظة مكثفة موجزة تتناول خيطاً ما من هذا الإنسان أو من هذه الحادثة. هذا الخيط من الممكن أن يطرح بأشكال متعددة عن كل مناحي الحياة ولا بد من ربط النواحي التراثية النفسية والناحية الاجتماعية. والقصة القصيرة لا بد أن تربط بين هذين الجانبين. ولكنك وانت تكتب القصة القصيرة تكتشف باستمرار جوانب عديدة في الحياة الاجتماعية وفي هذه الحالة تلح عليك الأنواع الأدبية الأخرى لكي تستوعب المشكلات والأجزاء الكبيرة في الواقع والجوانب الروحية. والملاحظ هنا في البحرين إن التطور الأدبي كان مهتماً بالقصة القصيرة والشعر باعتبارها يمثلان نوعين يعبران عن مستوى وعي المبدعين الشباب، ولم يكن حينها يوجد لدينا تراث محلي من نوع الرواية وبالتالي كان لا بد إذ تكون القصة القصيرة في مجتمع ما زال في بداية انفتاحه على العالم ومن خلال ملاحقة التطورات الأدبية الجديدة في العالم العربي، وبعد سنوات من الخبرة والتطور، كانت هناك مسائل كثيرة ومستجدة تنمو في الحياة. وقد كنا فى حاجة الى تطوير الأدب والأدوات الخاصة به وفي ظل وضعية المجتمع بشكل عام كان لا بد أن تكون الأمور مرتبطة بالقصة القصيرة ومن ثم الانتقال الى نوع جديد وهو الرواية أو المسرحية.
الوقت المناسب
■ هل يعني ذلك أن التحول من القصة القصيرة إلى الرواية جاء في وقته المناسب؟ اعتقد ذلك، خاصة أنني كتبت عدداً من القصص القصيرة، حوالي مجموعتين وقصصاً أخرى، وفي مرحلة السجن حدثت عملية اختمار فكري وأدبي وتأملات طويلة تم تحويلها الى رواية. إلا أن المسألة في حقيقة الأمر كانت عضوية. وهذه العضوية تنطبق على كتابة أي نوع من الأنواع الأدبية. ومن ثم يبدأ الوعي باكتشاف عملية الخلق الروائي بشكل أعمق. وكما ذكرت فإن القصة القصيرة المكثفة تكون البداية ثم الرواية بهدف تعميق الوعي الفني الموجود عند الكاتب، وهذا ما تعجز عنه القصة القصيرة وتستوعبه الرواية. وفي هذه الحالة يشعر الكاتب بأنه قام بكتابة ما لديه أو ما يعانيه ويختمر داخله. فرواية «اللآلئ» كانت عبارة عن تأملات طويلة في حياة الوطن وتعمق في كشف الأشياء والبحث عن المصائر التاريخية للأشياء والأفراد (الإنسان) كما أن الرواية تبحث الأسئلة الكبرى في الحياة. وهنا تأتي الرواية للإجابة عن هذه الأسئلة.
اعتقد ذلك، خاصة أنني كتبت عدداً من القصص القصيرة، حوالي مجموعتين وقصصاً أخرى، وفي مرحلة السجن حدثت عملية اختمار فكري وأدبي وتأملات طويلة تم تحويلها الى رواية. إلا أن المسألة في حقيقة الأمر كانت عضوية. وهذه العضوية تنطبق على كتابة أي نوع من الأنواع الأدبية. ومن ثم يبدأ الوعي باكتشاف عملية الخلق الروائي بشكل أعمق. وكما ذكرت فإن القصة القصيرة المكثفة تكون البداية ثم الرواية بهدف تعميق الوعي الفني الموجود عند الكاتب، وهذا ما تعجز عنه القصة القصيرة وتستوعبه الرواية. وفي هذه الحالة يشعر الكاتب بأنه قام بكتابة ما لديه أو ما يعانيه ويختمر داخله. فرواية «اللآلئ» كانت عبارة عن تأملات طويلة في حياة الوطن وتعمق في كشف الأشياء والبحث عن المصائر التاريخية للأشياء والأفراد (الإنسان) كما أن الرواية تبحث الأسئلة الكبرى في الحياة. وهنا تأتي الرواية للإجابة عن هذه الأسئلة.
■ ذكرت أن الرواية بمعنى ما تحاول الإجابة عن الأسئلة الكبرى للمجتمع الذي تصدر عنه. والملاحظ ان روايتك الاولى تتناول فترة الغوص وهى فترة ما قبل النفط. هل هذه الرواية تجيب عن الأسئلة الكبرى للماضي أو عن الأسئلة الكبرى للمرحلة المعاصرة؟ ـ سؤال جميل – تناول الماضي هو دائماً تناول للحاضر. لا يوجد بحث أو كتابة تهتم بالماضي بصفته المجردة. والنقاش في الماضي ليس نقاشاً في الماضي وإنما في الحاضر ولأجل الحاضر.
ـ سؤال جميل – تناول الماضي هو دائماً تناول للحاضر. لا يوجد بحث أو كتابة تهتم بالماضي بصفته المجردة. والنقاش في الماضي ليس نقاشاً في الماضي وإنما في الحاضر ولأجل الحاضر.
وبالتالي فهو نقاش في الحاضر وصراعاته. وهذا ينطبق على الرواية. وعندما يكتب روائي عن فترة ماضية، ويكتشف هذه الفترة وتناقضاتها وأعماقها من نماذج بشرية تعيش فيها والقضايا والأسئلة المهمة التى تؤرق هذه الفترة عندما يتحدث عن ذلك فهو إنما يناقش مسائل عصره بالتحديد. وعندما لا تكون هناك مناقشة لقضايا العصر الملحة، يكون العمل الأدبى لا قيمة له.
وهنا بطبيعة الحال لدينا الرواية، لأنه لا بد أن يكون ذلك العمل الأدبي شرارة تصب في هذا الصراع العام. ولا بد أن يكون قوة مضيئة في التحولات التي تجري في وقتها. فإذا ما سحبنا هذا المفهوم النظري على التجربة الملموسة، نجد بأن رواية «اللآلئ» هي اكتشاف للصراع بين الربان «النوخذة»، وهو الرجل الذي يتحكم في مصائر البحارة ويقودهم كما يحلو له ويستولي على تعبهم بهذه السيطرة وما يترتب عليها من نتائج نفسية، فيما نجد لدى البحارة تنامي الوعي بالرفض والتذمر وتنامي قدرتهم للتصدي لهذه السيطرة التي تقودهم الى الدمار. كما نلاحظ أن النوخذة يمثل الصراعات التي كانت موجودة ولا زالت موجودة وتتمثل في موقف طبقة معينة (القديمة) من التطور الرأسمالي. فالنوخذة كان يرغب في الاستفادة من اللآلئ للابتعاد عن البحر لتأسيس مؤسسة حديثة مرتبطة بالأحداث المستجدة في المجتمع.
الماضي والحاضر
■ إذا كان ذلك صحيحاً من الناحية النظرية. ما مدى انطباق ذلك على الرواية، خاصة اذا عرفنا ان فترة الغوص هي فترة قائمة بذاتها إلى حد كبير وفترة المجتمع الحديث هي الأخرى قائمة بذاتها، حيث أن الأولى قائمة على أساس علاقة السخرة والعبودية والفترة المعاصرة قائمة على أساس علاقات الإنتاج الرأسمالية، الا يعني ذلك اسقاطاً للماضي على الحاضر؟ أعتقد أن الفترتين الماضية والمعاصرة في البحرين وفي منطقة الخليج عموماً هما لحظتان في تطور واحد وفي تشكيلة اقتصادية اجتماعية واحدة وهما ليستا مبتورتين عن بعضهما البعض وإنما متداخلتان. أما بالنسبة للفن فان له قوانينه الخاصة غير المقطوعة عن القوانين العامة لتطور الحياة فالفن يمكن أن يناقش أي شيء يمكن ان يناقش المستقبل أو أن يكتب روايات خيالية ويمكن ان يكتب عن عصر الكهوف. ولكن المسألة هي في كيفية مناقشة أي موضوع وبطريقة تضيء الحياة المعاصرة. وهنا عندما نناقش الماضي بموضوعيته فإننا بطريقة ما نثير ذات الأسئلة وذات الموقف في الحياة المعاصرة. وبالتالي بالنسبة الي ككاتب لا يمكن أن أفهم الماضي إلا على ضوء قوانينه ولكن بارتباطه بالحاضر.
أعتقد أن الفترتين الماضية والمعاصرة في البحرين وفي منطقة الخليج عموماً هما لحظتان في تطور واحد وفي تشكيلة اقتصادية اجتماعية واحدة وهما ليستا مبتورتين عن بعضهما البعض وإنما متداخلتان. أما بالنسبة للفن فان له قوانينه الخاصة غير المقطوعة عن القوانين العامة لتطور الحياة فالفن يمكن أن يناقش أي شيء يمكن ان يناقش المستقبل أو أن يكتب روايات خيالية ويمكن ان يكتب عن عصر الكهوف. ولكن المسألة هي في كيفية مناقشة أي موضوع وبطريقة تضيء الحياة المعاصرة. وهنا عندما نناقش الماضي بموضوعيته فإننا بطريقة ما نثير ذات الأسئلة وذات الموقف في الحياة المعاصرة. وبالتالي بالنسبة الي ككاتب لا يمكن أن أفهم الماضي إلا على ضوء قوانينه ولكن بارتباطه بالحاضر.
■ ألا يعني هذا أن لفترة الغوص مشكلاتها الخاصة وللفترة المعاصرة النفطية مشكلاتها الخاصة التي تختلف عن الفترة السابقة؟ كما قلت فإن الفترتين متداخلتان إلا أنها متباينتان اذ ان الحقبة النفطية تشكل انعطافاً في التطور الاجتماعي وتشكل لحظة تاريخية واجتماعية مختلفة عن السابق لكنها ليست مقطوعة عن الماضي. هذه اللحظة لها سماتها الخاصة. والرواية لا تهتم بالقضايا الجزئية التكتيكية، وإما بالقضايا الكبيرة في التاريخ والكاتب يتناول القضايا الكبيرة مثل قضية التطور الاجتماعي إلى أين؟ مثلا…
كما قلت فإن الفترتين متداخلتان إلا أنها متباينتان اذ ان الحقبة النفطية تشكل انعطافاً في التطور الاجتماعي وتشكل لحظة تاريخية واجتماعية مختلفة عن السابق لكنها ليست مقطوعة عن الماضي. هذه اللحظة لها سماتها الخاصة. والرواية لا تهتم بالقضايا الجزئية التكتيكية، وإما بالقضايا الكبيرة في التاريخ والكاتب يتناول القضايا الكبيرة مثل قضية التطور الاجتماعي إلى أين؟ مثلا…
■ يقول جورج لوكاش «الرواية هي ملحمة بورجوازية» أو ملحمة المجتمع البرجوازي إلى أي مدى ينطبق هذا الكلام على الرواية في البحرين على الرغم من عمرها القصير نسبيا؟ بالنسبة للتعريف القائل بأن الرواية ملحمة البرجوازية أعتقد أنه يعني أنها ارتبطت بنشوء الطبقة البرجوازية. أما في الدول النامية فالأمر يختلف. فقد نشأت الرواية باعتبارها رواية وطنية. أي أنها تحاول ان تجسد ملامح شعب وطموحاته وحركته وتاريخه فهي بهذا المعنى ملحمة وطنية وتركز على الجوانب الديمقراطية بالمعنى البرجوازي. والرواية العربية وكذلك في بقية دول العالم الثالث ارتبطت بالتخلص من الاستعمار والتصدي له. وهذا ينطبق على البحرين والخليج بوجه عام. فقد نشأت الرواية كمحاولة لاكتشاف هذه الناحية مثل رواية «الشاهندة» في الإمارات وكذلك بعض الروايات التي تناولت تطور المدينة في الخليج من قرية صيادين الى مدينة كبيرة الى مدينة استهلاكية نفطية. ولكن المسألة أيضاً تتعلق بمدى رؤية الكاتب وقدرته على الربط بين هذه التحولات في المجتمع والشخصيات والأحداث في الرواية. في البحرين كان يوجد اهتمام بمعالجة رواية «الحصار» لفوزية رشيد والتي تناولت حقبة السبعينات وتتحدث عن مجموعة من المناضلين من أجل التغيير داخل وخارج السجن. وهذا في رأي محاولة لاكتشاف الواقع من خلال نمو الرواية واستبصار القضايا الاساسية وكذلك بالنسبة للادوات الفنية فهي ما زالت في البداية.
بالنسبة للتعريف القائل بأن الرواية ملحمة البرجوازية أعتقد أنه يعني أنها ارتبطت بنشوء الطبقة البرجوازية. أما في الدول النامية فالأمر يختلف. فقد نشأت الرواية باعتبارها رواية وطنية. أي أنها تحاول ان تجسد ملامح شعب وطموحاته وحركته وتاريخه فهي بهذا المعنى ملحمة وطنية وتركز على الجوانب الديمقراطية بالمعنى البرجوازي. والرواية العربية وكذلك في بقية دول العالم الثالث ارتبطت بالتخلص من الاستعمار والتصدي له. وهذا ينطبق على البحرين والخليج بوجه عام. فقد نشأت الرواية كمحاولة لاكتشاف هذه الناحية مثل رواية «الشاهندة» في الإمارات وكذلك بعض الروايات التي تناولت تطور المدينة في الخليج من قرية صيادين الى مدينة كبيرة الى مدينة استهلاكية نفطية. ولكن المسألة أيضاً تتعلق بمدى رؤية الكاتب وقدرته على الربط بين هذه التحولات في المجتمع والشخصيات والأحداث في الرواية. في البحرين كان يوجد اهتمام بمعالجة رواية «الحصار» لفوزية رشيد والتي تناولت حقبة السبعينات وتتحدث عن مجموعة من المناضلين من أجل التغيير داخل وخارج السجن. وهذا في رأي محاولة لاكتشاف الواقع من خلال نمو الرواية واستبصار القضايا الاساسية وكذلك بالنسبة للادوات الفنية فهي ما زالت في البداية.
نلاحظ ذلك من خلال بعض الروايات التي تتسم بالشعرية المكثفة جدا والغموض والتجريبية. فمثلاً نجد رواية امين صالح «اغنية ا – ص الاولى» تتجه اتجاهاً سريالياً، وهناك نماذج كثيرة.
من البحرين الى الخليج
■ ماهو موقع الرواية في البحرين بين الأدب العربي في الخليج، خصوصاً وان هناك كتاب روايات امثال اسماعيل فهد اسماعيل وليلى العثمان في الكويت؟ يمثل كل من اسماعيل فهد اسماعيل وليلى العثمان نضجا قصصيا مهما في الكويت والمنطقة.
يمثل كل من اسماعيل فهد اسماعيل وليلى العثمان نضجا قصصيا مهما في الكويت والمنطقة.
ولاسماعيل العديد من الإبداعات الروائية والنقدية والقصصية وتمثل إضافة مهمة. الا ان اغلب رواياته تناقش قضايا عربية شمولية أكثر منها محلية، كتطور المجتمع العراقي. ورباعيته اهتمت بالتاريخ العراقي في حين أن رواية «النيل يجري شمالا» تناقش فترة حكم مصر ايام نابليون. أما ليلى العثمان فقد اهتمت بقضايا المجتمع في الخليج ولديها روايتان تعالجان الحياة في الكويت ماضياً وحاضراً لماذا ذلك؟ لأن الجيل الحالي لا بد وأن يعالج الماضي باعتبار ان اقدامه ما زالت قائمة في الفترة السابقة. أما في بقية الخليج فيوجد تطورات خاصة في الإمارات العربية المتحدة التي فيها محاولات وكتابات قصصية وروائية تبشر بكثير من العطاء. ولدينا كتاب مثل علي أبوالريش ومحمد الحربي. (أنظر الدراسة المطولة عن الرواية بين الإمارات والكويت لـ عبدالله خليفة) أما في البحرين فهي تمتاز باهتمامها بالبناء الفني المتماسك وبالقضايا العميقة للتطور الاجتماعي خاصة بالصراعات الطبقية وهذا الاهتمام أيضاً يتعلق بالفكر والتطور الإبداعي وهو نتاج التطور الخاص بالبنية الاجتماعية. ومن هنا جاءت القصة القصيرة وخاصة الرواية زاخرة بهذه الصراعات وذات بعد طوري ربما أكثر من بعض الدول العربية في الخليج.
■ ذكرت أن الرواية في طور التكوين، أين موقع النقد في الرواية؟ من المعروف أن النقد قد سبق الرواية ولدينا العديد من الكتابات والمحاولات النقدية السابقة على الرواية التي حاولت أن تؤصل التطور القصصي والفكري في البحرين مثل كتاب الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم حول القصة القصيرة في الكويت والبحرين، لدينا أيضاً كتابات علوي الهاشمي وخاصة في مجال الشعر في كتابه ما قالته النخلة للبحر. ولدينا كتاب آخرون أمثال يوسف الحمدان في مجال النقد المسرحي ويوسف يتيم.
من المعروف أن النقد قد سبق الرواية ولدينا العديد من الكتابات والمحاولات النقدية السابقة على الرواية التي حاولت أن تؤصل التطور القصصي والفكري في البحرين مثل كتاب الدكتور إبراهيم عبدالله غلوم حول القصة القصيرة في الكويت والبحرين، لدينا أيضاً كتابات علوي الهاشمي وخاصة في مجال الشعر في كتابه ما قالته النخلة للبحر. ولدينا كتاب آخرون أمثال يوسف الحمدان في مجال النقد المسرحي ويوسف يتيم.
وقد لعب النقد دوراً تحفيزياً في نمو العمل الإبداعي. وما كتبه ابراهيم غلوم بالنسبة للقصة القصيرة هو محاولة فيها الكثير من الجوانب المفيدة والمضيئة للتطور التاريخي للقصة في الخليج والبحرين وهذه المحاولات حاولت أن تربط حلقات متعددة في الأربعينات والخمسينات والستينات، وادت الى الاهتمام بكتابة القصة القصيرة.
والملاحظ أن الرواية نمت عبر كتاب القصة القصيرة هذا فضلا عن اختلافها عن النقد الأدبي، لأن لها مسارها الخاص وعندما نلاحظ قصص الستينات نجد أنها اهتمت بجوانب عديدة ومهمة خاصة ما كتبه القاص محمد عبدالملك في مجموعتيه «نحن نحب الشمس» و«موت صاحب العربة» حيث نلاحظ قصصاً قصيرة بانورامية تتناول نماذج مختلفة من المهشمين والمحطمين من البشر ومحاولات الناس لتغيير هذا الواقع.
وعلى أعتاب هذه القصص القصيرة ظهرت الرواية، وفي مجال النقد يمكننا ملاحظة أنه قد لعب دورا كبيرا في اكتشاف لحظات تطور القصة. وفي هذا السياق وجد بعض الكتاب الذين كانوا ضد الكتابات النقدية الواقعية الموجودة على الساحة في البحرين. وينظر الى الكتابات التي تتسم بالشكلانية المفصولة عن هموم الانسان احياناً باعتبارها إنجازاً كبيراً.
ومن هنا فإن عدم وجود نقد واقعي يستطيع ان يكتشف الأدب في تطوره الفني والاجتماعي أوجد ثغرة وبالتالي تكرس لدينا نقد يهتم بالجوانب الفنية المفصولة عن الحياة كما أن هذه المحاولات النقدية غير دقيقة. وقد ادى ذلك الى نوع من الاهتمام بالكتاب الآخرين والى محاولة اكتشاف جوانب عديدة أخرى من العملية الإبداعية والأدبية فعندما يرى الناقد ابراهيم غلوم بأن «كتابات القاص محمد عبدالملك هي واقعية نقدية لكنه يبتعد عن الواقعية النقدية في «قوس قزح» يخطىء لأن هذه القصة هي في رأيي أكثر اقتراباً من الواقعية من القصص الأخرى. والمعروف ان هذه القصة قد ترجمت الى الفرنسية.
■ باعتبارك ناقداً أيضاً، يلاحظ ان الحياة الثقافية في البحرين تعج بالكثير من المستويات الابداعية، ضمن هذه المستويات يوجد تباينات في المنظور وفي وجهات النظر ما هو تقييمك للحركة الثقافية البحرينية بشكل عام؟ الحركة الثقافية فى البحرين على مدى 20 سنة الأخيرة توزعت بين فترتين زمنيتين: فترة الستينات الأولى أو فترة الأزمة الاجتماعية، حيث كانت الأوضاع أكثر إحتداماً بالصراعات الاجتماعية. وكانت الثقافة والحركة الأدبية خصوصاً جزءاً من هذه الحركة الاجتماعية الضاغطة والمهتمة بتغيير الحياة. فالحركة الأدبية انبثقت آنذاك من الصراعات التي كانت قائمة وعبرت مختلف المستويات الابداعية عن هذا الصراع، والقصة القصيرة والشعر والمسرحية كانت تمثل أكثر أشكال الأدب حضوراً خلال هذه الفترة كما كانت تمثل وعياً طليعياً بالنسبة للمجتمع حينذاك.
الحركة الثقافية فى البحرين على مدى 20 سنة الأخيرة توزعت بين فترتين زمنيتين: فترة الستينات الأولى أو فترة الأزمة الاجتماعية، حيث كانت الأوضاع أكثر إحتداماً بالصراعات الاجتماعية. وكانت الثقافة والحركة الأدبية خصوصاً جزءاً من هذه الحركة الاجتماعية الضاغطة والمهتمة بتغيير الحياة. فالحركة الأدبية انبثقت آنذاك من الصراعات التي كانت قائمة وعبرت مختلف المستويات الابداعية عن هذا الصراع، والقصة القصيرة والشعر والمسرحية كانت تمثل أكثر أشكال الأدب حضوراً خلال هذه الفترة كما كانت تمثل وعياً طليعياً بالنسبة للمجتمع حينذاك.
ثم جاءت المرحلة اللاحقة (النفطية). في ظل هذه الوضعية نمت الفئات الوسطى وازدادت العمالة الأجنبية وقلت الأيدي العاملة الوطنية في القطاعات الإنتاجية وظهرت الطفيلية، ونزعة التسلط. وكل ذلك انعكس على الحركة الثقافية والادبية، لذلك نلاحظ القليل من الأدب الذي يحاول أن يضيء للناس ويطور أدواته الفنية، في الوقت الذي يوجد قسم آخر من الأدب يتقوقع في شرنقته مهتما بالغرائبية أو بجوانب معينة فنية مبتورة عن الواقع و الجوانب الجوهرية في الحياة.
وهذا يعنى تهميشاً للأدب كما أن هناك اعمالاً فنية أخرى ذات إسفاف مهتمة بجوانب هامشية. وحقيقة الأمر أن التطور الفني والادبي يواجه مأزقاً ويعود إلى ظهور الطفيلية ارتفاع المداخيل الفردية الذي أدى إلى ابتعاد كثير من الجمهور عن الثقافة والأدب، والاتجاه الى الفنون السوقية والمبتذلة وهنا نواجه مشكلة علاقة الأدب بالجمهور اضافة الى ذلك أدت هذه الحالة إلى خلل في العلاقة بين الكتاب والجمهور.
الواقع وانعكاسه
■ يقال ان الثقافة انعكاس للواقع، إلى أي مدى يمكن اعتبار ذلك الانعكاس صحيحاً للثقافة عموماً والأدب خصوصاً؟ لا بد من الاشارة الى ان مفهوم الانعكاس يفهم أحياناً بشكل خاطئ وعلى أنه انعكاس مرآوي. والمشكلات التي تعبر عن التخلف ليس من الضروري أن تنعكس في الثقافة. ولربما يكون الأدب أكثر تقدماً من الواقع فعلى سبيل المثال نجد أن روسيا القيصرية كانت أكثر تخلفاً مقارنة بالدول الاوروبية الرأسمالية الا انها من الناحية الثقافية والادبية كانت أكثر تقدماً من بقية الدول وخاصة في مجال الأدب الواقعي والإنساني الذي اتسم بقدرة كبيرة على التحرر الروحي. وهذا معناه أن الناس فى فترة معينة وفي غمرة المشكلات الكبرى وفى فترات التمزق يتطلعون إلى آفاق أبعد ويتجاوزون الأنظمة القائمة التي تعيق تطلعاتهم وتقدمهم الثقافي والروحي، وهنا بالضبط يلعب الأدب دوره في عملية التجاوز وينسف الأنظمة الاجتماعية المتخلفة ويصل بالناس إلى آفاق أكثر تقدماً ورحابة ويهيئهم لتغييرات روحية ثقافية واجتماعية.
لا بد من الاشارة الى ان مفهوم الانعكاس يفهم أحياناً بشكل خاطئ وعلى أنه انعكاس مرآوي. والمشكلات التي تعبر عن التخلف ليس من الضروري أن تنعكس في الثقافة. ولربما يكون الأدب أكثر تقدماً من الواقع فعلى سبيل المثال نجد أن روسيا القيصرية كانت أكثر تخلفاً مقارنة بالدول الاوروبية الرأسمالية الا انها من الناحية الثقافية والادبية كانت أكثر تقدماً من بقية الدول وخاصة في مجال الأدب الواقعي والإنساني الذي اتسم بقدرة كبيرة على التحرر الروحي. وهذا معناه أن الناس فى فترة معينة وفي غمرة المشكلات الكبرى وفى فترات التمزق يتطلعون إلى آفاق أبعد ويتجاوزون الأنظمة القائمة التي تعيق تطلعاتهم وتقدمهم الثقافي والروحي، وهنا بالضبط يلعب الأدب دوره في عملية التجاوز وينسف الأنظمة الاجتماعية المتخلفة ويصل بالناس إلى آفاق أكثر تقدماً ورحابة ويهيئهم لتغييرات روحية ثقافية واجتماعية.
■ هل بإمكان الأدب أن يحدث تغييرات سياسية جذرية؟ بالطبع لا. الأدب غير قادر على ذلك ولكنه قادر على أن يحضر تحضيراً عميقاً لروحية الإنسان من أجل التغيير بمعنى أنه يهيئ الأرضية لارتباطه بالاجابة عن الأسئلة الكبرى. وعندما يتأثر الناس بهذا الأدب الحقيقي يتحول هذا التأثير إلى قوة جماهيرية تساهم في تغيير الحياة.
بالطبع لا. الأدب غير قادر على ذلك ولكنه قادر على أن يحضر تحضيراً عميقاً لروحية الإنسان من أجل التغيير بمعنى أنه يهيئ الأرضية لارتباطه بالاجابة عن الأسئلة الكبرى. وعندما يتأثر الناس بهذا الأدب الحقيقي يتحول هذا التأثير إلى قوة جماهيرية تساهم في تغيير الحياة.
والأدب هو رافد من روافد الحقيقة التي تمهد للتغير فمثلا شكسبير لم يحطم نظاماً اجتماعياً ولكن مسرحياته بقيت زادا مهما للبشرية تنهل منه بسبب معالجاته للقضايا الكبرى لدى الإنسان.
وفي البحرين أو الخليج نجد أن الأدب الذي يساهم في التحولات غير موجود. الا ان هناك بذورا أو جوانب مهمة تؤثر على فئات من الناس وفي مدى السنوات القادمة سوف تتسع عملية التأثير أما في لحظتنا الراهنة فنلاحظ أن الموجات الارتدادية والسلفية والمتخلفة هي التي تحاول أن تظهر على السطح وان تعرقل النمو الروحي والتطور الاجتماعي. وهذا ما نشاهده من انحسار للأدب وظهور حوانيت صغيرة تدعي الأدب وعدم اهتمام وسائل الإعلام بالأدب حقى ان الكتّاب يعانون من صعوبات الحصول على لقمة العيش وكذلك المثقفون.
■ ولكن الفترات الصعبة التي تمر بها الشعوب كثيراً ما تكون دافعاً لظهور كتاب عظماء لماذا لا يوجد لدينا كذلك؟ لا شك أن كبار الكتَّاب يحتاجون الى مواهب كبيرة وان التطور الاجتماعي يساهم في ظهور مثل هذه المواهب كما أن المواهب الكبيرة ليست منفصلة عن التطور الاجتماعي ومثال على ذلك أن الكاتب الروسي دوستويفسكي لم يكن بالامكان ان يظهر في القرن 18 ولكنه ظهر في القرن 19 وهذا يعود لأسباب تطورية اقتصادية واجتماعية وثقافية تراكمت لتهيئة الجو المناسب لظهور مثل هذه الموهة لابداع الروائع التي ابدعها. وينطبق نفس الأمر على شكسبير، الشروط الموضوعية تلعب دوراً لخلق مثل هؤلاء الكتاب بالإضافة إلى الجوانب التراثية المتمثلة في الأبعاد النفسية والقدرات والجوانب الفكرية. اما في الخليج فإن التطور التاريخي لا يتجاوز 20 أو 30 سنة فقبل عشرين سنة كان التخلف يضرب بجذوره عميقاً في المجتمع، الأمية، الأكواخ، الفقر، المرض، في ظل هذه الوضعية كيف يمكن أن يظهر كاتب عظيم؟ ومع ذلك نجد الجانب الآخر إن البحرين، وخلال عشرين سنة، استطاعت أن تقوم بنهضة أدبية وفنية كبيرة وانطلاقاً من الصفر الى القصة القصيرة الى القصيدة الحديثة والروايات المتعددة.
لا شك أن كبار الكتَّاب يحتاجون الى مواهب كبيرة وان التطور الاجتماعي يساهم في ظهور مثل هذه المواهب كما أن المواهب الكبيرة ليست منفصلة عن التطور الاجتماعي ومثال على ذلك أن الكاتب الروسي دوستويفسكي لم يكن بالامكان ان يظهر في القرن 18 ولكنه ظهر في القرن 19 وهذا يعود لأسباب تطورية اقتصادية واجتماعية وثقافية تراكمت لتهيئة الجو المناسب لظهور مثل هذه الموهة لابداع الروائع التي ابدعها. وينطبق نفس الأمر على شكسبير، الشروط الموضوعية تلعب دوراً لخلق مثل هؤلاء الكتاب بالإضافة إلى الجوانب التراثية المتمثلة في الأبعاد النفسية والقدرات والجوانب الفكرية. اما في الخليج فإن التطور التاريخي لا يتجاوز 20 أو 30 سنة فقبل عشرين سنة كان التخلف يضرب بجذوره عميقاً في المجتمع، الأمية، الأكواخ، الفقر، المرض، في ظل هذه الوضعية كيف يمكن أن يظهر كاتب عظيم؟ ومع ذلك نجد الجانب الآخر إن البحرين، وخلال عشرين سنة، استطاعت أن تقوم بنهضة أدبية وفنية كبيرة وانطلاقاً من الصفر الى القصة القصيرة الى القصيدة الحديثة والروايات المتعددة.
حتى اننا وجدنا انفسنا ننافس بعض الدول العربية كاليمن أو الاردن وعلى الرغم من صغر حجم البحرين سكاناً ومساحة، يظهر لدينا شعراء وقصاصون مهمون على مستوى الوطن العربي. وان نخلق مسرحاً ونقداً ورواية في ظل هذه الظروف الصعبة، انجاز هام جدا الا أنه لا يكفي. كما أن غير المنشور من الابداعات كثير فلديّ مثلا روايتان غير منشورتين ومجموعة قصصية غير منشورة وكتابان نقديان غير منشورين. وهذا يعود للظروف المحيطة في منطقة اتجهت للبذخ والترف والابتعاد عن الثقافة وأيضا الى صعوبة حياة الأدباء والأدب.
■ هل الأدب الجيد هو بالضرورة أدب جماهيري؟ ليس بالضرورة لأنه في فترة محددة لا يستطيع الأديب أن يكون جاهيرياً. وهذا مرتبط بعادات المتلقين والقراء وربما لأنهم يتجهون لأنواع فنية اخرى قد تكون مبتذلة. والكاتب الجيد لا يستطيع الوصول الى هؤلاء الناس. اضافة الى ذلك هناك قدرة الكاتب على توصيل ادبه. إذ يوجد كتاب يستطيعون بأدبهم العميق أن يكونوا جماهيريين ومن هؤلاء حنا مينة بسبب قدرته على التوصيل وتجسيد رواياته بطرق مقبولة من الجمهور.
ليس بالضرورة لأنه في فترة محددة لا يستطيع الأديب أن يكون جاهيرياً. وهذا مرتبط بعادات المتلقين والقراء وربما لأنهم يتجهون لأنواع فنية اخرى قد تكون مبتذلة. والكاتب الجيد لا يستطيع الوصول الى هؤلاء الناس. اضافة الى ذلك هناك قدرة الكاتب على توصيل ادبه. إذ يوجد كتاب يستطيعون بأدبهم العميق أن يكونوا جماهيريين ومن هؤلاء حنا مينة بسبب قدرته على التوصيل وتجسيد رواياته بطرق مقبولة من الجمهور.
وفي جانب آخر نجد كتاب مرموقين لكنهم يفتقرون للجماهيرية وهذا يعود الى طريقة تجسيدهم لابداعاتهم. فمثلاً ماياكوفسكي في الثلاثينات لم يكن جماهيرياً. والمعروف أن أذواق الجمهور حينذاك كانت من نمط جمالي معين. ومع تطور الابداع والذوق الجمالي اتسع بالتالي تذوق ماياكوفسكي. الجماهيرية ليست بالضرورة مقياساً للجودة، فالقصة البوليسية من أكثر الروايات رواجاً. الا ان الاديب الجيد هو من يحاول ان يوفق بين المضمون العميق لما يكتب وبين الشكل المعبر والموصل ولا يوجد تناقض بين جماهيرية الأدب وجودته.
■ ما المقصود بالجمهور؟ يتحدد الجمهور كما يتحدد الأدب بارتباطه بالتطور التاريخي والاجتماعي وإلى أي درجة من التطور وصل هذا المجتمع. وما هي درجة الأمية إضافة إلى التربية الجمالية للناس ضمن المجتمع وكذلك درجة الوعي ودرجة الصراعات وقضايا النضال السياسى، كل هذه الأمور تؤثر بهذا القدر أو ذاك على خلق جماهير الشعر.
يتحدد الجمهور كما يتحدد الأدب بارتباطه بالتطور التاريخي والاجتماعي وإلى أي درجة من التطور وصل هذا المجتمع. وما هي درجة الأمية إضافة إلى التربية الجمالية للناس ضمن المجتمع وكذلك درجة الوعي ودرجة الصراعات وقضايا النضال السياسى، كل هذه الأمور تؤثر بهذا القدر أو ذاك على خلق جماهير الشعر.
■ ما هو جديدك القادم؟ كما قلت لك لديّ روايتان ومجموعة قصصية ومسرحية وكتابان نقديان أحدهما يتناول كاتباً محدداً إو يعالج تطوره الابداعي وقضاياه وبشكل مكثف ويربطه بمختلف جوانب الحياة اجتماعياً وثقافياً. وكل هذه الكتب جاهزة للنشر…
كما قلت لك لديّ روايتان ومجموعة قصصية ومسرحية وكتابان نقديان أحدهما يتناول كاتباً محدداً إو يعالج تطوره الابداعي وقضاياه وبشكل مكثف ويربطه بمختلف جوانب الحياة اجتماعياً وثقافياً. وكل هذه الكتب جاهزة للنشر…



