عبدالله خليفة الأعمال الروائية والقصصية والتاريخية والنقدية الكاملة
كلمات الاغلفة للاعمال الكاملة


كلمة الغلاف الخلفي لكتاب الجزء الثالث الأعمال الروائيــة
الرواية عند عبدالله خليفة تنطلق من الماضي وتذوب في أطيافه، تمتزج بالواقعية، وتتمادى في تعقيد حبكتها الروائية، تؤسس لحياة غابرة بقلم الحاضر، تستدعي شخوصها وأمكنتها بتاريخ هذا اليوم وتحاول عبر عالمها الروائي أن تشيد الزمن برؤى الحاضر، تحكي بصوت الراوي المنفرد أصواتاً مختلفة وتعبر عوالم لا منتهية، عوالم البشر والطبيعة، عوالم الزمن والمكان الذي يشتغل برمزيته على الأحداث ويؤطرها وفق فترة زمنية وحقبة تحكي بشخوصها وملامحها ملامح عصر ربما عفت عليه الأيام لكنه يعيد تشكيل ذاته من جديد وبشكل مغاير يختلف بطريقة ما عن سابقه ولكنه يعتصر من الماضي مقومات حضوره.
هكذا كانت هي رواية «الأقلف» لــ عبدالله خليفة رؤية تسرد حكاية من لا يعرف لذاته طريقاً، ومن يجهل ملامح صورته ومن يسأل عن جذور هويته ولكن لا سبيل للوصول فالحقيقة تظل سراباً والواقع أكبر من ان نفهمه.
من أنا؟ ومن أكون؟ ما هي ديانتي وهويتي؟ أسئلة كثيرة في حياة «يحيى» فالوطن والحب والأثنية ثلاثي أنتج قلقة مبعثرة هادئة لكنها صاخبة، مسالمة لكنها قوية، حالمة لكنها مستاءة وحزينة، رواية من لا يعرف لذته طريقاً ومن لا يجد لأسئلته مجيباً ومن لا يكف عن البحث عن السكون إشكالية الوجود وعبر إشكالية الذات تتمحور إرهاصات الحياة وتبرز ثنايا النفس وعيوبها..
على مساحة واسعة عمقاً وسطحاً يجمع عبدالله خليفة عُقَد الخيوط بيديه، يشدها، يمَّدها، أو يُرخيها، بامتداد فضاءات حكائية سردية مترامية، تشبه إلى حد كبير القصيدة الملحمية المطوَّلة، أو النشيد البطولي الاسطوري، حيث تتوالي وتتقاطع وتلتحم، تلك الفصول كحبات المسبحة كما تترى وتائر الوقائع والأحداث والناس والشخوص، وتحتدم الصراعات وتتضارب المصالح والطموحات والغايات.
وفي ثلاثيته الينابيع، وفي غيرها من رواياته العديدة، التي تعتبر منجزاً وطنياً إبداعياً، ولعله الوحيد الذي يحسب له كتابة تاريخ البحرين الحديث «روائياً» في ثلاثيته «ينابيع البحرين» التي ستظل مرجعاً تأصيلياً مهماً لتاريخ البحرين والرواية السردية على السواء.

كلمة الغلاف الخارجي للاعمال التاريخية
إنها غوصٌ حميمٌ غنائي سردي في شخصيةِ النبي محمد، نبي الإسلام، حيث تتجسدُ البطولةُ في المفرداتِ الإنسانيةِ الطفوليةِ الأولى، وتنمو بشكلٍ درامي صدامي مع الواقعِ والآخرين، في نأيهِ عن عبادةِ الأحجار والتحامه بالمغمورين من البشر، وببذور المعرفة والنضال، وفي تساؤلاتهِ وبحثهِ عن طريقٍ متحضرٍ لجماعةٍ غارقةٍ في التخلفِ والتمزق.
هي لحظاتهُ الدراميةُ المتفجرةُ وثورته.
هي روايةُ محمد الإنسان، في حبهِ لخديجة، ونمو علاقتِهما وسط الوثنيين، المعادين، وفي عملِهما المشتركِ المضني المتصاعد.
ويتجسدُ من جهةٍ مضادةٍ الوثني الأناني الإستغلالي المتخلف، الذي يريدُ كرسياً وملكاً فوقَ رقابِ البشر، ويستعينُ بكلِ شيءٍ لوقفِ التقدمِ والحرية ودولة الجمهور.
محمد ثائراً
تعتدلُ الأسواقُ حين يمر.
يتطلعُ الباعةُ إلى موازينهم جيداً. تعتدلُ الأسعارُ ويتجرأ الفقراءُ، ويحترمُ الرجالُ نساءهم، ويختبئ اللصوصُ والدجالون في أوكارهم، وتزهرُ غيومُ العصافير على الشجر، وتتدفق كتبُ الأمصار بأخطاء الولاة، فيندفع رجالٌ على خيولهم أو أبلهم لا توقفهم الصحارى والسيول والذئاب والصعاليك والأمراء، يقتحمون أبوابَ الإمارات العالية، وينزعون سياطَ الحراس ويحررون الخدمَ من الأحباس، ويسحبون الولاة للمحاكم والأسواق، ويعرضونهم لصفعات الناس ، وكلماتهم القاسية..
يقحمون رؤوسَهم في خزائنهم، يدققون في الأرقام والمعادن النفسية، والرخيصة، يأخذون الكثيرَ وينثرونه على المساكين، ويتطلع أؤلئكَ الفقراءُ في أزقتهم المعتمة لهؤلاء البدو الغرباء ذوي الثياب الرثة، يحولون النقدَ الثمين مثل مطر مضيء رخيص ينهمرُ على العشش.
يرون أبوابَ الولاة الثمينة تـُهدمُ وتنفتحُ دارُ الإمارة للمتسولين والنساء والمجلودين في الحقول والمسروقين في أهراء القمح، وتتكاثر الحشودُ على الولاة.
حين يظهر عمرُ بدرتهِ في الطرقاتِ والأسواق والحارات، يختفي المتسولون وباعةُ الغش، وتمشي النساء باحترام، وترتاح حيواناتُ الحمل من صناديق ثقيلة وأحمال متعبة، ويوقف المتحدثون خطبهم الطويلة عن الفضيلة، ويتجه الرجالُ للحقول ويتركون مجالس الثرثرة.
ويبعث الحطابون والمزارعون والنساء والعراةُ من وراء الصحارى بخطاباتهم لأمير المؤمنين ينتقدونه على عدم عنايته بهم، ويتطلع بعضُ الصحابة في الرسائل بغضب، في حين يدقق فيها عمر، ويسألُ، ويكتبُ، ويرسل رجالاً مصنوعين من عظام الفضيلة والجرأة السميكة، يقتحمون مخادعَ الولاة النائمين ويجرجرونهم عن المحظيات، ويعرضونهم لسياط العامة، ويستبدلونهم برجالٍ آخرين من التراب، ويحملون خزائنهم ويلقونها في بيت المال، حيث حشدٌ من العبيد والخدم السابقين، حراساً غلاظاً على كل درهم.
عمر بن الخطاب شهيداً
من رأى عهداً للحب والحنو والمساعدة مثل عهدي؟ اسألوا الأباطرة الذين رحلوا ووسعوا المقابر، اسألوا الغاضبين الذين قُتلوا! انظروا العاصمة التي تخلو من الحرس والشرطة والمشعوذين والمخبرين والشحاذين! ولكن بعض النفوس الصغيرة لا تحبني، يريد لكل هؤلاء الفقراء أن يزهدوا في الدنيا بل لا بد أن يفرحوا ويأكلوا في الموائد العامرة، وينتشوا بالحياة!
عثمان بن عفان شهيداً
تنامُ العيونُ وتهجعُ الأجسادُ، وهو لا ينامُ ولا يستريحُ، في الأزقةِ المتربةِ، في خيامِ القادمين من الأمصار، في الأسواقِ الناعسةِ والضاجةِ بالصراخ، يرونه..
اسمهُ مثل عاصفةٍ على الأشرار، يسترخي الفلاحون تحت الأشجار، وترتاح حيواناتُ الجر، وتتوقف الفوائدُ المجحفة، وتقلُ الأرباحُ النهمةُ، وتسالمُ جيوشُ الفتوحِ السكانَ والزرعَ، وتغمغمُ القصورُ والبيوتُ الكبيرة بالشكوى.
يوجهُ الرسلَ والأمراءَ والدعاة:
يتأملُ الليلَ والنهارَ، ويغسلُ بيتَ المال من أثر الذهب والفضة، ويجلسُ ليأكلَ وجبتَهُ الشحيحة.
يتساءلُ: هل سيتركونني أعملُ ونقفز على مستنقعات الدم؟
هل سوف ينسى كبارُ رجالات قريش الماضي والكراسي؟!
علي بن أبي طالب شهيداً تتوجه هذه الرواية بأسلوبٍ عصري مختلف لحدثٍ تاريخي شهير.
إن مأساة الحسين تتحول هنا إلى حراك شعبي واسع مع غياب جسد الحسين نفسه.
فالرأس التي تُحملُ على أسنة الرماح نحو مقر الخلافة حيث زعامة القهر تحرك الجمهور ليقرأ واقعه الذليل، وتحملُ هذه الرأسَ عدة شخصيات، وتدخل مدناً، وتلتحم بمنولوجات شخصية وحوادث فردية وجماعية، حتى تتشكل دائرة واسعة من الأحداث والصراعات والحوارات.
لكن الرواية كفنٍّ عصري لا تكتفي بعالم من الأحداث التاريخية الحقيقية، بل تمزجها بخيال فني، يوسع من تغلغلها في الشخصيات التاريخية المحورية، فتوجدُ الشخصية الشعبية المتحولة كمحور كبير، فيتمازج المتخيل بالحقيقي، وما هو شعبي كفاحي متوارٍ يغدو في مقدمة اللوحة، وما هو تاريخي فوتوغرافي يتراجع للوراء ليكون خلفية الرواية، ليتغلب الشعري على النثري، وتغدو الرواية جزءً من ملحمة الصراع في بداية التاريخ الإسلامي.
إن تراجيديا التاريخ الإسلامي تتحقق هنا على صعيد الرواية كحوارات صراعية بين شخصياتها المحورية.
إنه عمل روائي من نوع جديد.
الحسين شهيداً

كلمة الغلاف الجزء الخامس
تمثلُ الأنواعُ الأدبية والفنية قضايا جوهرية في الأدب، فهي تعبرُ عن قدراتِ شعبٍ أو أمةٍ ما على التطور الثقافي على مدى قرون، فليستْ هي بناءاتٌ شكلانية تُرصفُ الكلامَ وتجمعُ المعاني في «قوالب» لكنها تعبيرٌ عن قدراتِ المبدعين والنقاد على الحراكِ التحويلي لمجتمعاتِهم، أي على مدى تمكنهم من إقامة علاقاتٍ عميقةٍ مع البشر وجذورهم الدينية والثقافية والاجتماعية وتغييرها تبعاً لخُطى التقدم، ومجابهة قوى التخلف والاستغلال والتهميش للناس، وتصعيد القدرات على الحوارِ والبحث والتجديد.
أي هو التحولُ من هيمنةِ الصوتِ الواحد إلى تعدديةِ الأصوات، ومن سيادةِ الأنا المركزيةِ الاجتماعية إلى تنوع الأفراد وقدرتهم على الحوار والنقد والتغيير.
وإذا كانت صناعة الأنواعِ الأدبية تخضعُ للأفعال الحرة للمبدعين فإنها لا تستطيع أن تقفزَ على الظروف الموضوعيةِ للواقع والناس. وهيمنةُ نوعٍ أو وجود الأنواع كافة هي قضيةٌ مركبةٌ من الذاتي والموضوعي، من سيطرةِ قيودٍ تعبيرية قَبْليةٍ ومن مساهماتٍ تحريرية لنزعِ تلك القيود، من آفاقٍ مرصودةٍ سلفاً نتاج سابقين ومن قدرةِ المعاصرين على تغييرِها تَبِعاً لتطورِ الحياة والمساهمة في تغييرها.
والمبدعون يظهرون في شروطٍ سابقةٍ على إبداعهم، إنها تقيدُهم وتجعلُهم يعيدون إنتاجَ الماضي الثقافي أو يضيفون عليه بعضَ الإضافات اليسيرة والمهمة غير التحويلية الواسعة.
ومن هنا فظهور الشعراء في عالم العرب الجاهلي يختلف عن ظروف أخرى تالية حين حدثت نهضة، فسيطرةُ الصحراءِ والحياةِ الرعوية، هي غيرُ ظهورِ المدنِ وميلادِ دولةٍ إسلامية واسعةٍ تختلطُ فيها الشعوب.
لكن ان تبقى الهياكلُ الإبداعية الجاهلية في عمقِ المدن وتسيطرَ على الإنتاج فهي أيضاً هيمنة قَبْلية مستمرة.
وقد طُرحتْ بقوةٍ مسألة قصورِ الأنواعِ الأدبية والفنية على نوعٍ واحد بشكلٍ كبيرٍ هو النوع الشعري، وضمور النوعين الآخرين وهما النوعان الملحمي والدرامي، كما هو غيابُ الأنواع الفنية، وهي قضية ليست تجريدية بل قضية تاريخية واجتماعية وفكرية طويلة ومعقدة.
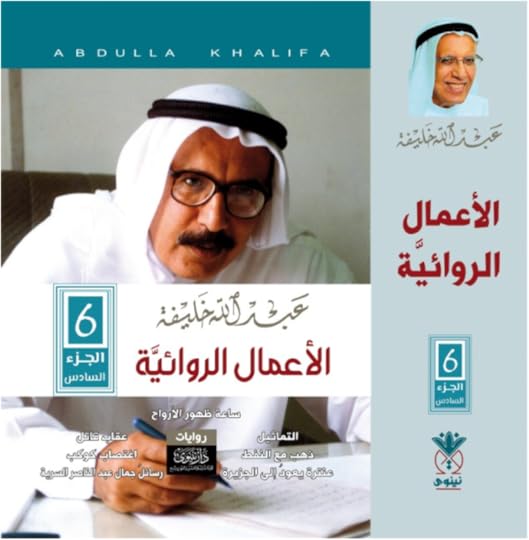
كلمة الغلاف الجزء السادس
تنتمي رواية «ساعة ظهور الأرواح» لـعبدالله خليفة إلى النوع الروائي الذي لا يهادن ما اتفق عليه في القراءة، ويعود الأمر إلى تركيبته البنائية التي تجعل النص تجربة تخييلية تعيش حالات مستمرة ومتنوعة من التطور التقني والإجرائي والأسلوبي والمعرفي، مما يجعلها منفتحة على الإيحاء في أبعاده المنتجة للتعدد والتنوع في التأويل.
…………….

 …………….
…………….
في لغة تفاعلية بين الفكرة والصورة، وبين الصوت السياسي الاجتماعي، والتأليف الجمالي الشعري، يسعى الكاتب عبدالله خليفة لإرساء بناء روائي لا ينقطع عن إحالاته الواقعية والتاريخية. فمناط الكاتب في رواية «التماثيل» كما فيما سلف من رواياته، قضايا اجتماعية وفكرية، ينطلق منها لكشف مرتكزات وأشكال الاستغلال الاقتصادي والزيف السياسي، ومرد التلوث الأخلاقي والسلطوي، والإضاءة على عالم المفارقات والتحولات. وتتراوح بين استرجاعات فردية وجماعية، واستدماجات واقعية وحلمية. وتنفتح على اليومي والمعيوش، كما على التاريخي والأسطوري.
…………….

 …………….
…………….
الفردُ الوحيدُ حين يُسحق، يُداسُ كحشرةٍ، ويقاومُ في هذا الوجودِ الممزقِ المتلاشي، يفقدُ رجولتَهُ وأبوتَهُ ، هل يزول تماماً؟ هل يبقى فيه عرقٌ ينبضُ؟
بل حين يفقدُ كرامتَهُ، ويبيعُ كلمتَهُ، هل يتلاشى كلياً؟!
هنا الشخصيةُ المعقدةُ المركبةُ وهي تضجُ بالكلام، والأحلام، والكوابيس، وبمشروعاتِ الأنتقام والأمتهان، وتخلقُ، وتتمزقُ بين ثورةٍ باطنيةٍ وإنسحاقٍ ظاهر، في أشكالٍ من السردِ الغرائبية الواقعية.
الخصمُ ملأ الساحةَ، حازَ الثروةَ، وصارَ كائناً كلياً جباراً، معبوداً كأنه إله، وتحولَ المواطنون إلى حشرات، ولم يبقْ سوى أن يذيبَ هذا المثقفَ الوضيعَ الذي لا يزالُ يقاوم، لكنه لا يذوبُ بل يتناسخُ ويظهرُ بأشكالٍ جديدة.
النفطُ يملأ البلد، ويصيرُ بحراً ويبتلعُ البشرَ ويبتلعُ الأرضَ.
ذهب مع النفط: روايةٌ واقعيةٌ كابوسيةٌ ساخرة.
…………….

 …………….
…………….
ما أن تشرع بقراءة رواية «عنترة يعود الى الجزيرة» حتى يطالعك منظر الصحراء وهي تصحو على الفجر. هي البلدة الراقدة قرب الشواطئ ذات البيوت الصغيرة المتلاصقة المسماة «سبخة» التي غزاها الغرباء على عيون أبناء القبيلة.. يتخذ الروائي من شخصية عنترة البطولية مادة للتعبير عن ذلك التلاحم والترابط الذي يبلغ أشده في الدفاع عن الهوية، فثمة إيحاء معتقدي واجتماعي وسياسي لهذه الشخصية التي اختارها عنواناً لروايته وأناط البطولة فيها الى «هلال العبسي» الذي يدخل السجن عقاباً على شجاعته. ما يميز العمل أنه يسلط الضوء على علاقات انسانية تشكل جزءاً من تاريخ مجتمعات الجزيرة العربية والخليج العربي في الماضي والحاضر في حراكه اليومي: إذ تؤرخ الرواية لحدث واقعي بأسلوب رمزي يضفي على البيئة المحلية نكهتها الخاصة..
…………….

 …………….
…………….
«هو الأسطورة الحية، له أسرة واسعة من الطمي والتاريخ والرموز، مازال يرقب الثورة المغدورة، يمشي بين الجمهور، يرسل رسائله عبر الزمن».
هو هنا يمضي، على عرشِ النيل الخالد، قلوبِ الجماهير.
يرى جمالٌ أصابعَهُ تشقُ الجبلَ، وتنهمرُ المياهُ، ومن الزقاقِ الضيقِ والباعةِ الصغار راح يطيرُ في الفضاء قربَ السحب، يمسكُ جذورَ النهر ويحولُها عن صخورِ الطحالب، يقربُهَا من منازلِ الصيادين والخدمِ وعمالِ التراحيل، يكسرُ أحجارَ الجبال ويضربُ بها العمالقةَ الطالعين من القبورِ والكهوفِ ويركضُ السحرةُ حولَهُ ويمسكون ساقيهِ الضخمتين المتشبثتين بتاجِ فرعون، يفضهم كورقِ الشجرِ نحو الزنزانات والفيافي، يتطلعُ للأزقةِ المزدحمةِ الخانقةِ فيجدها لم تتبدل، والفولُ هو نفسُهُ صغيرٌ صغيرٌ حتى كأنه لا يُرى، لكنه صامدٌ أبدي في الشوارع مع الدخانِ والبخار والذبابِ، يهجمُ جمالٌ على السحبِ والغبار والأموالِ وتعلو المداخنُ توزعُ الأرغفةَ على الجائعين، وتملأُ رئتيهِ رماداً فيحولُهَا لسجائرَ ثم غليوناً وتتغلغلُ في خريطةِ ظهره.
من رسائلُ جمال عبدالناصر السريةِ

كلمة الغلاف الجزء السابع
كيف تكونت القصة القصيرة لدي؟ لماذا لم تنفصل عن صرخاتي السياسية والاجتماعية؟ لماذا وجدت نفسي كاتباً للقصة القصيرة وللاحتجاج الوطني والاجتماعي معاً؟ لماذا غدت شخوصي مستقاة من المشاهدات والحكايات المروية والمواقف الحقيقية والرموز العربية ومن التجربة الحياتية بكل عفويتها في البدء؟
لا أعرف لماذا وأنا طفل توجهت لقراءة سيرة عنترة بن شداد، فلماذا هذه الشخصية هي التي ظللت طفولتي، فرحت أقرأها واشاهدها على شاشة السينما القريبة من حينا؟
هل مخاض التحدي المحيط، والحي الفقير المهموم بالحرائق والاستغلال، هو الذي يخلق جواً من البحث عن البطولة، واستبصار طرق الكفاح؟
هل يلعب مخاض الشعب البسيط المستعبد الباحث عن حريته من الأسياد الخارجيين والداخليين، دوره في خلق مناخ جاذب للفتيان، ومحرضاً لهم على الالتحاق به، والإضافة فيه؟
هل يغدو واقع الأمة المفتتة التابعة، والتي تستعيد نهوضها وتفكك شبكة تبعيتها وإرثها، روحاً هائمة قوية فوق نفوس شبابها؟
لا شك أن مناخ الخمسينيات الذي تشكلت طفولتنا فيه، والممتلئ بضجيج الإذاعات، وخبز المنشورات الساخن، والمعبأ بالمظاهرات، كان له دوره في الذهاب إلى رموز البطولة القصصية، سواءً كانت عنترة أم السندباد أم أولئك الأطفال اليتامى الذين يتلقون المساعدات من القوى السحرية.
لقد كان نمونا الدراسي والثقافي هو صراع ضد تركات المجتمع التقليدي، في عقد تخلص النخب الثقافية ــ السياسية من الأفكار العتيقة في الثقافة والسياسة، عقد تجاوز الأقصوصة الميلودرامية والإنشائية، والتلاحم مع مستويات الواقع، والتاريخ، عقد تجاوز أفق «الطبقة المتوسطة» على مستوى الممارسات الفكرية والإبداعية.
لا شك أن صعود ثقافة الشعب البسيط كان محصلة لتغير عالمي غامر، كان يدفق أدبياته ورموزه وخلاياه في الأحياء المأزومة.
من هنا كانت أقصوصة رصد الواقع الفاقع، والتقاط ما هو طافح وبارز، وكشف مثالب «الأشرار» هي تعبير عن هذا المناخ الشعاري، أما البُنى الفنية السائدة فهي تعتمد على: التصوير الفوتوغرافي لنماذج بائسة، أو خلق بنية أولية لكشف التضادات الاجتماعية الحادة، واعتماد على اللمحات الخاطفة وعلى الرموز الأكثر حضوراً وديناميكية في الوعي العام كالنماذج الأسطورية والدينية. .
تجربتي في القصة القصيرة

كلمة الغلاف الجزء الثامن
الكاتبَ والمثقّف البحرينيّ الكبير عبدالله خليفة، بعد مسيرة طويلة شاقّة ومضنية وحافلة بالعطاء والتنوير، وإنتاجات دافقة وعميقة وثريّة ومتنوّعة في الفكر والفلسفة والأدب خلّفها وراءه لتشهد بآثاره التي حفرها في ذاكرة الوطن بترابه ونخيله وبحره وهوائه وشخوصه وتاريخه التليد والطارف، لقد توسّل عبدالله خليفة بالكتابة لِتقوم «بالانغراس في جذور الأرض لأنّ كلّ يوم هو لحظة ألم وأمل»، ولكلِّ لحظة مضمون، وكلّما كان المثقّف ممتلكًا أدوات التعبير عن هذه اللّحظة، ومتمكِّنًا من الإفصاح عمّا تحتويه كان إنتاجه الكتابيّ أقدر على مقاومة الفناء والتّلاشي، وأجدر بتسجيل جوهر اللّحظة وتجلية خصوصيّتها.
والناظر في تجربة الكتابة الروائيّة عند عبدالله خليفة يلاحظ تراكم النصوص وانتظام صدورها؛ ليكون بذلك أغزر كتّاب الرواية في البحرين إنتاجًا، وأشدّهم حرصًا على ممارسة فعل الكتابة؛ لإيمانه بأنّ «الكتابة تنمو فوق الأرض الحقيقيّة، تسحب الصواري من عند البحارة الذين غطّسوهم موتى وهياكلَ خاليةً من المعنى في قعر الخليج، فتغدو الروايةُ الكبيرة المخطّطة في الرأس رواياتٍ عديدة»، تزخر بما يزخر به الواقع من صغير الشؤون وعظيمها، ذلك أنّ روايات عبدالله كلَّها مشدودة إلى الواقع شدًّا وملتصقة بالحياة التصاقًا، تكشفُ ما يمور به المجتمع من قضايا ومعضلات، وتعمدُ إلى فهم حركة التاريخ، ومظاهر تطوّره، وما ينعكس فيه من تجاذبات وصراعات وتغيّرات ثقافيّة واجتماعيّة وإيديولوجيّة وسياسيّة، وتنظرُ في بنية المجتمع، وتنشغلُ بمحرّكات التاريخ؛ لتقتنعَ بالتّصوّر الاشتراكيّ الذي ينتصر لمقام الكادحين والعمّال. فقد صرفت الروايات اهتمامها إليهم، وأخذتنا إلى الفلاحين يكدحون في حقول ملتهبة، والغوّاصين يجوبون بحارًا قصيّة، ويركبون الأهوال والآلام من أجل الكفاف والعفاف، ورحلت بنا إلى المصنع حيث العمّال «مندفعون في تيّار الحديد والنار والهواء البارد واللاهب»، وتنقّلت بنا بين القرية والمدينة، والماضي والحاضر، والأنا والآخر، وفتحت لنا المجال للنّظر في علاقة الإنسان بالمكان والتاريخ والتحوّلات الفكريّة والاجتماعيّة، وصلته بمصيره والسلطة.
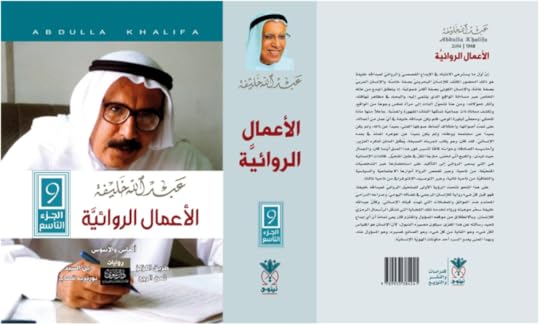
كلمة الغلاف الجزء التاسع
إنّ أوّل ما يسترعي الانتباه في الإبداع القصصيّ والروائيّ لعبدالله خليفة هو ذلك الحضور المكثّف للإنسان البحرينيّ بصفة خاصّة، والإنسان العربيّ بصفة عامّة، والإنسان الكونيّ بصفة أكثرَ شموليّة. إذ ينطلق المبدع من عالمه الخاصّ عبر مساءلة الواقع الذي ينتمي إليه، والبحث في مظاهر تهافته، وآثار تحوّلاته؛ ومن هنا تتحوّل الذات إلى مرآة تعكس وجوهًا من الواقع، وتكشف معاناة ذات جماعيّة تمثّلها الفئات المقهورة والمعذَّبة، جاعلاً منها مادّة للحكي، ومعطًى لبلورة الوعي، فلم يكن عبدالله خليفة في أيّ عمل من أعماله، على تعدّد أصواتها، واختلاف أنماط صوغها الفنيّ، بعيدًا عن ذاته، ولم يكن بعيدًا عن مجتمعه ووطنه، ولم يكن بعيدًا عن جوهره الممتدّ في بعده الإنسانيّ. لقد كان، وهو يكتب تجربته العميقة، يُطْلِق العِنان لفكره الغزير، وأحاسيسه الصادقة، وحواسّه كافّة لتسبر غور هذا العمق أينما كان، والجمال حيث تبدّى، والقبح أنّى تخفّى، مازجًا الكلّ في طين المتخيَّل. فالذات الإنسانيّة هي التي يسعى الروائيّ إلى التأكيد على استحضارها عبر الشخصيّات المتخيَّلة، من ناحية، وعبر تقمّص الرواة أدوارها الاجتماعيّة والسياسيّة والثقافيّة من ناحية ثانية، وعبر التوصيف الإثنوغرافي من ناحية ثالثة.
على هذا النحو تتحدّد الرؤية الأولى للمتخيَّل الروائيّ لعبدالله خليفة، فهو قبل كلّ شيء رواية للإنسان المرجعيّ في نضاله اليوميّ، وصراعه الدراميّ المحتدم ضدّ العوائق والمعضلات التي تهدِّد كيانه الإنسانيّ. وكأنّ عبدالله خليفة سخّر موهبته ورؤاه لخدمة تلك القضايا التي تشكّل الرأسمال الرمزيّ للإنسان. وبالانطلاق من موقفه المسؤول والملتزم كان يعي تمامًا أنّ أيّ إبداع تحيد رسالته عن هذا المغزى سيكون مصيرُه الذبول؛ لأنّ الإنسان هو المقياس لكلّ شيء، وهو الغاية من كلّ شيء، وهو الصانع لمصيره، وهو المسؤول عنه، وبهذا المعنى يغدو السرد أحد مكوّنات الهويّة الإنسانيّة.

كلمة الغلاف الجزء العاشر
هي دارين التي خرجَ منها. نقطةٌ صغيرةٌ تضاءلتْ وغطستْ وراءَ البحر، هو الربانُ الكبيرُ أحمد بن جبر خرجَ بسفينتين كأنهما أسطول، البحرُ الأزرقُ الواسع يفتحُ ذراعيَهِ، وبدتْ الصحارى الترابيةُ اللامتناهيةُ وراء تاروت متجهمةً تدورُ فيها دوائرٌ كريهةٌ من الغبار، الجزيرةُ تلويحةٌ خضراءُ بين الصخور، تشمخُ النخيلُ ورأسُ القلعةِ ينزل لقعر المياه.
للأرواحِ نفثاتُها على هذه المياهِ المشتعلةِ ولهمامِ جسدهُ الصلبُ المنغرس في الخشبِ والأرضِ، سفنٌ كثيرةٌ نزلتْ إلى الأعماق، أجسادٌ كثيرةٌ لم تُكفن وهي تُحاصرُ بين الأشياءِ المحطمةِ والأشلاءِ، أجسامُهم صارتْ جزءً من الأعشابِ والأسماكِ والمحار والقواقع.
سألتهُ القوقعةُ وقروشُ البحر من أكثر خلوداً أنا أم أنت؟
◇ خَليجُ الأرواحِ الضَائعةِ
كان البحرُ يتحرش ببيتها، تتغلغلُ موجاتهُ بين أحجارهِ وقيعانه، فكأنه يطفو على الماء، في دورةِ المياهِ يصلُ إلى ساقيها، ويتضخمُ مدهُ فيضربُ حتى أحشاءه، وتغرفُ منه في النافذة وتداعبُ نوارسَهُ وتطعمها من فتات خبزها. كان يتنائى حيناً فيبتعدُ حتى كأنه غادرَ أرضَها، وترى القواربَ جافة، منقلبة على جهة، وثمة شظايا من زجاجٍ الماء تلمعُ وتتوهج.
كان يحضرُ على مائدتِها، فترى أمَها بين أدخنةٍ كثيفة تقلبُ على الصفيحةِ المعدنيةِ الرقيقة بناته، تلك السمكات الكثيرات الصغيرات مثلها اللواتي يقفزنّ على اللهب، وتنضجُ جلودُهن، ويطرطشُ دهنهن في فرقعاتٍ لذيذة، والحطبُ يُلقى، ومن هنا كانت هي حمالة حطب، تمشي على الساحل الطويل وتجمع قطعه.
وأمُها تقول: ابنتكَ سرايةُ ليلٍ، هي جنيةٌ أو خليلة، وتروي إنها رأتْ قواربَ وسفناً ونخيلاً وينابيع بعدد التراب، ابنتكَ تخاوي الجن!.
◇ حورية البحر



