عبدالرحمن بدوي
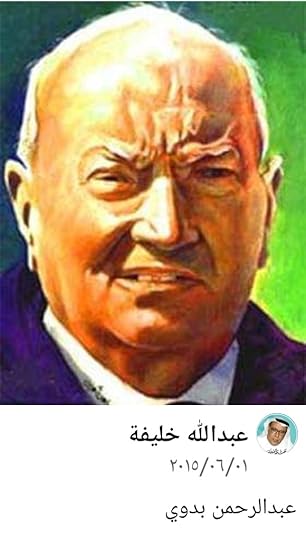 كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة
كتب : عبـــــــدالله خلــــــــيفة في كتابه ( الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ) يقوم الباحثُ ومحقق النصوص الكبير والمترجم عبدالرحمن بدوي ، بتشكيلِ مطلقاتٍ عامةٍ للوعي ، فالإنسانية لديه عامة والحضارة عامة ، لها سماتٌ مجردةٌ وتخترقُ العصورَ والبــُنى الاجتماعية ، ( 1 ) .
يقول :
( وهذا العَودُ المحوري إلى الوجود الذاتي الأصيل هو ما يسمى في التاريخ العام باسم ( النزعة الإنسانية ) . ولا بد لكلِ حضارةٍ ظفرتْ بتمامِ دورتها أن تقومَ روحُها بهذا الفعل الشعوري الحاسم . ولهذا كان علينا أن نتفقده بين الحضارات التامة النمو على تعددها ، وما الاختلاف إلا في الألوان المحلية والمعادلات الشخصية الضئيلة ، أما الخصائص الإجمالية فواحدةٌ بين الحضارات ) ، ( 2 ) .
هناك تعبيراتٌ مجردةٌ هي قاموسُ الباحث عبدالرحمن بدوي فنرى منها هنا : التاريخَ العام ، والنزعةَ الإنسانية ، والروح العامة ، والفعل الشعوري ، والألوان المحلية ، والخصائص الإجمالية .
إن كلَّ هذه التعبيرات تتمازجُ وتشكل رؤيةً عامة ، فالبشريةُ لها تاريخٌ عام مشترك ، وهذا صحيح ، ولكن هذه العمومية تشكلتْ داخل بُنى تاريخية طويلة وغائرة في كلِ حضارة ، ولا يمكن القفز بسهولة على هذه البنى والمراحل التاريخية الكبرى ، ف ( العود المحوري إلى الوجود الذاتي الأصيل ) ، هو قراءةٌ للنزعات الفردية دون رؤية الأسس الموضوعية لتكوِّنِ هذه النزعاتِ الشخصية والحرة والمبدعة .
إن الباحثَ حين يجعلُ مثل هذه النزعات ( وجوداً ذاتياً أصيلاً ) يقومُ بجوهرةِ هذه النزعات ، فتغدو وكأنها تستطيع أن تكون في كل التاريخ ، وكأن ليس ثمة شروطاً موضوعية لتشكل ونمو وانحسار مثل هذه النزعات .
ولهذا فهو يقولُ ؛ ( الخصائص الإجمالية العامة فواحدة بين جميع الحضارات ) وهو يشيرُ إلى وجودِ ظروفٍ لتشكلِ النزعاتِ الفردية الخلاقة بتساوٍ بين الحضارات ، وهو أمرٌ غير موضوعي ، فبعضُ الحضارات لا يخلق ظروفاً مؤاتية مهمة لهذه النزعات وبعضها يشكل لها منسوباً أوسع وبعضها يدمرها كلياً .
ومن هنا فإن تعبير ( النزعة الإنسانية ) هو الآخر يحتاجُ إلى فحصٍ ، فما هي هذه النزعةُ الإنسانيةُ العابرةُ للتاريخِ وما هي ملامحُها لتكون نزعةً إنسانية ؟
يقول عبدالرحمن بدوي :
( . . إن الوجود الحق أو الوحيد هو الوجود الإنساني ، حتى صارت شارته هي : من الإنسان وإلى الإنسان بالإنسان ؛ أو كل شيء للإنسان ولا شيء ضد الإنسان ، ولا شيء خارج الإنسان ) ، ( 3 ) .
وهذه تعبيراتٌ عصريةٌ مجردة غير معروفةٍ في العصور القديمة والوسطى ، فلم يكن الإنسان يفكرُ في نفسه كفردٍ منقطعٍ عن الجماعةِ بهذا الشكل التجريدي ، فهو كائنٌ مُلحق بجماعةٍ ، وسواء كانت قبيلةً أو جماعةً دينية ، أما كفردٍ مستقل فهو تفكير عصري ، ولهذا فإن الباحث عبدالرحمن بدوي سوف يقوم بمهمة شاقة وهو يحاول أن يثبت لنا وجود هذا الاستقلال وتلك الكينونة الفردية العالية في العصور التي سحقت الإنسان الفرد !
( النزعة الإنسانية لا يمكن أن تصدر إلا عن الروح الأصلية للحضارة التي ستنشأ فيها ) ص 8 ، وهنا تقودنا التعبيراتُ المجردةُ إلى تعبيراتٍ أخرى مجردة ، فعلينا أن نبحثَ عن النزعاتِ الفردية الخلاقة في ( الروح الأصلية للحضارة ) فلا بد هنا أن نعرفَ ما هي الروح وما هي الروح الأصلية ، ولهذا سوف نبحثُ إذن عنها من خلالِ الوعي وهو مقطوعُ الصلةِ بالبُنى الاجتماعية التي يتشكلُ فيها ، أي أن نبحثَ عنها وهي تخترقُ المراحلَ والبُنى والعصورَ ، متشكلةً في أفكارٍ وأخلاق وإنتاجٍ فردي مقصوصٍ من كيانه الذي تشكلَ فيه .
وهكذا ستتحولُ التكويناتُ الموضوعيةُ بين الحضارات والبنى إلى عناصرَ مجردةٍ ، وإلى أن ( لكل حضارة عواملها الخاصة بتوليد النزعة الإنسانية ) ص 8 .
ويضربُ الباحثُ لنا مثلاً بالنزعة السوفسطائية الإغريقية كنزعةٍ إنسانية ( أنها تؤكد إن معيار التقويم هو الإنسان . فالسوفسطائية اليونانية قالت على لسان بروتاغورس : ( الإنسان مقياس كل شيء : ما هو كائن بما هو كائن ، وما هو غير كائن بما هو غير كائن ) ، فيحلل ذلك قائلاً ؛ ( أن يُردَ التقويمُ إليه ، لا إلى أشياءٍ خارجية فزيائية مادية ، ولا إلى كائنات خارجةٍ مفروضة على الوجود على سبيل الأحوال النهائية ، لا الواقعية الحقيقية ) ، ( 4 ) .
ويعتبر الباحث مثل هذه الأفكار نزعةً إنسانية ، دون أن يقرأها في ضوء عصرها ، ولا أن يحللها ، فمقياس الإنسان هو الإنسان ، يظل كلاما مجرداً غامضاً ، فلا يمكن معرفة الإنسان من خلال قطع جذوره الطبيعية والأبنية الفكرية التي ينتجها ، فليست الأديان خارج معرفة الإنسان لنفسه .
إن في الحضارة الإغريقية أشياء كثيرة وكبيرة إنسانية وفيها ما هو مضاد للإنسانية ، وسبق لنا أن حللنا بعضاً من هذه الجوانب في الجزء الأول والثاني ( 5 ) لكن الباحث عبر منهجه يقومُ بقطع أشياء معينة ويفصلها عن مسارها التاريخي ، مثلما يحدث هنا عبر اختيار السفسطائية مدرسة للذاتية غير الموضوعية .
ولأن البناء الموضوعي ليس مهماً في تبيان جذور الفردية ، يقفز بدوي من العصر الإغريقي إلى العصر الحديث فيستشهد بباحث أوربي (بترركه ) الذي يقول :
( كل ما هو خارج عن ذاتك ليس منك ولا إليك ، وكل ما هو لك حقاً عندك ومعك .. ) ، ص 10 ، فيغدو الفردُ في مثل هذا الوعي مقطوع الجذور بالخارج ، وسواء كان الخارجُ سيرورةً تاريخيةً أم وعياً غائراً ، أم تكويناً اجتماعياً .
ويسايرُ بدوي مثل هذا الوعي فتغدو الفردية أي إعلان بالذاتية ، عبر تباين العصور والفلسفات والمواقف ، ومن هنا تغدو في وضعٍ مشتت ضائع الملامح .
وإلى جانب هذه السمة يضع سمة أخرى كتحديد للنزعة الإنسانية وهي ( الإشادة بالعقل ورد المعرفة إليه ) ، ولكن فيما كان العقل السفسطائي يقطع الفرد عن كيانه الموضوعي ، يتوجه ( العقلُ ) الأوربي المتشكل مع نمو الفئات الوسطى إلى ربط الوعي بالواقعِ التاريخي ومهمات التحول الاجتماعية .
والجانب الثالث للنزعة الإنسانية هو ( تمجيد الطبيعة وأداء نوع من العبادة لها ) ص 12 :
( فقول السوفسطائية بالقوانين الطبيعية وبالطبيعة بوصفها معايير التقويم ، هو قولٌ في الآن نفسه بأن الإنسان هو مقياس الأشياء ، لأن الطبيعة لم تعد بعد طبيعة طاليس وأنكسمانس ، بل هي تموضع الذات في تحقيقها لإمكانياتها الذاتية خارج نفسها في العالم ) ( 6 ) .
لكن هذه الطبيعة ملغاة لدى السوفسطائيين ، خاصة باعتبارها الركيزة الأولى الموضوعية للوجود الإنساني ، مع تمحور الفرد على ذاته المطلقة ، مثلما أن درسَ العالم كبناءٍ مادي كما قال طاليس ، هو المقدمة لقراءةِ الفرد داخل الطبيعة وداخل المجتمع ، لكن حين يغدو الفردُ غير قادرٍ على قراءة جذوره في الطبيعة والواقع ، تغدو فرديته مقاطعَ من وعيٍّ مشتتٍ مبتورِ الصلة بالوجود . ولهذا فإن ( تحقيق إمكانياتها ) لا يتشكلُ إلا بوعي هذا العالم ورؤية القوى التي تعضدُ هذه الفردية الخلاقة ، وحين تنقطع الفرديةُ عن هذه القوى تذبلُ ولا تترك أثراً عميقاً في الخارج سواء كان مجتمعاً أم تاريخاً .
هنا يقوم الوعي الوجودي لدى عبدالرحمن بدوي بإسقاط منطلقاته على التاريخ الفكري ، فلا ترى هذه المنطلقاتُ الجذورَ الاجتماعية والفكرية للفرديةٍ التي جعلت الفردية ممكنةً في زمن الإغريق ولا فشلها ، ولا ظهورها مجدداً مع صعود الفئات الوسطى الأوربية الحديثة ، فيغدو تعبير ( بترركه ) مطابقاً لوعي بدوي ، أو قلْ بأن الوعي الوجودي للذاتِ وهي مقطوعةُ الصلات ، يحاولُ أن يفسرَ نشأتــَهُ وتطورَهُ من خارج سياقاته الاجتماعية – الإيديولوجية ، لأنه كوعي فردي مُغلق غير قادرٍ على رؤيةِ ذاتهِ كنتاجٍ فاعلٍ للوجودِ الخارجي .
وهذا ما سوف يفسرهُ في كتابٍ آخر لكن دون أن يؤيد أقوال باحث أوربي آخر وهو ( كارل هينريش بكر ) ، فلدى هذا الباحث لم يستطع ( الإسلام ) تشكيل ( مدينة تعادل المدينة اليونانية أو تشابهها ) ، ( لأن فكرة المواطن الحر لم توجد في المدينتين الأخيرتين ” بغداد والقاهرة ” ) ، ( 7 ) .
لا يتفق ولا يعارض بدوي ( بكر ) في هذه النقطة تحديداً ، فهو يتفق في كون ( الروح ) أو الوعي هو الذي يشكلُ سمات الحضارة منقطعةً عن بناها الاقتصادية – الاجتماعية ، لكنه يعارضهُ من منطلقٍ آخر هو في كونِ الحضارات مستقلة عن بعضها البعض ولها سمات مميزة .
هو هنا يرتكزُ على المؤرخ اشبنجلر الذي ( يرى أن الحضارات مستقلة بنفسها تمام الاستقلال الواحدة عن الأخرى ، وأن ما يخيل إلينا من وجود تشابه بين حضارةٍ وأخرى إنما هو تشابه ظاهري لا يكاد يتجاوز اللفظ ) ، ويحدث التميز بين الحضارات ويتشكل الفصلُ بالتالي حين تختار كلُ حضارةٍ ( ما يتلاءم وإياها ، أي ما يتفق وروحها ، وحتى هذا الذي تأخذه لا تلبث أن تحيلَهُ وتبدلَ فيه حتى يتكيف وروحها تكيفاً تاماً ) ( 8 ) .
هكذا تغدو ( الروحُ ) مصطلحاً مجرداً ، يضمرُ داخله سمات الأمم والطبقات والأجيال والأفراد ، وهو هنا كذلك يمثلُ ( الثقافة ) المتضادة بين القوى الاجتماعية المختلفة ، وقد أُزيلت منه عبر هذا التعميم خصائصُهُ الملموسة وسماته المحددة . ومن هنا فلا بد من متابعةِ عبدالرحمن بدوي لرؤيةِ هذه التضادات وقد صارت روحاً .
* الصوفية والوجودية
يقوم عبدالرحمن بدوي بدمج الصوفية بالوجودية .
وهكذا فإن الوعي المثالي التحديثي العربي سوف يربط بين الصوفيةِ والعديدِ من الاتجاهاتِ الحديثة ، وبروز الصوفية هنا كنموذجٍ ماضوي يعبرُ عن عجزِ بعض الاتجاهات المثالية الحديثة عن إنتاجِ فكرٍ تنويري ، وهي إشارةٌ ما تعبرُ عن صعود البناء التقليدي العتيق .
يقول بدوي :
( إن النزعةَ الصوفية نزعة تقومُ على مذهب الذاتية ، بمعنى أنها لا تعترفُ بوجودِ حقيقي إلا للذات ، الذات المفردة . ولهذا لم يكن للوجود الخارجي عندها إلا مرتبة ثانوية ، أعني أنه لا يوجد إلا بوجود الذات العارفة . ) ، ( 14 ) .
ولكن الصوفيةَ هي ذروةٌ لتصدعِ الوعي الديني الإسلامي ، فالصوفي القطبُ الذي يقوم بإنتاج الوعي الصوفي المميز في سيرورة هذا النوع من الوعي ، لا ينطلق من أناه الفردية كأنا معزولةٍ عن الشبكةِ الفكرية العامة التي ينتمي لها ، أي عن الإيديولوجية الصوفية الشمولية التي لا تعترف بالفرد بشكل الوعي الحديث .
وكما أوضحنا في الجزء الثالث من هذا المشروع في فصل ( تطور الصوفية ) فإن القطبَ المتضخمَ الفردية لا تتشكلُ فرديتــُهُ إلا داخلَ المنظومة الدينية الإقطاعية ، فهنا لا يقومُ القطبُ بالحفر في تصعيد الوعي الفردي ، بل في إطفائه عبر ذوبانه في ( المطلق ) ، أي في صورةِ الإلهِ التي يشكلها ، وبالتالي يقومُ بتكريسِ ثقافةِ القطيع ، التي تصل في النهاية إلى الدروشة .
فهي لا تعترف بأي وجودٍ حقيقي للذات الفردية إلا من خلالِ هيمنة صورة الذات الإلهية التي تشكلُها على خلافِ ما يقول بدوي . أي أن صورة هذه الذات الإلهية التي تشكلها مضادةٌ لتطور الفردية ولتطور المسلمين عموماً ، لأن هذه الصورة مغيبة وبلا شروط قانونية موضوعية عامة ، فتقومُ بتفتيت المجتمع .
يضيف بدوي :
( ولهذا كانت مراتب السالكين في طريق الصوفية تسيرُ جنباً إلى جنب مع مراتب الوجود ، وسيرها هذا إنما يقصد به إحلال الوجود الذاتي شيئاً فشيئاً مكان الوجود الفيزيائي أو الخارجي . ) ، ( وهذا هو المقصود من فكرة الإنسان الكامل ” وهو الجامع لجميع العوالم : الإلهية والكونية ، والكلية والجزئية ” . . فاستحالته إلى أن يكون هو الله معناها أن الوجود الأكمل هو الوجود الإنساني ، وأن الوجود الإنساني هو الوجود الحقيقي ، لأننا ما دمنا في هذا نقول بوحدة الوجود ، فإنه برد الوجود إلى الله وبرد الله إلى الإنسان الكامل ، ننتهي إلى رد الوجود كله إلى الإنسان الكامل ، وتلك أعلى درجة للذاتية . ) ، ( 14 ) .
وفي الواقع فإنه لا توجد سوى صور الإله التي يشكلها كلُ صوفي والتي غدت هي الوجود وحين يذوب ُ الصوفي فيها معطياً ذاته مساحةً كبرى ، يزيحُ الذاتية ، أي يزيحُ الوجودَ الفردي العقلاني والحقيقي ، ويتحولُ إلى فردٍ متضخم ، يقومُ هو بدوره كما يفعل الحكامُ بتذويب الأفراد تحت عباءاتهم ، وهنا لا يتمظهر الوجود الإنساني ، بل يتلاشى ، والذاتيةُ تتحققُ على العكس حين ينفصل عن صورة الإله المطلقة على كل الوجود التي صنعها خلافاً للدين ، فيكتشفُ قوانينَ الوجود ويسيطرُ عليها .
إنه لا يذوبُ في الذاتِ الإلهية بل هو يذوبُ في مفهومهِ الذي شكله عن تلك الذات ، فتلك الذاتُ الإلهيةُ المقدسة التي يؤمنُ بها الآخرون تظلُ نائيةً عن وجودهِ وعن طيرانه وذوبانه فيها ، لأن لها وجودٌ موضوعي مفارق اجتماعياً ، ولا يحدث التغيير في هذا الوجود إلا بشكلِ نشاطٍ تحويلي اجتماعي عميق ، أي أن المفهومَ لا يتحول بفعل أفراد معزولين عن سيرورة التطور الاجتماعي ، بل داخل هذه السيرورة .
ولهذا حين دخل الصوفيون في هذه السيرورة الاجتماعية فعلاً كانوا طائفة عبادية ذات طقوسٍ شكلانية غير قادرةٍ على تغييرِ مفهومِ الإله العام لأنها عاجزة عن التغيير الاجتماعي .
وإذ يقطعُ عبدالرحمن بدوي هذه الذاتيةَ الصوفية عن إبعادها المتوارية بكونها شكلاً من أشكال الشمولية الدينية والاغتراب وإنها عاجزة عن إنتاج ذاتية حقيقية ، يماثلها بالوجودية في العصر الحديث ، قاطعاً كل هذه المسافة التاريخية والجغرافية ، لأن ( الروحَ ) الإنسانيةَ عنده واحدة ، فيصيرُ الصوفي مثل الفيلسوف الوجودي :
( وفكرة الإنسان الكامل هذه تناظر في الوجودية فكرة الأوحد خصوصاً عند كيركجورد . والصفات التي يخلعها هذا على الأوحد نجدها كلها تحتل مركز الصدارة في بيان مناقب الصوفي الكامل في التصوف الإسلامي . ) ويضيف : ( وكما قال كيركجورد ” أمام الله لن تكون إلا أمام نفسك . . وحيداً مع ذاتك أمام الله ) ، ( 16 ) .
كما يأخذُ أيَّ عنصرٍ فكري وتعبيري لدى الوجودية ويجده مماثلاً لنفس العنصر لدى الصوفية كعنصرِ القلقِ مثلاً :
( ولنعد إلى فكرة العدم في المذهب الوجودي عند هيدجر فنقول : إن الذي يكشفُ عن العدم في مذهبهِ هو الحالةُ المعروفة بالقلق ، إذ في هذه الحالة نشعرُ إننا معلقون ، يحملنا القلقُ ، مشعراً إيانا بفرار الموجود بأسره وانزلاقه ، الموجود الذي نحن من بينه ، ولا وجود في هذا الانزلاق الشامل إلا للذات المحققة لحضورها في القلق . . . ) ، (17 ) .
وهنا كذلك فالقلق الصوفي جزءٌ من حالة المؤمن لغياب الحضور الإلهي ، في حين إنه لدى هيدجر هو حالةٌ شعوريةٌ للذاتِ المنفصلة عن الإله ، والتي تعاني دهساً من تروس النظام المعاصر .
وبطبيعةِ الحال هناك عناصر مشتركة للمثقفين بين العصرين ، العصر الإقطاعي القديم ، الذي لم يكن فيه أفق للتحول ، ويعتبر الذوبان في فكرة الإله المطلق هو علامة عليها ، فيغدو القلقُ وكافةُ المشاعر الأخرى أدواتٍ لهذا الذوبان ، وبالتالي يتمُ جعل المشاعر البشرية تابعة للغيب ، في حين أن أغلب اتجاهات الوجودية المعاصرة تقوم على جعل هذه المشاعر في خدمة التحرر الإنساني ، وإن كان بشكل فردي . أي هو أفق الفئات الوسطى في الانسلاخ من آلات الصهر الجماعية سواء كانت في الرأسمالية أو في رأسمالية الدولة ( الشيوعية ) . وكلتاهما تطحنان هذه الفئات بأشكالٍ مختلفة .
ويقدمُ لنا عبدالرحمن بدوي مواداً لرؤية ذلك ، فقد كانت ( مسألة المسائل عند كيركجورد ) هي قضيةُ الذاتِ الفردية ( أن أجد حقيقة ، حقيقة ولكن بالنسبة إلى نفسي أنا ؛ أن أجد الفكرة التي من اجلها أريدُ أن أحيا وأموت ) ، ويعلقُ عبدالرحمن قائلاً : ( فهذه الفكرة هي حياته نفسها ؛ ولذا يجب أن تكون نضالاً بين الذات وبين المطلق ، بين الله وبين العالم . . ) ، ( 18 ) .
هنا يغدو الصراعُ بين الذاتِ وبين المطلق بلا سيرورة تاريخية واجتماعية كمنهجِ عبدالرحمن بدوي دائماً ، فهو يغدو تجريدياً لديه رغم وجوديته ، فذات كيركجورد – كما نرى – هي صراعُ ذاتٍ فردية حساسة مقموعة بشتى أشكال القهر الخارجي الديني والعائلي ، ويتحولُ لديها هذا الصراع إلى صراع بين مفاهيم ، مفهومها للذات ، كفردٍ مميز ، وبين المفهوم الديني البروتستانتي في هذه الحالةِ الذي بعدُ لم يحررْ الفردَ تماماً من الخضوع للمطلق ، رغم أنه لعب دوراً كبيراً في سبيل هذا الانسلاخ ، و( المطلق ) هنا هو هيمنةٌ الجماعة الشمولية على حرية الفرد ، وقد تمظهرت بسيرورة فكرية مذهبية واجتماعية ، لكن هذا الانسلاخَ هو كذلك تشكيلُ قيمٍ إنسانية ليست بالضرورة مجلوبةً من المخزن الديني ، وهذا ما يجد صداه في تطورات الوجودية خاصة في فرعها اللاديني ؛ الاختيار ، والمسئولية ، والحرية بالضرورة الخ . . وتواجهها قسوةُ الوجود وهو تعبير عن قسوة الأنظمة وآلاتها السياسية الاقتصادية ، وهو أمر يفتح نوافذ للوجوديين بالتعاون مع الحركات الاجتماعية المعارضة . ويواجهها كذلك الوجود بشكل الطبيعي القاسي حيث الفرد ذاتاً عابرةً ، تجد الوجوديةُ المؤمنة الملاذ في الدين ، في حين تتوجه الوجودية الملحدة إلى الارتباط بقضايا إنسانية بهذه الدرجة أو تلك من الوضوح والعمق .
ومن هنا فعبدالرحمن بدوي وجد انتماءه في بحث التراث ورصده بشكل موسوعي والبحث عن النقاط التحررية الفردية فيه دون ربط ذلك بالحركات الاجتماعية .
فالوجودية لا تعطي زخماً نضالياً واسعاً بسبب ارتباطها بفردية محصورة في قوقعتها ، مهما قالت بأنها اجتماعية ، لأنها ترى الذات الفردية باعتبارها ليست نتاجاً اجتماعياً وتاريخياً مثلما هي فاعلية كذلك ، ولهذا فإن نقاط الضوء التي يرصدها بدوي تبقى فردية غير مرتبطة بقوانين ، فلا تستطيع أن تعمم أفكاراً فلسفية كبرى .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصادر :
( 1 ) : ( حول إنجازات عبدالرحمن بدوي في الثقافة العربية يقول الباحث أحمد عبدالحليم عطية : { إن ما قدمه بدوي يمثل مشروعاً فلسفياً متميزاً طموحاً ، وهو مشروع ذو نزعة إنسانية في الأساس ، قدمه على امتداد حياته العلمية وإن كان لم يعلن عن ذلك . . ويسعى هذا المشروع إلى الكشف عن ” روح الحضارة العربية ” بدايةً من التنقيب في التراث الفلسفي اليوناني والعربي ، انطلاقاً من المخطوطات الفلسفية الإسلامية التي تقدمُ لنا صورةً واضحةً تكاد تكون كاملة لأعمال الفلاسفة والمتكلمين والصوفية العرب ، وما عرفوه عن أسلافهم . . . ) ، ( الخطاب الفلسفي في مصر ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع ، 2001 ، ص 306 – 307 ) .
( 2 ) : ( الإنسانية والوجودية في الفكر العربي ، مكتبة النهضة المصرية ، ص 3 – 4 ، 1947 ) .
( 3 ) : ( المصدر السابق ، ص 6 ) .
( 4 ) : ( المصدر السابق ، ص 9 ) .
( 5 ) : ( راجع الجزأين الأول والثاني من هذا المشروع وبشكل خاص فصل ( دخول العرب إلى التاريخ العالمي ) من الجزء الأول ، فقرة : الإغريق ازدهار الرأسمالية ، ص 247 ، وكذلك الجزء الثاني فصل ( من علم الكلام إلى الفلسفة العربية ، فقرة من بغداد إلى أثينا ، ص 533) .
( 6 ) : ( الإنسانية ولاوجودية ، ص 13 ) .
( 7 ) : ( عبدالرحمن بدوي ، من تاريخ الإلحاد في الإسلام ، سينا للنشر ط2 ، 1993 ، ص 19 ، ثم ص 23 ) .
( 8 ) : ( المصدر السابق ، ص
(9 ) ، ( 10 ) : ( المصدر السابق ، ص 25 ) .
( 11 ) : ( المصدر السابق ، ص27 ) .
( 12 ) : ( المصدر السابق ، ص 28 ) .
( 13 ) : ( يمكن مراجعة الجزء الأول من هذا المشروع ) .
( 14 ) : ( الوجودية والإنسانية ، مصدر سابق ، ص 68 ) .
( 15 ) : ( المصدر السابق ، ص 69 ) .
( 16 ) : ( المصدر السابق ، ص 69 ، 70 ، على التوالي . ) .
( 17 ) : ( المصدر السابق ، ص 82 ) .
( 18 ) : ( دراسات في الفلسفة الوجودية ، الدكتور عبدالرحمن بدوي ، المؤسسة العربي للدراسات والنشر ، ط1 ، 1980 ، ص 8 ) .



