صحِّ النوم – باسم سليمان – رصيف22
لنا أن نعتبر النوم آلة سفر عبر الزمن والمكان والذات الإنسانية، وهذا ما أشار إليه مارسيل بروست في كتابه الزمن المفقود، فهو بعد أن يستيقظ، يكاد ألا يتعرّف على نفسه، وكأنه أصبح في مكان وزمن آخرين وشخصية أخرى. وفي حكايا التراث الديني ما يشبه ذلك، فهناك قصة النائمون السبعة، أو أهل الكهف الذين أنامهم الله، أكثر من ثلاثمئة سنة، في كهف لا تدخله الشمس، إلى أن انقضى حكم من كان يضطهد إيمانهم بالله، وكأنه سافر بهم عبر النوم إلى المستقبل.
تقدّم لنا الأسطورة الإغريقية بأن هبينوس/ إله النوم، وثاناتوس/ إله الموت، على أنهما ابنا آلهة الليل. كان الشاعر أوفيد يسمي النوم “الموت المزيف” الذي يعيش في كهف لا تنفذ إليه أشعة الشمس أبداً. وعند بوابة هذا الكهف تزهر نباتات الخشخاش وعدد آخر كبير من النباتات المخدرة التي يستقطر منها هبينوس تلك السوائل التي تسبب النوم. ولا تختلف عنه التقاليد الجرمانية القديمة التي ترى، بأن النوم والموت أخوان. وكانت تصف إله النوم، بأنه رجل الرمل، لأن من يصيبه النعاس بشدة، ولا يعود قادرًا على فتح أجفانه، يقول بأن هناك رملاً في عيونه.
هذا التشابه بين النوم والموت، كأنهما شقيقان، نجده في قصة لعازر الذي بعثه المسيح من الموت. قال المسيح لتلاميذه: ” لقد آوى لعازر إلى النوم، ولكني أعمد إليه لأوقظه من النوم”.
ترى الفلسفات الهندية بأن هناك أربع حالات من الوجود: حالة اليقظة- الحالة الحالمة- حالة النوم العميق – حالة الوعي الفائق. أما حالة النوم العميق، فإنها الحالة التي لا يرغب المرء فيها شيئاً، ولا يحلم بشيء. وفي هذه الحالة من النوم العميق يتصل النائم بالذات الحقّة له، التي لا تعرف الخوف وتكون على اتصال ببراهما إله الكون. وهذه الرؤية الهندية تتشابه مع ما كتبته راهبة ألمانية تدعى هيلد جاردمن بنجمن في القرون الوسطى ترى ارتباط النوم بالطعام وسقوط آدم من الجنة. وهي ترى بأن حياة الإنسان تقسم إلى: اليقظة والنوم. ويأخذ الإنسان غذاءه من الطعام والراحة، وأن آدم قبل الخطيئة كان يتغذّى وهو نائم من خلال عينيه المغلقتين، فنومه كان نوماً عميقاً- وهنا لنا أن نشابهه بالنوم العميق عند الفلاسفة الهنود- لكن بعد أن أخطأ آدم أصبح ضعيفاً لذلك فهو يحتاج للطعام. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فالتوراة قصّت بأن حواء خلقت من ضلع آدم بعد أن ألقى الله عليه سباتاً عميقاً!
ربط الفلاسفة الإغريق النوم بالعناصر الأربعة: النار، التراب، الهواء، والماء وخاصة أمبادوقليس الذي كان يرى النوم بأنه انسحاب عنصر الحرارة من الجسم. ولا يختلف أبقراط عنه إذ يقول، بأن النوم هو انسحاب الدم إلى الأعضاء الداخلية وهذا ما يسبب برودة أطراف النائم. أما أرسطو فقد ربط النوم بالطعام، الذي تصعد أبخرته إلى الرأس فتتجمع وتسبب النوم.
إن النوم طبيعة بشرية، لا تتعلق بالآلهة، فالتوراة تقول: “أبصر، إن الذي يحفظ إسرائيل، لايغفل ولا ينام” وفي القرآن: “لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ” لكن في قديم الزمان كانت الآلهة تحب النوم فكما تذكر الأسطورة البابلية الإينومليش بأن إله المياه المالحة/ أبسو وزوجته تعامة أزعجتهم الآلهة الجديدة لكثرة نشاطها ويقظتها، فقررا قتلها إلا أن مردوخ الذي عيناه لا تنام انتصر عليها وخلق الكون.
فــــما أطـــال الـنوم عـــــمراً ولا قصر فى الأعمار طول السهر:
هذا البيت الشعري لعمر الخيام، وقد غنته أم كلثوم وعلى ما يبدو لم يكن النوم ممدوحاً من قبل الفلاسفة والشعراء، فنيتشه كان يكره النوم ويراه تضييعاً للطاقات. ومع ذلك كان يحسد هؤلاء الذين ينامون، يقول نيتشه في كتابه هكذا تكلم زرادشت: “طوبى للنِعاس، سينامون قريباً” أما أفلاطون فكان يستهجن النّوّم مثل معلمه سقراط الذي شبه نفسه بالذبابة التي تلسع النائمين ليستيقظوا وكان يقصد بالنائمين أهل أثينا، لذلك كانوا يريدون قتله، لكنه تمنى أن يرسل الإله لهم ذبابة أخرى توقظهم من سباتهم. تقدم الكتب المقدسة أحكامًا عن النوم، فالتوراة تمسك العصا من منتصفها، فتارة تحث على النوم والتمتع به: “إِذَا اضْطَجَعْتَ فَلاَ تَخَافُ، بَلْ تَضْطَجعُ وَيَلُذُّ نَوْمُكَ” وتارة أخرى تزدريه: “إِلَى مَتَى تَنَامُ أَيُّهَا الْكَسْلاَنُ؟ مَتَى تَنْهَضُ مِنْ نَوْمِكَ”. لا تبتعد المسيحية عن أحكام النوم في التوراة مع أن الدعوة إلى قيام الليل بالصلاة والصمت منتشرة في الجانب الصوفي من المسيحية. أمّا الإسلام، فله أحكام عديدة، كتحبيذ النوم على الجهة اليمنى استناداً إلى حديث الرسول: “إذا أتى أحدكم فراشه؛ فليتوضأ، ثم ليضطجع على جنبه الأيمن” وكراهة ابتداء النوم على الجهة اليسرى، لكن في العموم يقال: “كلٌ ينام على الجنب الذي يريحه”، فلا أحد يتمنى أن يحرم من النوم. تعدّ عقوبة المنع النوم من أشد العقوبات التي تمارس بحق السجناء، فالسجين قد يحتمل التعذيب مطولاً، لكنه ينهار بعد أيام من انعدام النوم، مما يسمح للسجّان أن يستخلص منه ما يريد من اعترافات. على الرغم من أن ديكارت كان يحب النوم حتى ساعة الظهيرة، إلا أن مقولته المشهورة في فلسفته تناقض رغبته:” أنا أفكر، إذن أنا موجود” في النوم تنقطع سلسلة التفكير، لكن سيغموند فرويد يرى بأن الأحلام رسائل اللاشعور المكبوت، وهي نوع من التفكير تحت اللاشعوري، فعلى ما يبدو لا يناقض النوم مقولة ديكارت.
النوم سلطان، وهو السلطان الوحيد، إلى جانب سلطان الحب، نتمنّى أن نقع تحت حكم أحدهما، عندما يستبد بنا التعب والأرق والتوق إلى النصف الآخر. لكن السلطانين يتنازعان المحبّ الأرق. فالأول يريد أن يدخله في عباءته، وله ما شاء من الأحلام وطيف الحبيب الزائر، أما سلطان الحب، فهاجسه أن يبقى المحبّ راعي نجوم، يقول بشار بن برد: لم يطل ليلي ولكن لم أنم ونفى عني الكرى طيفٌ ألمّ وإذا قلت لها جودي لنا خرجتْ بالصمت عن لا ونعم.
أو كما تقول فيروز:
من عزّ النوم بتسرقني
بهرب لبعيد بتسبقني. لا يتصالح السلطانان إلا عندما يتوسّد المحبّ ساعد الحبيب، أو حضنه، أو سريره، فيغفو، ليترك كلّاً من النوم والحب يتنادمان على صوت أنفاسه الهادئة.
يقول محمود درويش على لسان الحبيبة: “لا أَنامُ لأحلم قالت لَهُ/ بل أَنام لأنساكَ. ما أطيب النوم وحدي/بلا صَخَبٍ في الحرير”. إن الرغبة في النوم، رغبة في النسيان وخروج من الزمن، كما حدث للأميرة النائمة، ولولا قبلة الأمير، لظلت المملكة نائمة إلى الأبد. هذه القبلة هي من توقظ الغرقى من نوم الموت.
بعيدًا عن أحكام القيمة التي تخصُّ النوم إيجابًا أوسلبًا، هناك جانب آخر للنوم يخصّ شكل النوم الذي نشتهيه، فمع أن الفيلسوفة فيليبا فوت من أكسفورد تقول من غير الأخلاقي تصوير النائم وضمنًا مراقبته، إلا أن رواية ياسوناري كواباتا، الجميلات النائمات، قامت على خرق هذا المحظور.
نوم الأطفال:
هو الحلم المشتهى لكل أرق، أن ينام كما ينام الأطفال. هو نوم يحدث كما التنفس، فالطفل ينام عندما يشاء إله النوم ورائحة الأم، فننشد له: نم في سريرك يا ملك أنت الفتى ما أجملك.
هذا النوع من النوم نغادره، كلما تقدمنا في الزمن، ليصبح ذكرى عن كيف كان النوم حرية تامة بالانسحاب من نهر هيراقليتس ومن ساعة المنبه. وكأن لسان حالنا لسان المتنبي: أَنامُ مِلءَ جُفوني عَن شَوارِدِها.
لا أحد ينام ملء جفونه غير الأطفال، لذلك نحاول أن نجعل من لباس النوم والسرير يحتويان على الكثير من القطن، لا الحرير ولا الدانتيل، فهذه الأقمشة لنوع آخر من النوم، النوم بين أحضان الحبيب.
أريد النوم معك:
هناك أسماء وصفات ونعوت كثيرة لممارسة الجنس، ليس أولها النيك ولا النكاح بل النوم. كثيرًا ما يتم التعبير عن الرغبة بممارسة الجنس/ الحب مع الحبيب بالعبارة التالية: أريد أن أنام معك. هذه العبارة وإن يدل منتهاها على مشاركة السرير مع الحبيب، لكن مبتدأها يدل على الرغبة بالمتعة الجنسية المطمئنة التي تقود إلى نوم هانئ على إثرها، بل وأكثر من هذا، فهذه العبارة تشي بطمأنينة الإعلان عن الرغبة تجاه الشريك من دون تبعات، كمن يعلن عن نعاسه فلا أحد يزدريه، فهو لا يرتكب خطأ تحت أي مسمى. وهكذا تغدو عبارة: أريد النوم معك- مفتوحة الكاف أو مكسورة- أبلغ العبارات الجنسية التي لا يتبعها قلق، أو أرق، أو تأنيب ضمير.
هذا من جانب الحبيبين. أمّا من العذول، فكثيرًا ما تحمل تلك العبارة الاتهام، لكن مع الحسد، لأنها تشي بتلك الرغبة المقموعة أن يتحصّل العذول على النوم الجنسي إن صح التعبير.
نوم الأجنة:
يقال رفع القلم عن النائم، فالنائم يأتي بحركات ويتلفظ بكلمات غير مسؤول عنها، حتى أن هناك من يمشي في نومه. ولربما أشهر الوضعيات في النوم هي تلك التي تشبه وضعية الجنين في رحم أمه. حيث يتكوّر النائم على نفسه وكأنه يسترجع ذكريات غامضة عن تلك الجنة المائية عندما كان يعوم في بطن أمه. ولكن كثيراً ما يفسر هذا الشكل من النوم كتعبير عن الانطواء تجاه الوجود، وكما قال فرويد عن الأحلام، بأنها رسائل مكبوتة، كذلك شكل النوم. فهناك من ينام كالرجل الفيتروني الذي رسمه دافنشي تعبيراً عن انطلاقه في الحياة. وهناك من ينام على جانبه الأيمن أو الأيسر، أو يظل يتقلّب طوال الليل كعاصفة لا تهدأ حتى الصباح. وهناك من ينام كخشبة لا يتزحزح من وضعية نومه حتى الاستيقاظ. وهناك من يفضل النوم عاريًا ليسمح لجسده أن يتنفس بعيدًا عن كل لباس.
النوم مع العدو:
يعني النوم مع الآخر، بدءاً بالأهل، وانتهاء بالزوج والأبناء، تسليماً بأن من ننام معه هو الأمان كله، فالنائم كالميت لا يدري ما يُفعل به، لذلك كانت محظورات النوم مع الآخر عبر تاريخ الإنسان كثيرة. لكن الحياة تقودنا إلى النوم مع آخرين لا تربطنا بهم علاقات واضحة كالجنود الذين يفترشون الخنادق في هدأة الحرب. والمساجين الذين يتقاسمون مساحة السجن الضيقة. كل منهم ينام، وهناك خوف مبهم، ليس من القذائف ولا الجلاد، بل من الآخر الذي يشاركه مكان النوم.
النوم في أسرة البيت، أو أرضية السجون والخنادق، قد تكشف عن عدو لم يكن متوقعًا، فالعديد من جرائم الاعتداءات الجنسية يكون مسرح وقوعها أسرّة البيوت. كذلك قد يذهب سجين ضحية لسجين آخر حين يغدره وهو نائم، أو مجموعة من الجنود قد أمّنوا على حياتهم لدى جندي يحرسهم في غفلة النوم، إلا أنه قد خان الأمانة، كأن يتركهم نهبًا للعدو، أو يقوم هو بإزهاق حياتهم عبر رصاصاته التي كان يجب أن تُوجّه إلى الجهة المقابلة في الجبهة. ولا ريب أن شمشوم أشهر من تمت خيانته وهو نائم على يد دليلة، حيث جزّت شعره وهو مصدر قوته وفقأت عينيه.
ثياب النوم:
يعتبر القطن سيد ألبسة النوم، فنعومته ومشاكلته للجسد تسمح له بأن يحتضن النائم بكل عطف ودفء. أمّا الحرير، فله مآرب أخرى قبل النوم، حيث الغواية بأبهى صورها عندما ترتديه النساء لأجل ليلة حمراء. يسانده في ذلك الدانتيلا التي تشبه الشبابيك، فتسمح برؤية موشاة بالغموض لأشد المواضع حميمية، فيشتعل الخيال على أرض السرير. لكن هناك من يرفض هذه الأقمشة ويرتدي مسوح التقشف من الكتان والصوف حتى يكون نومهم تعبداً لله حتى وهم لا يشعرون.
ونختم هذا المقال بما كتب الروائي الروسي إيفان غونتشاروف رواية عن أوبلوموف الذي كان يحب النوم لدرجة أنه لا يغادر فراشه: “لم يكن الرقاد ضرورة بالنسبة لأوبلوموف، كما هو الحال بالنسبة لمن كان مريضاً أو يغلبه النعاس. ولم يكن أمراً يفرضه التعب أو رغبة الخامل في الاستمتاع، وإنما كان الرقاد بالنسبة له هو الحالة السوية” ألا يذكّر أوبلوموف بالإلهين أبسو وتعامة؟
باسم سليمان
https://raseef22.net/article/1092023-%D8%B5%D8%AD-%D8%A7%D9%D9%D9%D9خاص رصيف22
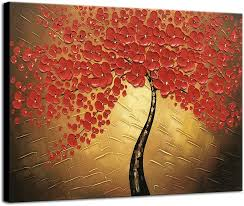
باسم سليمان's Blog
- باسم سليمان's profile
- 24 followers



