الجمل من ناقة الله إلى حرب النجوم – مقالي في موقع رصيف22
كان الجمل عند العرب حيوانًا أسطوريًّا، يُرجَع بأصله إلى بدء الأزمنة. وكان اعتقادهم، بأنّه من نسل الجان. وقد أورد الجاحظ في كتابه الحيوان: “يقول الناس في الإبل أقوالًا عجيبة، فمنهم من يزعم بأنّ فيها عرقًا من سفاد الجان”. حتى أنّ البدو لا يستحمون في مياه ولجت فيها الإبل، لأنّه فيها صفات شيطانية.
يذكر النويري في كتابه؛ نهاية الأرب في فنون الأدب، بأن الحيّة في الفردوس كان لها صورة الجمل. وكانت تصحب آدم وحواء في تطوافهما في الجنة تعرّفهما على الأشجار. وبالقليل من التأويل سيكون من بين تلك الأشجار، شجرة الخطيئة التي أغواهما الشيطان بها، فالناقة لعبت دورًا، وإن كان غير مباشر في الخطيئة. ويضيف ابن قتيبة بأنّ الحيّة التي لها هيئة جمل، كانت تعتبر من أجمل مخلوقات الله وعن طريقها دخل الشيطان إلى الجنّة.
يشرح جيمس فريزر، صاحب كتاب الغصن الذهبي، العلاقة بين الإنسان والطوطم بالقول: يحيط الرجال والنساء الطوطم بالتقديس والتحريم والاحترام والتقدير. فالطوطمية نظام اجتماعي، ديني يترتب عليه الكثير من المقدسات والمحرمات. ولا يستبعد سعيد الغانمي بأن تكون أسماء القبائل العربية طوطمية النشأة؛ وهو بذلك لا يتفق مع ابن دريد الذي ذهب في تعليل تسمية العرب لقبائلها بأسماء السباع ترهيبًا لأعدائها.
لعب الجمل دورًا أسطوريّا وواقعيّا في التراث العربي، فهو سفينة صحرائهم، به تجمّعوا، وبه تفرّقوا. يحلّل بول ريكور كما ذكر ياروسلاف ستيتكيفيتش في كتابه؛ العرب والغصن الذهبي، دور الأسطورة في الثقافة الإنسانية إلى فعاليتين الأولى: تقوم على توطيد الواقع القائم واستمرار وجوده. والثانية ترسم الوجه اليوتوبي للأسطورة، أي الحلم بما لم يوجد بعد، وتصوّر أشكال بديلة للواقع. وفي كلتا الحالتين كان الجمل قادرًا على تلخيص الحراك الديني والعقائدي والمجتمعي والاقتصادي. وقبل أن نعرض لتمظهرات الجمل في التراث العربي، لابدّ من الإشارة إلى أنّ التقدير الكبير لدور الجمل في حياة العرب، جاء من دوره المعاشي والاقتصادي الذي أنشأ تحريمات كان هدفها الحفاظ على بقاء المجتمع في بيئة قاسية. ومن هذا المنطلق تم تقديس البحيرة، والسائبة، والوصيلة، والحام. وقد بيّن ابن هشام معنى هذه الألقاب التي أطلقت على النوق والجمال بالقول: البحيرة؛ هي الناقة التي تنجب أبطن متتالية ويأتي الخامس ذكرًا، فتشق أذنها وتترك للآلهة، فلا تحلب، إلّا لضيف، ولا يقصّ وبرها. السائبة؛ هي التي يطلقها صاحبها إن شفي من مرض، أو تم له أمر. الوصيلة؛ هي التي تبكر بأنثى وتثنّي بأنثى، فكانوا يطلقونها، ويقولون وصلت أنثى بأنثى. الحامي؛ هو الفحل الذي يولد من ظهره عشرة أبطن، فيقال حمى ظهره. عارض الإسلام هذه العادات وجاء في القرآن الكريم: “مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ”.
جاء في كتاب جواد علي؛ المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام بإن لفظ المال/ النقد كان معادلًا للإبل: ” إن الإبل هي المال عند العرب، وبها كانوا يقدرون أثمان الأشياء، ويتعاملون في تجارتهم وفي أسواقهم، فالجمل عندهم هو الوحدة القياسية في البيع والشراء وفي تقدير الحقوق والديات والفدية والمهور”.
الأقدس:
يقول سعيد الغانمي في كتابه ينابيع اللغة العربية بأنّ الثموديين كانوا يعتبرون الجمل حيوانًا مقدسًا، ولذلك كانوا يحرّمون أكله وقتله والانتفاع به. ويرى أنّ الجمل كان طوطمهم، فيسمونه الأقدس في نقوشهم؛ ولأنه حيوانهم المقدّس كان امتحانهم قد تم من خلاله، وهذه ما يذكره القرآن: ” إِنَّا مُرْسِلُواْ ٱلنَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ”.
طلب الثموديون من النبي صالح معجزة تؤكّد صحّة كلامه بأنّه رسول من الله وذلك بأن يخرج لهم من الصخرة ناقة لها أوصاف جميلة وإعجازية كما ذكر النويري بأن يكون لبنها يفيض من ضرعها وأن يشفي المريض. ومن ثم أضافوا شروطًا أن ترعى فقط في قمم الجبال وأعماق الوديان ولا تقرب مراعيهم، فلا تزاحم قطعانهم وأن يكون لها سقب يتبعها. وافق النبي صالح على شرط أن يكون المصدر الوحيد للماء في ثمود مقسومًا بين الناقة وأهل ثمود؛ يوم بيوم. تنصلت ثمود من عهدها مع النبي صالح، وقام قيدار/ قُدار الذي يرى فيه يورسلاف سيتيكيفيتش رمزًا يوحي بالقدر المكتوب؛ بعقر الناقة وقتلها ومن ثمّ لاحق فصيلها الذي تعددت الروايات بشأنه، فمنهم من قال بإنّهم قتلوه وأكلوا لحمه، ومنهم من قال بإنّه هرب إلى قمم الجبال؛ وهناك ارتفعت به صخرة حتى غاب عن النظر، فيما كان رغاؤه ينذر بالعاقبة الكبيرة. وبعدما وقعت الواقعة قال لهم صالح: تمتعوا بداركم ثلاثة أيام. وما إن انتهت المهلة حتى وقع العقاب، فأتتهم من السماء صيحة مهولة: “فيها صوت كلّ صاعقة، وصوت كلّ شيء له صوت”. يعلّل الغانمي ما حدث بأنّ قبيلة ثمود لم تستطع إدارة مواردها المائية، مما أدّى إلى دمارها ولذلك ترتبط قبيلة ثمود دلاليًّا بشحّ الماء. ثمد البئر: استقى ماءها كلّه. ثمد الناقة: اشتفها بالحلب. إنّ الظروف البيئية القاسية، وخاصة قلّة الماء أدّت إلى أنّ الثموديين بدأوا بالنظر إلى طوطمهم الناقة بتسامح أكبر، مما قاد إلى عقرها وقتلها من قيدار الذي من أسمائه الجزار. لقد كان ما فعلته ثمود خرقًا لمحرمًا كبيرًا في نظر الشعوب المحيطة بهم.
إنّ دلالة التحريم والتقديس للناقة نجده في الاستخدام المتكرّر لوصف أي فعل فاحش، فقد أورده شاعر الرسول حسان بن ثابت معتبرًا قيدار أشقى البريّة، لأنه قتل الناقة والسقب حاضر؛ ومن أجل ذلك شبه عبد الرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي بقيدار. وقالوا عنه بأنّه أشقى مراد. وقد أصبح هذا التشبيه استعارة سهلة التكرار للضلال ونقض الولاء كما يوضّح ستيتكيفيتش
تدخل قصة ثمود ومدينتهم الحجر إبّان الإعداد لغزوة تبوك والمسير إليها التي رافقها الكثير من التردّد من المسلمين، وقد نزلت الآيات في ذلك، وتعتبر آخر غزوة قادها الرسول. يعرض ستيتكيفيش لذلك وينوه إلى حادثة ضياع ناقة الرسول، فعابه بعض المنافقين كونه لا يعرف مكانها، فأخبر الرسول أين هي بالضبط. وفي هذه القصة نجد أنفسنا تحت وقع أصداء القصة القديمة لناقة صالح حيث يكذّب الرسول.
يفسّر سيتيكيفيتش استخدام ثيمة دمار ثمود في أحداث غزوة تبوك تطبيقًا لما قال بول ريكور، فأن رفض أهل ثمود لقدسية ناقة صالح كان الهدف منه إقرار ما هو واقع، ورفض ما يعدهم به صالح، مما أدّى إلى دمارهم. والأمر ذاته حدث مع الرسول محمد، فإن رفض الامتثال لأوامره ستكون نتيجته مساوية لما حدث في ثمود أمّا الطاعة، فستفتح الآفاق أمام الدين الجديد.
أصبحت استعارة دمار ثمود لدى الشعراء في العصرين الجاهلي والإسلامي، رمزًا للفناء والدمار، فأكثروا من استخدامها. يقول عبد الله بن رواحة في جاهليته: وَرَهْطَ أَبي أُمَيّةَ قَدْ أَبَحْنَا/ وَأَوْسَ اللَّهِ أَتْبَعَنَا ثَمُودَا. ومثله فعل جرير: وكــانَ لَكُــمْ كَبَكْــرِ ثَمُـود لَمَّـا/ رَغــا ظُهْــرًا فَدَمَّــرَهُمْ دَمـارًا. ومن هذا المنطلق جاء تحذير الشاعر زهير بن أبي سلمى إلى بني أسد وغطفان، القبيلتين المتحاربتين، بأنّ الحرب تشبه ناقة صالح، فلا تشعلوها/ تعقروها. وهذا الأمر كان له أثره في تهدئة القبيلتين وإحلال السلام بينهما، لما يعرفوه من قصة ثمود والناقة،
ارتبطت الناقة لدى الشاعر العربي بالفراق عن الحبيبة والمنزل. ولذلك يتمنّى أسامة بن منقذ أن تفنى النوق أو تقتل على الرغم مما سيرتبه ذلك من دمار، فهو يرى بالفراق عن الأهل والأحبة ما هو أشد من ذلك، فيتمنّى أن يقتل النوق وأن يكون الغد قدارًا يعقرها: لو أنّ كلَّ العِيس ناقةُ صالحٍ/ ما سَاءنِي أنّي الغَداةَ قُدارُهُ
ما حَتْفُ أنفُسِنَا سواها إنّها/ لَهِيَ الحمامُ أُتيحَ أو إنذارُهُ.
اليوم خمر وغدًا أمر:
قتل كليبُ ناقة البسوس، فاستنفرت أهلها. ومن ثمّ انتقم جساس لها وقتل كليب، فاندلعت الحرب بين بكر وتغلب التي دامت أربعين سنة. كان عدي بن ربيعة أخًا لكليب، فأراد الانتقام له. هذا العدي؛ هو الزير سالم، صاحب السيرة الشعبية الشهيرة، وهو خال امرئ القيس الذي قال: “اليوم خمر وغدًا أمر” بعد مقتل أبيه. جاء لقب الزير لعدي من كليب بعد أن رأى ولعه بالنساء. إنّ النظر إلى هذه الحرب التي أشعلتها ناقة يعرف مقدار ما كانت تعني النوق والجمال للعرب.
لم تتوقّف الجمال والنوق عن لعب أدوار مختلفة في كلّ حقبة زمنية جديدة، ففي الحرب بين عائشة زوجة الرسول والخليفة الرابع علي، كان الجمل الذي حمل هودج عائشة رمزًا مازالت أثاره واضحة في ما آل إليه الإسلام من فرق مختلفة.
إنّ صورة الهودج الذي حمل عائشة زوجة الرسول إلى حرب ابن عم الرسول، أصبح لدى البدو ثيمة حربية حتى أوائل القرن المنصرم، فقد كانت أجمل بنات القبيلة البدوية توضع في هودج وتسمّى العطفة وتتقدّم القبيلة في حربها، فتكون لرجالاتها محرضًا للاستبسال دفاعًا عن شرف القبيلة.
لم تبتعد ثيمة الحرب والدمار المتعلّقة بالجمل عن حرب الخليج في القرن المنصرم، حيث صوّرت أوردت إحدى الجرائد الجمل بشكل طائرة هليكوبتر. كذلك فعل جورج لوكاس في فيلمه حرب النجوم حيث صوّر الجمل كآلة حربية في كوكب صحراوي.
الجمل حيّة، والحيّة جمل:
يشرح زكريا محمد في كتابه؛ اللقب والأسطورة بأنّ المثل المشهور: “حتى يلج الجمل سمّ الخياط” الذي يفيد باستحالة وقوع الأمر المنتظر؛ له بعد ديني أسطوري أيضًا. وقد جاء في القرآن الكريم: “إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لاَ تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاء وَلاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ”. ويرى زكريا بأنّ الكون يتجلّى بين صيف وشتاء. والصيف هو الجمل، والشتاء هو الأفعى، فالكون تارة يكون جملًا وتارة أفعى يتعاقبان السيطرة.
وهذا التوجه نجده لدى شاعر الحيرة عدي بن زيد العبادي إلى أنّ الجمل كان قد خُلق في بدء الزمن على صورة أفعى: فكانت الحياة الرقطاء منذ خلقت/ كما ترى ناقة في الأرض أو جملًا.
ولربما يعود أقدم ذكر للجمل، كما يقول الغانمي للجمل إلى الملحمة البابلية (حينما في الأعالي): بأنّ الجمل كان روح تيامات؛ وتيامات ذاتها تتمظهر بشكل أفعوان. وفي الأسطورة البابلية يخلق الإله مردوخ الكون من تيامات بعد أن يشطرها نصفين، فهل هما الجمل والأفعى، الصيف والشتاء؟
يعرض الغانمي لنقش ثمودي يظهر جملين برقبتين طويلتين، وكأنهما حيّتين. ومن خلال كلمات النقش التي يقرأها الغانمي بأنّ الثمودي يطلب من إلهه رضاء أن ينتقم من من يحكّ نقش الأقدس/ الجمل.
قيل قديمًا: “النصيحة بجمل” ويذكر سيتيكيفيتش بأنّ للجمل ألف لقب، فما قدِم أعلاه جزء بسيط من سيرة أسطورية وواقعية للجمل الذي حوّل حافره إلى خفّ، كي لا يكسر قلب الرمل.
باسم سليمان
خاص رصيف22
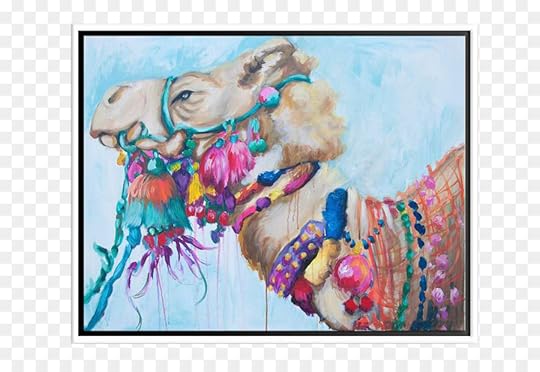
باسم سليمان's Blog
- باسم سليمان's profile
- 24 followers



